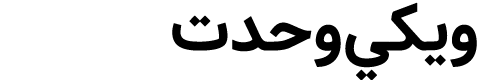النجف
النجف أو النجف الأشرف هي مدينة عراقية تقع فيها مرقد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أول أئمة الشيعةو خليفة بلا فصل للنبي الاكرم ص، وتُعتبر المدينة مركزًا لمحافظة النجف، وتُعدّ من أقدس المدن لدى الشيعة، فضلًا عن كونها مركزًا للقوة السياسية الشيعية في العراق، تشهد النجف حركة دائمة من الزائرين والمقبلين على الدراسة الدينية، مما أسهم في ازدهار تجارتها بشكل ملحوظ، كما كانت المدينة لقرون طويلة محطة رئيسية لقوافل الحجاج البرية المتجهة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما عزّز تواصلها مع المدن والمراكز الحضارية الأخرى.
تاريخ مدينة النجف
اختلف المؤرخون حول تاريخ نشأة هذه المدينة؛ فبعضهم يعيدها إلى ما قبل الإسلام، بينما ينفي آخرون وجودها قبل القرن الثالث الهجري، يذكر جعفر محبوبة أن النجف كانت منطقة عامرة بالسكان خلال حكم المناذرة والتنوخيين واللخميين، الذين اتخذوا من الحيرة عاصمة لهم، وكانت ثقافتها عربية أصيلة[١]. ومن جهته، يرى الدكتور كاظم الجنابي أن النجف لم تكن سوى منطقة تابعة للحيرة، وتحولت لاحقًا إلى مقبرة لأهالي الكوفة بسبب جفاف أراضيها [٢]. ويُروى عن ابن طاووس أن محمد بن علي بن رحيم الشيباني قال: "دخلنا النجف أنا وأبي وعمي ومجموعة من الزوار عام ٢٦٠ هجريًا تقريبًا، وكانت المنطقة قليلة السكان، ولم يكن عند قبر الإمام علي (عليه السلام) سوى حجرًا يدل عليه"[٣]. والتحقيق فهم دقيق لتاريخ النجف، لا بد من ملاحظة أمرين: تمتعت أرض النجف بتربة خصبة ومناخ معتدل، مما جعلها منطقة استجمام للساسانيين والمناذرة والعباسيين، حيث شُيدت فيها الأديرة والقصور الفاخرة. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن المدينة كانت مأهولة بشكل دائم، إذ لم تذكر المصادر الجغرافية القديمة وجود سكان فيها آنذاك. يرجح الدكتور الجنابي أن النجف كانت منطقة صغيرة تابعة للحيرة، وأن وجود المباني الضخمة فيها يدل على سكنى مؤقتة أو موسمية، خاصة مع توفر الظروف البيئية المناسبة [٤].
كشف قبر الإمام علي (عليه السلام)
ارتبط ظهور قبر الإمام علي (عليه السلام) وبناء ضريحه بحدث تاريخي مهم. ففي عهد الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، أُعلن عن موقع القبر لأول مرة، ورد في رواية صفوان أن الإمام الصادق (عليه السلام) أمر بإصلاح القبر بعد أن دلّ عليه، قائلًا: «نعم، أعلم شيعة الكوفة»، ثم قدم نقودًا لإعادة تعميره وتعرض القبر للتدمير بسبب فيضان، وبقي مهملًا حتى أعاد داود بن علي العباسي (ت. ١٣٣ هـ) ترميمه ووضع صندوقًا فوقه. لاحقًا، تهدم القبر مرة أخرى، فقام هارون الرشيد ببنائه وشيّد قبة عليه عام ١٧٠ هـ [٥]. في سنة ٣٣٨ هـ، بنى أبو علي عمر بن يحيى قبة بيضاء على مرقد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وشُيّدت حولها غرف صغيرة كانت مخصصة لفقراء الشيعة. وفي أواخر القرن الرابع الهجري، أقام الشيعة منازل حول الحرم العلوي، وبدأت العمران بالانتشار وتُشير هذه الروايات إلى أن الاستيطان المهم حول قبر الإمام علي (ع) بدأ في أواخر القرن الثالث الهجري. ولا نملك سوى ما دَوَّنَه الرحالة عن النجف، ولعل أول مَنْ ذكرها هو الرحالة العربي ابن جبير (ت. ٥٠٨ هـ) الذي قال:«دخلنا النجف، وهي منطقة خلف الكوفة كأنها حدّ فاصل بين المدينة والصحراء، أرضها صلبة واسعة ممتدة. وفي غرب الكوفة، على بُعد فرسخ، يقع ضريح عظيم مشهور يُنسب لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، وله بناء فخم» [٦].
أما ابن بطوطة (ت. ٧٧٩ هـ) فوصف النجف في رحلته قائلًا: «نزلنا بمدينة النجف حيث ضريح علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، مدينة جميلة في أرض واسعة صلبة، تُعدّ من أحسن مدن العراق وأكثرها سكانًا ومتانة بناء، بها أسواق نظيفة. دخلنا من باب الحضرة إلى سوق البقالين والطباخين والخبازين، ثم سوق الفواكه والخياطين والغسالين والعطارين، حتى وصلنا الحرم الذي يزعم الناس أنه قبر علي (ع). أمامه مدارس وزوايا ومساكن عامرة آية في الجمال، جُدران الحرم مغطاة بطلاء بهيّ» ونقل يعقوب سركيس عن الرحالة تيكسيرا قوله: «وصلنا ظهر السبت ١٨ أبريل ١٦٠٤م (٢٣ ربيع الآخر) إلى النجف، مدينة كبيرة كان عدد منازلها قبل ٥٠-٦٠ عامًا نحو ٦٠-٧٠ ألفًا، لكن الخرائب الباقية تدل على عظمتها السابقة. أما اليوم فلا يتجاوز عدد منازلها ٥٠٠، يسكنها فقراء. يذكر أهلها أن التدهور بدأ بعد وفاة الشاه طهماسب الصفوي سنة ٩٨٤هـ/١٥٧٦م، إذ توقف الاهتمام بها. تُرى في المدينة بقايا أسواق تشهد على مجدها الماضي» [٧]. وصف الرحالة الفرنسي تافيرنيه النجف عام ١٦٣٨م قائلًا: «وصلنا إلى بلدة صغيرة كانت تُسمى الكوفة، وهي الآن تُعرف بـ«مشهد علي». ضريح علي (صهر النبي) فسيح، به أربع شمعدانات مضاءة وقناديل معلقة. يُتلى القرآن ليل نهار. لا يوجد سوى آبار قليلة ذات مياه مالحة وقناة جافة. الغذاء الوحيد هو التمر والعنب واللوز بأسعار مرتفعة، يُقدم الشيخ للزوار أرزًا مطهوًا بالماء والملح والزيت. عدم وجود مراعي زاد من نقص الغذاء» [٨]. أما الرحالة الألماني نيبور فكتب عن زيارته سنة ١٧٦٥م/١١٧٩هـ: «مشهد علي في أرض جرداء كجدة، يعاني نقصًا حادًا في الماء. يستخدمون مياه الآبار للطبخ والغسيل، وينقلون مياه الشرب على الحمير من مسافة ثلاث ساعات. البيوت مبنية من الطين على قواعد جيرية، بسقوف مقببة. سكانها خليط من السنة والشيعة، تشبه القدس في هيئتها واتساعها. سور المدينة به بابان: باب المشهد وباب النهر، بينما سُدّ باب الشام. السور مُتداعٍ في عشرين مكانًا. بالإضافة إلى الضريح العظيم، توجد ثلاث قاعات اجتماع أصغر» [٩].
وذكرت المستشرقة الإنجليزية ليدي درور في رحلتها عام ١٩٢٣م/١٣٤٢هـ: «النجف مدينة جميلة، لكن شوارعها غير معبدة». وبعد عشر سنوات تقريبًا، جاء في «دليل أرض العراق» (١٩٣٥م): «شوارعها عريضة مُعبدة في معظمها، مبانيها ضخمة، وأسواقها منظمة خاصة السوق الكبير الممتد من السور الشرقي حتى صحن الإمام علي (ع). بالمدينة ثلاث مدارس حكومية وأخرى محلية ومدارس دينية عديدة، ومساجد تحتوي على قبور العلماء. سور المدينة العظيم بُني عام ١٢٣٢هـ/١٨١٦م بأمر محمد حسين خان علاف وزير فتح علي شاه القاجاري، وله أربعة أبواب».
في سنة ١٩٤٥م/١٣٦٩هـ، قررت بلدية النجف إحداث تغيير جذري فشقت شارعًا حول الصحن العلوي، وهُدمت أسواق قديمة لتحل محلها مباني حديثة. ظهرت شوارع مثل شارع الرسول مقابل باب القبلة، وشارع الطوسي، وشارع الإمام الصادق، وشارع زين العابدين. أُنشئت أكبر أسواق النجف (بطول ٥٠٠ متر) مع فروع متعددة. لكل حي سوقه الخاص، لكن لا توجد أسواق متخصصة بسلعة واحدة.
أصبحت النجف - باستثناء بعض أحيائها - مدينة حديثة نابضة بالحضارة. حتى عام ١٩٧٤م/١٣٩٤هـ، أُنشئت أحياء متكاملة الخدمات، ذات شوارع واسعة وحدائق ومدارس ومباني حكومية. اشتهرت النجف بحوزتها العلمية العريقة، التي كانت الأبرز عالميًا قبل صعود مدينة قم، ولا تزال تضم علماء كبارًا.
ارتبطت مكانة الحوزة العلمية في النجف بوجود مرقد الإمام علي (ع)، حيث كانت ملاذًا للعلماء المسلمين عبر العصور. سابقًا، كان الطلاب يتوجهون إلى النجف لإكمال دراستهم الدينية على يد علماء كبار - كثيرون منهم إيرانيون - لكن اليوم انتقل هذا الدور إلى حوزة قم [١٠].
الجغرافيا
النجف إحدى المدن العراقية المقدسة، تقع في محافظة تحمل نفس الاسم، وتُعتبر قبلة آمال محبي أهل البيت (ع) لوجود مرقد الإمام علي بن أبي طالب (ع)، أول أئمة الشيعة. يبلغ عدد سكان المدينة 563,000 نسمة، وتقع على بُعد 77 كيلومترًا جنوب شرق كربلاء و10 كيلومترات جنوب الكوفة. يُشير وجود مدينة الحيرة الأثرية المجاورة لها، والتي تمتعت بحضارة مزدهرة في تاريخ العراق، إلى عراقة المنطقة. يحدّها من الشمال "وادي السلام"، ومن الغرب "البحر الجاف لمدينة النجف"، وصحراء متصلة ببادية الشام تمتد حتى السعودية والأردن وسوريا [١١].
سبب التسمية
سُميت "النجف" لارتفاعها عن الأراضي المجاورة، ولشكلها المستطيل أو الدائري الذي لا تجتمع عليه المياه. وذكر ياقوت الحموي أنها ساحل بحر مالح كان متصلًا بالحيرة قديمًا. يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 70 مترًا. وقيل في تسميتها: إنها كانت مكانًا مرتفعًا زمن طوفان نوح (ع)، ثم تشكلت فيها بحيرة واسعة عُرفت بـ"النِّي"، وبعد جفافها سُميت "نِي جَفّ" [١٢].
أسماء أخرى
عُرفت المنطقة بأسماء عديدة مثل "الغري" أو "غرّيان" (من الجذر "غَرِي" بمعنى الجمال)، و"حد العذراء"، و"حوار"، و"جودي"، و"وادي السلام"، و"ظهر"، و"ربوة"، و"بانقيا"، و"مشهد". يُطلق على سكانها "غرويّون"، نسبةً إلى "الغري" [١٣].
الموقع الجغرافي
تقع النجف على حَدّ فاصل بين المدينة والصحراء، حيث تحيط بها رمال ترفع درجات الحرارة أحيانًا إلى 50°م. عانت المدينة تاريخيًا من ندرة المياه، رغم أن آبارها كانت تُروي 20 ألف نخلة في القرن السابع الهجري [١٤]. وصفها ابن جبير بأنها "أرض صلبة واسعة تُنعِش البصر بجمالها". اليوم، تتألف النجف -مثل كربلاء- من قسمين: المدينة الحديثة والقديمة.
التحليل اللغوي
يرى الدكتور مصطفى جواد أن اسم "النجف" (الذي يعني في اللغة: التلّ أو المرتفع) يُشير إلى طبيعتها كسَدّ طبيعي يصدّ المياه عن محيطها دون أن تغمرها موسوعة العتبات المقدسه، [١٥].
النجف من الناحية السياسية
لعبت فئتان رئيسيتان دورًا محوريًا في النجف: عامة الناس المُسلحين القادرين على المقاومة، والعلماء الذين تولّوا قيادة الحراك وتوجيهه. ولا يُمكن تجاهل صلات المدينة بالقبائل المحيطة، النابعة من روابط روحية وعقائدية. كما تمتع شباب النجف الواعي بثقافته بقدرة كبيرة على إيقاظ روح التحدي والعزة لدى الناس. بمراجعة السنوات المحيطة بالحرب العالمية الأولى، يبرز دور العلاقة الوثيقة بين المرجعية الدينية والجماهير في إبقاء الحركات المناهضة للاحتلال حية. فلم تعرف النجف السكينة خلال تلك الفترة، بل شهدت نشاطًا متواصلًا على جميع الأصعدة. كانت النجف من أوائل المدن العراقية التي انتشرت فيها المطابع، وتفاعلت مع الحركات التحررية في إيران وتركيا عبر إصدار المنشورات وتبني المواقف، مثل إعلان الجهاد ضد روسيا المحتلة لشمال إيران، والوقوف إلى جانب ليبيا ضد إيطاليا، مما يعكس وعي أبنائها ورفضهم للهيمنة الأجنبية [١٦]. مهدت هذه الخلفية لاندلاع أحد أكبر الحركات الشعبية تأثيرًا في النجف: ثورة ١٩١٨م/١٣٣٧هـ ضد الاحتلال البريطاني. بعد سقوط بغداد، سعت بريطانيا لبسط نفوذها على كامل العراق. حاول المحتلون إخضاع النجف عبر شراء الذمم وإغراء الزعماء بالقروض المالية، لكن المواجهة اندلعت عندما دخلت قواتهم الهندية المدينة، ورد المدافعون بإسقاط طائرة بريطانية، ما دفع البريطانيين إلى فرض الحصار . بتاريخ ١٩ آذار ١٩١٨م/٦ جمادى الثانية ١٣٣٦هـ، اغتالت "جمعية النهضة الإسلامية" الكابتن مارشال واثنين من جنوده، وهاجمت دار الحكم القديم وأحرقتها. لكن غياب دعم القبائل المجاورة سمح للجنرال ساندرز بإحكام الحصار، مما أجبر الثوار على الاستسلام بعد شروط قاسية شملت إعدام ١١ شخصًا ونفي ١٢٣ آخرين إلى الهند [١٧]. لم يكن فشل الثورة نهاية المطاف، بل شكّل بداية حراك متجدد. تصدّرت النجف المشهد مجددًا خلال انتفاضة ١٩٢٠م/١٣٣٩هـ ضد الاحتلال، بعد اعتقال شيخ شعلان أبو جون. أصدر آية الله الشيخ محمد تقي الشيرازي فتوى تاريخية تحث على المطالبة بالحقوق ثم الدفاع المسلح، مما حشد الجماهير وأربك البريطانيين [١٨]. واصلت النجف دورها الرافض للهيمنة عبر مقاطعة انتخابات المجلس التأسيسي ١٩٢٢م، بإصدار فتوى تحرّم المشاركة وتُخرج الناخبين من «دائرة الإسلام». كما لعبت دورًا محوريًا في إسقاط الاتفاقيات الجائرة مثل معاهدة ١٩٣٠م/١٣٤٩هـ، ودعمت الثورات المتتالية حتى انتصار ثورة ١٩٥٨م/١٣٨٧هـ التي أنهت الحكم الملكي المدعوم بريطانيًا [١٩]> ظلت النجف -برمزيتها الدينية ووعي شعبها- حصنًا للتحرر ودعم الحركات المناهضة للاستعمار في العراق والعالم العربي، مؤكدةً مكانتها كقلعة للمقاومة ورمزًا للكرامة [٢٠].
مرقد الإمام علي (ع) في مدينة النجف
خُفي مرقد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) طوال فترة حكم بني أمية، ولم يعلم مكانه سوى أبنائه وعددٍ من خواص الشيعة. بعد سقوط الدولة الأموية وصعود العباسيين، انتشر سرّ مكان دفنه تدريجيًا، فتوافد الشيعة لزيارته. كشف قبر الإمام علي (ع): تُروى قصة الكشف عن المرقد الشريف بأن هارون الرشيد خرج للصيد في النجف، فلاحظ هروب الظباء إلى تلّ مرتفع وتوقف كلابه عن مطاردتها هناك. استدعى رجلًا عجوزًا من المنطقة وأمّنه على نفسه، فكشف له العجوز أن الإمام جعفر الصادق (ع) أخبرهم بأن هذا التل يضم قبر جده علي (ع)، وأنه سيكشف قريبًا. أمر هارون بالحفر فاكتشفوا لوحًا مكتوبًا باللغة السريانية يُفيد: «هذا القبر حفره النبي نوح (ع) للإمام علي (ع)، وصيّ محمد (ص)، قبل الطوفان بسبعمائة عام». أكد الإمام موسى الكاظم (ع) صحة الموقع، فأمر هارون بإعادة الدفن ووضع حجر أساس عُرف بـ«التعجير الهاروني» [٢١].
حرم الإمام علي (ع)
يقع الحرم الشريف للإمام الأول للشيعة في النجف، حيث دُفن (ع) بعد استشهاده سنة 40 هـ على يد ابن ملجم. وفق وصيته، أُخفي القبر خوفًا من الخوارج حتى القرن الثاني الهجري، حين أعلن هارون الرشيد مكانه في عهد العباسيين. يعتقد الشيعة أن آدم ونوح (ع) دُفنا بجواره، بالإضافة إلى عددٍ من علماء الشيعة البارزين.
تاريخ العمارة
بعد الكشف عن القبر، شيّد هارون الرشيد أول بناء للمرقد سنة 171 هـ، تضمن قبةً وقبرًا من الحجر الأبيض. في العصر الحديث، نُقل نقشٌ تاريخي لرجل يحمل قوسًا وأيلًا - كان موجودًا بالقرب من الضريح - إلى متحف الحرم. كان للحرم أربعة أبواب، وتُوجت قبتُه بلون وردي مع علم أخضر في الأعلى.
تفاصيل الاستشهاد
أصيب الإمام علي (ع) أثناء صلاة الفجر في مسجد الكوفة ليلة 19 رمضان، وتوفي ليلة 21 رمضان سنة 40 هـ. أوصى ولديه الحسن والحسين (ع) بإخفاء قبره، فنُقل جثمانه ليلًا ودفن سرًا بمشاركة عددٍ من أهل البيت. بقي القبر مخفيًا حتى زوال خطر الخوارج، ليتحول لاحقًا إلى مزارٍ عالمي ومَعلَمٍ روحي يُجسد صمود التشيّع عبر التاريخ.
العمارة الثانية
بناها عمر بن يحيى من أصحاب الإمام الكاظم (ع).
العمارة الثالثة
بعد صعود الداعي الصغير (من أحفاد زيد بن الإمام زين العابدين) إلى السلطة في طبرستان، بدأ تشييد العمارة الثالثة للروضة العلوية بفخامة عظيمة، ضمت سبعين طاقًا.
hلعمارة الرابعة
أقامها عضد الدولة البويهي حوالي سنة 327 هـ/ 317 ش. تطوير حرم الإمام علي (ع): في العصر الصفوي، كسا الشاه طهماسب القبة الجصية بالقيشاني ووسع الحرم. أمر نادر شاه عام 1156 هـ بإزالة القيشاني القديم وتذهيب القبة، وأنفق ثروات على تزيينها بالذهب، مع إهداء تحف نادرة لخزانة الحرم. نُقش على القبة: «الحمد لله الذي جدد تذهيب هذه القبة المشرقة بأمر السلطان نادر شاه سنة 1156 هـ». صُمم صحن الحرم في عهد الشاه عباس الصفوي بتخطيط هندسي بديع من تصميم الشيخ البهائي، مُحاط بحجرات ذات إيوانات صغيرة كانت سكنًا للعلماء حتى القرن الرابع عشر الهجري. كُسيَت جدران الصحن بالقيشاني لأول مرة في عهد الشاه صفي. تخضع الروضة حاليًا لتوسعة تشمل الجزء الغربي (مُسمى باسم السيدة فاطمة "ع")، بتصميم معماري إيراني، لتبلغ مساحتها الإجمالية 140 ألف م².
المباني المجاورة للحرم
مسجد عمران بن شاهين
أقدم مساجد النجف، شمال الصحن، بُني بعد صلح بين عضد الدولة وعمران بن شاهين (منتصف القرن الرابع الهجري). أعيد ترميمه حديثًا ليصبح قاعة فخمة بعد أن كان مهجورًا.
مسجد الخضراء
شرق الصحن، كان مكان تدريس آية الله الخوئي. أُزيل الحاجز بينه وبين ضريح الخوئي (الحجرة 31) وأُستبدل بنافذة مشبكة.
حسينية آل زيني
غرب "باب الطوسي"، هُدمت وتُعاد بناؤها حاليًا.
مكتبة الروضة
غرب مسجد عمران بن شاهين، شمال الصحن.
تكية البكتاشية
شمال مسجد الرأس، بثلاثة أبواب، يُعتقد أنشئت في القرن الثامن الهجري زمن حاج بكتاش.
مسجد بالاسر
غرب الصحن، يحتوي محرابه على قطع قيشاني من القرن السادس الهجري.
مقام الإمام الصادق (ع)
قرب باب الفرج، كان مكان صلاة الإمام الصادق (ع) أثناء زيارته. اختفى الموقع حاليًا ضمن مشروع التوسعة.
إيوان العلماء
وسط الجانب الشمالي للرواق، سُمي لدفن علماء كبار فيه.
أماكن الزيارة في النجف
حرم الإمام علي (عليه السلام)
يقع في مركز المدينة، ويتميز بقبة ذهبية ضخمة وقاعة مقببة ورواقات متعددة وصحن واسع. بُنيت أول عمارة للحرم زمن الخليفة العباسي هارون الرشيد، ثم خضعت للتجديد عبر العصور. يعود البناء الحالي للعصر الصفوي، حيث زُينت القبة والأروقة بذهب بأمر نادر شاه الأفشاري، بينما نفذ فنانون من أصفهان الأعمال الزجاجية المعكوسة. يضم الضريح صندوقًا من الخشب المطعم بالخاتم (من عهد الشاه إسماعيل الصفوي) محاطًا بضريح فضي.
مميزات الصحن
تختفي الظلال من الجانب الشرقي تمامًا وقت الظهر الشرعي في جميع الفصول. أول أشعة شمس الفجر تمر عبر السوق الكبير وتنعكس على الضريح عبر بوابة الصحن. يحيط بالصحن غرف تُخَصَّص لدفن الشخصيات البارزة. له أربع بوابات رئيسية: أكبرها "باب الذهب" (شرقًا)، و"باب الطوسي" (شمالًا)، و"باب القبلة" (جنوبًا)، و"باب السلطاني" (غربًا).
مقبرة وادي السلام
تقع شمال شرق النجف، وهي من أقدس المقابر الشيعية عالميًا. تضم: قبر النبي هود (ع) والنبي صالح (ع). مقام الإمام الصادق (ع) والإمام السجاد (ع). قبور علماء وسادات ومقامًا يُنسب لصاحب الزمان (عج). ورد في الروايات أن أرواح المؤمنين تُدعى للالتحاق بوادي السلام ("بقعة من الجنة")، ويُنقلون إليها بواسطة مَلَكٍ يُدعى "نَقّالة".
مقام صاحب الزمان (عج)
موقع مقدس داخل وادي السلام يُزَار للصلاة والدعاء.
مرقد كميل بن زياد النخعي
يقع على طريق النجف-الكوفة، ويضم صحنًا واسعًا وقبة كبيرة.
مقام الإمام زين العابدين (ع)
غرب النجف، يُذكر أن الإمام السجاد (ع) صلى فيه أثناء زيارته لقبر جده الإمام علي (ع).
مرقد الشيخ الطوسي (جامع الشيخ الطوسي)
بجوار الحرم العلوي، دُفن فيه مؤسس حوزة النجف العلمية. تحول منزله إلى مسجدٍ ظلّ مركزًا للدراسة الدينية طوال عشر قرون. يضم المسجد أيضًا قبر العالم الشهير محمد مهدي بحر العلوم.[٢٢].
الحوزة العلمية في النجف
لم تكن النجف الأشرف قبل شهادة أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أرضاً معروفة، وقد نالت شرفها من كونه "مولود الكعبة" الذي دُفن فيها بعد استشهاده، فجذب إليها سيلاً من المحبين. كانت هذه المدينة قبل هجرة الشيخ الطوسي تضم بعض العلويين والشيعة المخلصين لأمير المؤمنين (ع). لكن مع هجرة الشيخ الطوسي، تحولت النجف إلى مركز للشيعة وجامعة كبرى للإمامية، حيث تخرج منها آلاف الطلاب والعلماء الذين ساهموا في نشر معارف أهل البيت (عليهم السلام). تمتد الحوزة العلمية في النجف الأشرف لأكثر من ألف عام، وكانت لسنوات طويلة مقراً لقادة الشيعة الإمامية، ومن أبرز أسمائهم حسب الترتيب:
- شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (385–460 هـ).
- الشيخ أبو علي (ابن الشيخ الطوسي) (حيّاً حتى 515 هـ).
- أبو نصر محمد بن أبي علي الحسن بن أبي جعفر محمد الطوسي.
- الفاضل المقداد (ت 826 هـ).
- شيخ الإسلام علي بن هلال الجزائري (ت 937 هـ).
- المحقق الثاني علي بن عبد العالي الكركي (ت 940 هـ).
- أحمد بن محمد الأردبيلي، المشهور بالمقدس الأردبيلي (ت 993 هـ).
- السيد مهدي بحر العلوم (1155–1212 هـ).
- الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت 1228 هـ).
- الشيخ محمد حسن النجفي، صاحب الجواهر (1200–1266 هـ).
- الشيخ مرتضى الأنصاري (1214–1281 هـ).
- الآخوند ملا محمد كاظم الخراساني (1255–1329 هـ).
- العلامة ميرزا محمد حسن النائيني (1276–1355 هـ).
- آية الله شيخ الشريعة الأصفهاني (1266–1339 هـ).
- آية الله السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي (1247–1338 هـ).
- آية الله السيد أبو الحسن الأصفهاني (1277–1365 هـ).
- آية الله السيد محسن الحكيم (1264–1390 هـ).
- آية الله السيد أبو القاسم الخوئي (1317–1413 هـ).
لا يُعتقد أن النجف كانت خالية من علماء الشيعة قبل الشيخ الطوسي، بل إن بعض علماء الشيعة سكنوها وأجازوا الرواية عنهم. لكن النجف أصبحت مركزاً للفقه الشيعي وعلوم آل البيت (ع) بعد هجرة الشيخ الطوسي إليها، حيث أسس الحوزة العلمية مع تلاميذه [٢٣].
مساجد مدينة النجف
مسجد حنَّانة
من المساجد التي يزورها الحجاج في النجف ويتبركون به. وفقاً للروايات، وُضع الرأس الشريف للإمام الحسين (ع) في هذا الموقع أثناء نقله من كربلاء إلى الكوفة، لذا يُعرف أيضاً بـ"رأس الحسين". صلى الإمام جعفر الصادق (ع) في هذا المكان أثناء زيارته لمرقد جده أمير المؤمنين (ع). ذكر السيد ابن طاووس في آداب الزيارة زيارة خاصة للإمام الحسين (ع) في هذا المسجد.
مسجد عمران بن شاهين
من أقدم وأشهر مساجد النجف، بناه عمران بن شاهين في منتصف القرن الرابع الهجري. يقع عند مدخل الصحن من جهة باب الطوسي. ثار عمران ضد عضد الدولة في العراق وهُزم، فنذر بناء رواق في النجف عند مرقد الإمام علي (ع) إذا عفا عنه، فتحقق نذره. تحول هذا الرواق لاحقاً إلى مسجد بعد تغيير بناء الحرم، ودُفن فيه علماء كالسيد محمد كاظم اليزدي صاحب "عروة الوثقى" والعلامة السيد محمد كاظم المقدس.
مسجد صفوة الصفا
من المساجد القديمة في محلة "شيلان"، يعود بناؤه للقرن الثامن الهجري. يقع في أقصى غرب المدينة، ويُقال أن أمير المؤمنين (ع) صلى فيه، ويضم قبر أحد أصحابه. مجاور لمقام الإمام السجاد (ع).
المسجد الخضراء
من المساجد القديمة شرق الصحن، كان مركز تدريس آية الله الخوئي. بناه علي بن مظفر، وأُعيد بناؤه عام 1380 هـ بواسطة الشيخ أحمد الأنصاري القمي.
مسجد الشيخ الطوسي
كان منزلاً للشيخ الطوسي، ثم تحول إلى مسجد بناءً على وصيته. يقع في محلة "المشراق" شمال الصحن، وهو إرث عظيم للعالم الإسلامي. أُجريت عليه ترميمات رئيسية مرتين.
مسجد الشيخ الأنصاري
بُني في محلة "حويش" بدعم من الشيخ مرتضى الأنصاري، ويُعتبر من المراكز التعليمية البارزة. درّس فيه السيد محمد كاظم الطباطبائي والإمام الخميني (ره).
مسجد الهنْدي
من أكبر مساجد النجف، يُقام فيه صلوات الجمعة والعزاء الحسيني. بُني عام 1323 هـ، ووسّعه العلامة السيد محسن الحكيم. يُستخدم للاعتكاف وأهم المراسم الدينية بعد الحرم.
مسجد الشيخ الطريحي
من المساجد الكبيرة المشهورة، نُسب إلى المحقق الكركي، وأُجريت عليه ترميمات عام 1376 هـ.
مسجد الشيخ شوشتر
في محلة المشراق، اعتاد الواعظ الشيخ جعفر شوشتري إلقاء مواعظه فيه.
مسجد الميرزا الشيرازي
من المساجد المزدحمة بالمصلين. ومن المساجد الأخرى المشهورة: مسجد آل كاشف الغطاء، مسجد الجواهري، مسجد الرأس، ومسجد الحيدري [٢٤].
مقبرة وادي السلام
تعد مقبرة وادي السلام واحدة من أكثر المقابر قدسية لدى المسلمين والشيعة. ورد في الروايات: "ما من مؤمن يموت في شرق الأرض أو غربها إلا نودي لروحه أن التحقي بوادي السلام". ويوجد ملك اسمه "ملك النقلة" ينقل أرواح المؤمنين من جميع أنحاء العالم إلى هذه المقبرة. تقع المقبرة شمال مدينة النجف، وتبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع، ويعود تاريخها لأكثر من ألف عام. دُفن فيها العديد من الشيعة من مختلف المناطق، وكثيرون يوصون بدفنهم فيها قبل وفاتهم. تكمن أهمية المقبرة في مجاورتها لمرقد الإمام علي (ع). وردت فضائل كثيرة لهذه المقبرة في المصادر الشيعية. أقدم رواية معتبرة في هذا الشأن نقلها الكليني (ت 328 هـ) عن الإمام علي (ع) الذي زار المقبرة مع أحد أصحابه وقال: "ما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه الحقي بوادي السلام، وإنها لبقعة من جنة عدن". ونقل المجلسي الثاني رواية تفيد أن النبي (ص) زار وادي السلام ليلة المعراج مع جبريل وصلى فيها، وكانت مصلى آدم والأنبياء. كما ورد أنها أول مكان على الأرض عُبد الله فيه [٢٥].
السكان
بحسب إحصاء 2017م، يبلغ عدد سكان محافظة النجف مليون ونصف المليون نسمة، منهم حوالي 800 ألف في مدينة النجف. بسبب وجود مرقد الإمام علي (ع)، فإن معظم السكان مسلمون شيعة. ينتمي بعض السكان إلى قبائل بدو الحجاز، والبعض الآخر إلى عشائر عراقية. يزور النجف يومياً حوالي 50 ألف زائر في الأيام العادية، وقد يصل العدد إلى مليون ونصف المليون في المناسبات الخاصة. تهاجر أعداد كبيرة من مختلف أنحاء العالم إلى النجف. وبما أن النجف تعتبر مدينة دينية، فهي تخلو من دور السينما والمسارح [٢٦].
الأحياء القديمة
كانت النجف القديمة تتكون من أزقة ضيقة متداخلة، حيث كان الزائر يرى القبة والمنائر من فوق أسطح المنازل أثناء توجهه نحو الحرم، ثم يجد نفسه فجأة أمام مرقد أمير المؤمنين (ع) الذي يملأ القلب هيبة وقدسية. تنقسم المدينة القديمة إلى أربعة أحياء: المشراق البراق العمارة الحويش أما المدينة الجديدة فقد بنيت في العقود الثلاثة الأخيرة وتتميز بتخطيط عمراني جيد مع شوارع واسعة ومساحات خضراء [٢٧].
مواضيع ذات صلة
الهوامش
- ↑ ماضی النجف و حاضرها، ص١۶
- ↑ تخطیط مدینة الکوفه، ص٣٢
- ↑ فرحةالغری، سید بن طاووس، ص١٢٢
- ↑ الدیارات، ص٢٣٠
- ↑ دلیل النجف الاشرف، ص٢٣
- ↑ رحلة ابن جبیر، ص١۶٣ و ١۶۴
- ↑ مباحث عراقیة، القسم الثانی، ص٣٣۵
- ↑ العراق فی القرآن السابع عشر، ص٢۴ و ٢۵
- ↑ مشاهدات نیبور فی رحلته من البصرة الی الحلة سنة١٧۶۵م، ص٧٧-٧٩
- ↑ فی بلاد الرافدین، صور و خواطر، لیدی درور، ص٧١-٧٣
- ↑ یاقوت حموی، معجم البلدان، 5/271؛
- ↑ ابن بابویه، علل الشرایع، 22
- ↑ شیخ باقر آل محبوبه، ماضی النجف وحاضرها، بیروت دارالاضواء، 1406 ق، 1/8
- ↑ یاقوت حموی، معجم البلدان، 5/271.
- ↑ جعفر الخلیلی، مقاله دکتر مصطفی جواد، ص9
- ↑ فصول من تاریخ العراق القریب، جعفر خیاط، ص١٢٧
- ↑ ثورة النجف، عبدالرزاق الحسنی، ص٢۴-٣۴
- ↑ الحرکة الوطنیة فی العراق ١٩٢١-١٩٣٣
- ↑ احرار العراق، انتفاضة العراق الاخیرة، ص۵٢-۵۵
- ↑ احرار العراق، انتفاضة العراق الاخیرة، ص۵٢-۵۵
- ↑ بحارالانوار: 42 ص 330
- ↑ دور الشیعه فی بناء الحضاره الاسلامیه، استاد جعفر سبحانی، ص 128ـ127
- ↑ الحوزه العلمیه نجف اشرف - مرکز للمطالعات
- ↑ بابائی، سعید، گزیده سیمای نجف اشرف، ص۳۷-۴۳
- ↑ الانوار، ج ۹۷، ص ۲۴۹- ۲۵۰، ۴۵۴
- ↑ الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب ج۵، ص۶۰۰
- ↑ جمالالدین، ملامح فی السیره، ۲۰۰۳م، ص۱۷