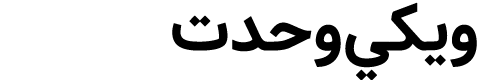الحسن والقبح
الحسن والقبح: مجمل الكلام عن الحسن والقبح في أنّهما ممّا يُدركان بالعقل أم لا؟ كما لحق هذا بحوث من قبيل: امكانية إدراك العقل للحسن والقبح وذاتية أو عدم ذاتية الحسن والقبح للأفعال وغيرها من البحوث التي طرحت، وتطرح عادة في علم الكلام.
ويرى ابن تيمية أنّ نفي الحسن والقبح العقليين مطلقا لم يقله أحد من سلف الاُمة ولا أئمتها [١]، وقد اعتبر بعض نفي الحسن والقبح العقليين من البِدع التي أحدثت في عهد أبي الحسن الأشعري لمّا ناظر المعتزلة في القدر بطريق الجهم بن صفوان ونحوه من أئمة الجبر، فاحتاج إلى هذا النفي [٢].
وأرجع بعض آخر تاريخ المسألة إلى فلاسفة الإغريق، حيث قسّموا الحكمة إلى عملية ونظرية، والحكمة العملية: هي إدراك العقل ما من شأنه أن يُعمل، عكس النظرية التي هي: إدراك العقل ما من شأنه أن يُعلم. وذكروا مثالاً للحكمة العملية، وهو الحسن والقبح [٣].
والمسألة من توابع مسألة الحاكم وتحديده والخلاف الذي وقع بين المعتزلة و الأشاعرة، حيث ثبّتت المعتزلة إمكانية حكم العقل على المكلّفين وإدراكه للحسن والقبح، بينما نفى الأشاعرة هذا وقالوا: بأنّ الحكم هو خطاب الشرع فحسب، فلا حاكم على المكلّفين غير الشرع، ولا قابلية للعقل بأن يحكم أو يدرك الحسن والقبح [٤]. كما أنّ المسألة في أصول الفقه نالت تفريعات ومسائل جزئية من قبيل: التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع.
تعريف الحسن والقبح
اختلفت تعاريف الحسن والقبح، باعتبار اختلاف معانيهما من جهة واختلاف وجهات النظر من حيث كونهما عقليين أم شرعيين من جهة اُخرى. وعليه، يمكن تقسيم التعاريف بعدد المعاني والمباني الواردة في الحسن والقبح. وفي البداية نورد المعاني الواردة لهما، ثُمّ نورد التعاريف التي ثبّتها الأصوليون:
المعنى الأوّل: ما يلائم الطبع وينافره، كالحلاوة والمرارة والفرح والحزن، وليس هذا محلّ نزاع لاختلافه باختلاف الأغراض.
المعنى الثاني: كون الشيء صفة كمال أو نقص كالعلم والجهل، وهذا المعنى للحسن والقبح عقلي، أي يعرف بالعقل بلا خلاف.
المعنى الثالث: كون الفعل موجبا للثواب والعقاب أو المدح والذمّ.
والأخير هو موضع النزاع، فالأشاعرة قالوا: بعدم إمكان العلم به إلاّ من خلال الشرع، بينما المعتزلة والشيعة قالوا: بإمكان معرفته بالعقل [٥].
وورد عن بعض المتأخّرين تعبير ملاك الحسن والقبح بدلاً عن معانيه، فوردت عنهم الموارد التالي ذكرها كملاكات للحسن والقبيح، ويبدو أنّ هذا تعبير آخر عن المعاني المختلفة للمفردتين:
1 - موافقته ومنافرته للطبع، ويراد من الطبع هو البُعد العلوي والجانب الملكوتي والروحاني من الإنسان، والذي تناط به إنسانية الإنسان.
2 - موافقة الأغراض النوعية التي يدور بقاء النظام عليها، كالعدل الذي يقيم النظام، والظلم الذي يهدمه.
3 - موافقة الكمال النفسي، فالفعل إذا كان محصّلاً للكمال فهو موصوف بالحسن، وإذا كان غير محصّل فهو موصوف بالقبح. وهذا يمكن أن يعود إلى الملاك الأوّل؛ لأنّ الميل إلى الكمال أمر فطري، فالفعل إذا حصَّل الكمال فهو موافق الطبع.
4 - موافقة العادات والتقاليد وعدم موافقتها، فما وافقها حسن وما خالفها قبيح. وهذا لا يشمل أفعال اللّه؛ لأنّه لا يمكن وصف أفعاله بالتقاليد والعادات التي هي اُمور عرفية مع أنّها اُمور نسبية وغير ثابتة.
لكن الحسن والقبح موضع البحث هو الأوّل فقط [٦].
وبناءً على الاختلاف في معنى الحسن والقبح، وتمشيا مع المبنى المعتمد في هذه المسألة، ما إذا كان أشاعريا أو معتزليا، وردت التعاريف عن الأصوليين مختلفة، نورد بعضها هنا:
فالتي تشير إلى الأفعال تعاريف:
منها: الحسن هو ما للمكلّف أن يفعله أو ما لفاعله أن يفعله، والقبح هو ما ليس للمكلّف فعله أو ما ليس لفاعله أن يفعله [٧].
ومنها: الحسن ما للقادر عليه المتمكّن من العلم بحاله أن يفعله، ويتبع ذلك أن يستحقّ المدح، والقبيح ما ليس للقادر عليه المتمكّن من العلم بحاله أن يفعله، ويتبع ذلك أن يستحقّ الذمّ بفعله [٨].
ومنها: الحسن هو ما لم يكن على صفة تؤثّر في استحقاق فاعله الذمّ، والقبح هو ما كان على صفة لها تأثير في استحقاق فاعله الذمّ [٩].
والتي تشير إلى منشئه ما إذا كان الشرع أو العقل، فتعاريف:
منها: الحسن هو ما أمر اللّه به، والقبيح هو ما نهى اللّه تعالى عنه. أو الحسن هو ما لم ينه عنه الشارع، والقبيح هو ما نهي عنه شرعا. أو الحسن هو المأذون فيه شرعا، والقبيح هو المنهي عنه شرعا [١٠].
ومنها: الحسن هو ما أمرنا اللّه بمدح فاعله وتعظيمه وحسن الثناء عليه والعدول عن ذمّه وانتقاصه. والقبيح هو ما أمرنا اللّه تعالى بذمّ فاعله وانتقاصه وسوء الثناء عليه به [١١].
والتي تشير إلى شؤون اُخرى من قبيل: جلب المنفعة أو التوافق مع الغرض، فتعاريف:
منها: الحسن هو ما يعود على فاعله نفع محض، والقبيح هو ما يعود على فاعله ضرر محض.
ومنها: الحسن هو المقبول والمرضي، والقبيح هو عكسه[١٢].
ومنها: ما وافق الغرض فهو حسن وما خالفه فقبيح [١٣].
المسألة أصولية أم كلامية؟
اختلف الأصوليون في كون هذه المسألة أصولية أم كلامية، فذهب الكندي الأنصاري إلى أنّها أصولية راجعة إلى أنّ الأمر الإلهي يدلّ على الحسن اقتضاء، والنهي الإلهي يدلّ على القبح كذلك [١٤].
بينما يذهب بعض المتأخّرين إلى أنّها مسألة كلامية بالأصالة، وهي مبدأ أصولي في الوقت ذاته، بسبب توقّف كثير من المسائل الأصولية عليها، من قبيل: حكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع [١٥].
ومع غضّ النظر عن كلا الرأيين فإنّ المسألة لا تخلو من أبعاد كلامية وأصولية بل وفقهية كذلك، ولهذا نجد دراستها في علم الكلام وأصول الفقه.
حكم العقل بالحسن والقبح
اختلفت الفرق والمذاهب فى حكم التحسين والتقبيح، والاختلاف ـ ذات الصلة بأصول الفقه ـ جلّه قد انصبّ على كون العقل ممّا يدرك حسن الأشياء وقبحها أو لا يدرك، وفي هذا المجال عدّة نظريات وآراء أوردها بعض المتأخّرين بالنحو التالي:
النظرية الاُولى: كونهما ذاتيين للأفعال الصادرة من الفاعل باختياره
فإذا نظر العقل إلى فعل وتجرّد عن كلّ شيء يستقلّ بحسنه أو قبحه، فالفعل علّة تامّة لحكم العقل بالحسن أو القبح.
النظرية الثانية: كونهما اقتضائيين
أي أنّ نفس الفعل مجرّدا عمّا يترتّب عليه من المصالح والمفاسد ليس علّةتامّة لحكم العقل بالحسن أو القبح، إنّما للفعل اقتضاء لأحد الحكمين، والعنوان الذي يكتسبه الفعل هو الذي يقتضي حكم العقل، ولذلك قد يكون الصدق قبيحا إذا كان مظنّة للفتنة وإراقة الدماء.
النظرية الثالثة: التحسين والتقبيح يدخل في إطار المصالح والمفاسد
أي أنّ حكم العقل يدور مدار المصالح والمفاسد، فإذا ترتّبت مصلحة على أمر ما حكم بالتحسين، وإذا ترتّبت مفسدة على أمرٍ ما حكم بالتقبيح.
النظرية الرابعة: التحسين والتقبيح يختلفان حسب نيّة الفاعل
أي أنّ حكم العقل يدور مدار نيّة الفاعل.
النظرية الخامسة: كون الحسن وصفا ذاتيا للأفعال بخلاف القبح
فإنّه يدور مدار نيّة القاصد [١٦].
ونعرض بشيء من التفصيل لبعض من هذه الآراء والنظريات لأهمّيتها ودورها فى الجدل الأصولي والكلامي الذى احتلّ حيّزا من البحوث في هذا المجال.
1 - رأي الأشاعرة
برغم اختلاف الأشاعرة في قضية الحسن والقبح فإنّ مجمل رأيهم في هذا المجال هو نفي التحسين والتقبيح العقليين. وقد فصّل البعض موقفهم وقسّم البحث في هذا المجال إلى أربعة فصول:
الأوّل: الأفعال، وقالوا: إنّها لا تحمل أوصافا ذاتية ملازمة توجب على الشرع حكمه بحسنها أو قبحها، وبتعبير آخر: لا يقبح شيء في حكم اللّه تعالى لعينه، كما لا يحسن لعينه.
الثاني: الشرع، وهو الذي يحسّن ويقبّح بمطلق إرادته، وأمر اللّه ونهيه هما اللذان يحسّنان الشيء أو يقبّحانه، فإذا أمر بشيء أصبح حسنا وإذا نهى عنه أصبح قبيحا.
الثالث: العقل، وإذا كان العقل مدركا لحسن بعض الشؤون وقبح اُخرى، مثل: الكذب، والصدق، والكمال، والنقص، فإنّه لا يدرك الحسن والقبح في التكاليف؛ لأنّه لا أحد يدرك ما يترتّب عليه ثواب أو عقاب إلاّ اللّه، والرسالات تعكس ما يراه حسنا أو قبيحا، فهي الكاشفة لا العقل.
الرابع: الحسن والقبح، ليسا صفتين ثابتتين للأفعال، بل الحسن يعني التحسين الشرعي (أي ما رآه الشرع حسنا وأمر به) والقبح ما قبّحه الشارع (أي رآه قبيحا ونهى عنه)[١٧].
أدلّة الأشاعرة
استدلّ الأشاعرة على مجمل رأيهم القائل بعدم التحسين والتقبيح العقليين بعدّة أدلّة نقلية وعقلية أو إدغاما بين الاثنين، نورد بعضها هنا:
1 - لو كان الفعل حسنا أو قبيحا بالعقل لزم تعذيب تارك الواجب ومرتكب الحرام، سواء صدر من الشارع في هذا المجال أمر ونهي أم لم يصدر، بينما يقول اللّه: «وما كُنّا مُعذّبين حتّى نبعثَ رسولاً» [١٨]. ولو كان العقل حاكما والأحكام مدركة بالعقل لما احتاج الإنسان إلى بعث رسول من اللّه.
وقد استدلّ كذلك بآيات اُخرى في هذا المجال من قبيل: النساء: 165، والأنعام: 130 و 131، والمائدة: 19، وطه:134، والملك: 8.
2 - لو كانت صفات الأفعال ذاتية لما اختلفت في حالات دون اُخرى، فلو كان القتل قبيحا لقبح القصاص كذلك، ولو كان الكذب قبيحا لذاته لقبح حتّى لو كان لأجل عصمة دم نبي أو ولي.
3 - البحث فيما يحسن ويقبح عند اللّه مع غضّ النظر عن موافقته لغرض المكلّف أو مخالفته، وهذا أمر لا يعلمه إلاّ اللّه؛ لأنّه من الغيبيات، فهو الوحيد الذي يعلم بما يحسن أو يقبح من وجهة نظره وبما يقبح، والمكلّف لا يعلم بمقياس الحسن والقبح عند اللّه.
وهناك استدلالات ووجوه عقلية اُخرى استدلّ بها على رأي الأشاعرة [١٩]. ومجمل هذه الاستدلالات غير خالية عن الإشكالات والردود [٢٠].
2 - رأي المعتزلة
اتّفق أتباع المعتزلة على أنّ الحسن والقبح ثابتان للأفعال، لكنّهم اختلفوا في جهة ثبوتهما للأفعال، وانقسموا إلى أربع طوائف:
الاُولى: طائفة ذهبت إلى أنّ الحسن والقبح ذاتيان للأفعال مطلقا.
الثانية: يحكم بالحسن والقبح لصفة في الفعل، فالصدق حسن إذا وصف بأنّه نافع، والكذب قبيح إذا وصف بأنّه مضرّ.
الثالثة: الحسن ذاتي للأفعال بينما القبح لا يكون إلاّ لصفة، فالصدق حسن لذاته، لكنّه يكون قبيحا لصفة، وهي الضرر.
الرابعة: الحسن والقبح اعتباريان، فيقبح الفعل لاعتبار ويحسن لاعتبار، فالسجدة تحسن إذا كانت للّه وتقبح إذا كانت للصنم [٢١].
أمّا الإمامية فيبدو اتفاقهم مع المعتزلة في هذه الرؤية [٢٢]. هذا مع غض النظر عن أنّهم أخذوا هذه الرؤية من المعتزلة أم المعتزلة أخذوها منهم، ومع غض النظر عن الاختلافات العقدية ذات الصلة بهذا الموضوع بين الإمامية والمعتزلة [٢٣].
العقل مدرك وليس حاكما
برغم قول المعتزلة بالحسن والقبح العقليين [٢٤] إلاّ أنّ قولهم لا يعني كون العقل هو الذي يحكم بحسن الاُمور أو بقبحها، بل مقولتهم تعني كون العقل مدركا لحسن الأفعال وقبحها لا موجبا لها، كما أنّه يدرك وجوب بعض الأفعال على اللّه تعالى؛ باعتباره حكيما ويوجب ما فيه مصلحة ويحرّم ما فيه مفسدة [٢٥].
لكن يبدو من البعض أنّ هذا الخلاف لفظي، ولا خلاف بين المسلمين أصلاً في أنّ الحاكم هو اللّه وأنّ مراد المعتزلة من كون العقل حاكما هو كونه مدركا لا غير [٢٦].
استدلالات المعتزلة
استدلّ المعتزلة والقائلون بالتحسين والتقبيح العقليين من غير المعتزلة (كالشيعة) على أصل كون الحسن والقبح عقليين باُمور:
1 - بداهة العقل، فيعدّ المعتزلة الحكم أو الإدراك المزبور من بديهيات العقل العملي. وهذا الصنف من الأحكام لم ينشأ عن ترسيخ التعاليم الدينية في أذهان المسلمين وإلاّ لاختصّ بهم، بينما نجده يتعدّاهم [٢٧].
2 - لو كان الحسن والقبح مرتبطين بالأمر والنهي لترتّب عليه أنّ العدل والإنصاف سيكونان قبيحين إذا نهى عنهما اللّه، والكذب حسن إذا أمر به اللّه، مع أنّ المعلوم خلافه [٢٨].
3 - لو لم يكن الحسن والقبح معلومين قبل الشارع لاستحال العلم بهما بعد ورود الشارع؛ لأنّه لا يعلم عندئذٍ بحسن الشريعة ولا قبح مخالفتها [٢٩].
4 - إطباق العقلاء على حسن بعض الأفعال، مثل: إنقاذ الغرقى، وقبح البعض، مثل: الكذب برغم اختلافهم في الشرائع واختلاف قرائحهم، ما يدلّ على كون العقل مدركا لهما بالضرورة ودون الحاجة إلى الشرع [٣٠].
5 - لو كان حسن الفعل لأمر الشارع به وقبحه لنهي الشارع عنه للزم عدم علم مثل الملاحدة بقبح الظلم والكذب بينما الواقع أنّهم يعرفون ذلك [٣١].
وهناك وجوه عقلية اُخرى كذلك [٣٢].
6 - الآيات التي تدعو إلى التدبّر والتفكير من قبيل: «أفلَم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذينَ من قبلهم» [٣٣] و «أوَلم يتفكّروا في أنفسهم ما خلقَ اللّه السموات والأرض وما بينهما إلاّ بالحقّ» [٣٤]. وكذلك الآية 185 من سورة الأعراف، والآية 46 من سورة الحجّ.
ووجه الاستدلال بهذه الآيات هو أنّ الإنسان لو كان معذورا بترك الاستدلال بالعقول وعدم العمل وفق ما تحسّنه أو تقبّحه، لما عاتبهم اللّه في الآيات السابقة ولما كان معنى للآيات أصلاً [٣٥].
مواقف المذاهب الفقهية من المسألة
لا يبدو أنّ المواقف التي التزمها الفقهاء في قضية الحسن والقبح ناشئة عن مبادئ فقهية مذهبية، ولذلك تفاوتت المذاهب الفقهية فى مواقفها تجاه المسألة، فقد تلتزم رأي المعتزلة أو رأي الأشاعرة، وقد تسعى للموافقة بين الرأيين؛ وذلك كلّه لعدم تأثيرها في المذهب من الناحية الفقهية. برغم أنّها قد تكون مفيدة في القول بتخطئة المجتهد أو تصويبه، وفي تعليل الأحكام، و الاجتهاد، وفي تحديد حكم العقلاء قبل ورود الشرع، وشكر المنعم. وهي مسائل أصولية أو كلامية وليست فقهية [٣٦].
فائدة المسألة
ذكرت عدّة ثمرات لهذه المسألة تدخل ضمن علم الكلام، والأخلاق، والفقه، وأصول الفقه:
الثمرات الكلامية هي من قبيل: مسألة وجوب شكر المنعم [٣٧]، أو وجوب اللطف، أو وجوب نصب الإمام على اللّه. فإنّه قد يقال: بكون هذه الأحكام عقلية وتدرك بالعقل دون تدخّل الشرع، وقد يقال بالعكس [٣٨].
والثمرات الفقهية هي من قبيل: صحّة إسلام الصبي المميز؛ باعتبار حكم العقل بالصحّة. وقبول خبر الواحد في رؤية الهلال أو عدم قبوله. وانعقاد نذر صوم يوم العيد وأيّام التشريق أو عدمه [٣٩].
إنّ أبرز النتائج لمسألة الحسن والقبح في علم الأخلاق هي كونها دعامة وحيدة لاستنتاج الفضائل والمسائل الأخلاقية [٤٠].
أمّا الثمرات الأصولية فيبدو أنّ كلّ استدلال يعتمد الاستحسانات العقلية يعتمد في النهاية مسألة التحسين والتقبيح العقليين، فلابدّ أن يقرّ بها أو يرفضها، وقد عدّ البعض الكثير من البحوث الأصولية التي استفيد فيها من مسألة التحسين والتقبيح، من قبيل الموارد التالية:
1 - قد يقال بعدم وجود مباح في الشريعة، حيث ذهب إلى هذا الكعبي، واستدلّ عليه بأنّ المكروه والحرام قبيحان، وكلّ قبيح منهي عنه، والمباح حسن وكلّ حسن مأمور به....
2 - حكم أفعال العقلاء قبل الشرع ما إذا كان على الإباحة أم لا؟ فإنّ بعضهم يحكّم العقل والقاعدة المزبورة لإثبات رأيه، فقد يستدلّ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
3 - التكليف بما لا يطاق، فقد يستدلّ على عدم صحّته بأنّه قبيح عقلاً، والقبيح منهي عنه.
4 - خلوّ واقعة عن حكم اللّه، فبعض فرّع هذه المسألة على حكم العقل بالتحسين والتقبيح، فيستصحب حكم العقل قبل الشرع في الموارد التي تخلو الواقعة عن حكم شرعي.
5 ـ الإتيان بالمأمور به مسقط للأمر؛ لاستقلال العقل بقبح بقاء الأمر مع الإتيان بالمأمور به بأجزائه وشرائطه.
ومن هذه الموارد نجد الكثير من البحوث والاستدلالات المتناثرة في ثنايا المطالب الأصولية. وقد تناول البعض دراسة وجوه تأثير مسألة التحسين والتقبيح والاعتقاد بها أو عدمه بالتفصيل، وسرد الكثير منها [٤١].
ومن جانب آخر، قد تُذكر ثمرة للأحكام التي تستمدّ من قاعدة التحسين والتقبيح، فقد قيل في مواصفات الحكم الشرعي المستمدّ ملاكه من هذه القاعدة كونه حكما مؤبّدا بتأبيد ملاكه؛ لكون حسنه أو قبحه ذاتيا، لا يتغيّر ولا يتبدّل، من قبيل: شكر النعمة، فهو حسن على كلّ حال، وكفرانها قبيح [٤٢].
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
من البحوث المترتّبة على ثبوت التحسين والتقبيح العقليين هو البحث في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، أي إذا حكم العقل بحسن أمر ما فهل يأمر الشرع بذلك الأمر؟ وإذا حكم العقل بقبح أمر ما فهل ينهى الشرع عن ذلك الأمر؟ [٤٣]
ذهب إلى هذه الملازمة المعتزلة و الشيعة ونفى هذه الملازمة الأشاعرة، و أهل السنّة، و الأخباريون من الشيعة [٤٤]. وخالف صاحب (الفصول الغروية) أصوليي الشيعة [٤٥].
وبرّر الشيخ المظفر ذهاب الأخباريين وصاحب (الفصول) إلى عدم القول بالملازمة بأنّ نظرهم كان منصبّا على غير المستقلاّت العقلية، من قبيل: القول بـ القياس و الاستحسان وما شابه، ولا يقصدون المستقلاّت العقلية التي تطابقت عليها آراء العقلاء [٤٦].
أدلّة القائلين بالملازمة
تناول الشيخ السبحاني هذه الملازمة من خلال تقسيمه أحكام العقل إلى قسمين، ومن خلال ذلك حدّد محلّ النزاع:
الأوّل: إدراكه لمثل مدح المحسن وذمّ المسيء، وإدراكه كذلك بأنّ حكم العقل هنا يستلزم حكم الشرع كذلك.
الثاني: إدراكه وجود مصلحة في الفعل ومفسدة فيه، وفي هذه الحالة لا يرى ملازمة بين ما يدركه وبين حكم الشارع؛ لأنّ العقل عاجز عن الإدراك والإحاطة بالمصالح والمفاسد. وهذه طبيعة مدركات العقل [٤٧].
وفي سياق الاستدلال على هذه الملازمة يذهب السيد الخويي إلى أنّ حكم العقل يتصوّر على ثلاثة أقسام:
الأوّل: أن يدرك العقل وجود مصلحة أو مفسدة فى فعل من الأفعال فيحكم بالوجوب أو الحرمة، لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد عند أكثر الإمامية والمعتزلة.
الثاني: أن يدرك العقل الحسن والقبح كإدراكه حسن الطاعة وقبح المعصية، فيحكم بثبوت الحكم الشرعي في مورده؛ لقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.
الثالث: أن يدرك العقل أمرا واقعيا مع قطع النظر عن ثبوت شرع وشريعة، نظير إدراكه استحالة اجتماع النقيضين أو الضدين، وهو العقل النظري.
بالنسبة إلى الأوّل فلا يمكن إدراك حكم، إذ لا يحيط العقل بجميع جهات المصالح والمفاسد فإنّ «دين اللّه لا يصاب بالعقول» [٤٨].
وبالنسبة إلى الثاني فهو ممّا لا يمكن إنكاره، لكنّه حكم في طول الحكم الشرعي، وفي مرتبة معلوله، فإنّ حكم العقل بحسن الإطاعة وقبح المعصية إنّما هو بعد صدور أمر مولوي من الشارع، فلا يمكن استكشاف حكم شرعي به.
بالنسبة إلى الثالث، فهذا ممّا يمكن استفادة حكم شرعي منه دون شكّ، لكن النقاش هنا في كبراه، وهي حجيّة القطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة، لكن يرفض السيّد الخوئي تشكيك الأخباريين في الكبرى، ويقول في النهاية بعدم تمامية ما ذكروه من أدلّة المنع من العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة [٤٩].
واستدلّ الشيخ المظفر عليها بأنّ الملازمة حاصلة باعتبار كون الشارع عاقلاً، بل رئيس العقلاء، فإذا حكم العقلاء جميعهم بحسن شيء حكم الشارع وفق رأيهم [٥٠].
وقد اختلفت عبارات الأصوليين الشيعة في الاستدلال على هذه الملازمة برغم التزامهم المسلك ذاته [٥١].
أدلّة نفاة الملازمة
يذهب القائلون بعدم الملازمة إلى أنّ العقل يدرك حسن الأفعال والأشياء وقبحها، لكنّ هذا الإدراك لا يترتّب عليه حكم من تحريم أو وجوب، ولا ثواب ولا عقاب، بل هذه الاُمور بحاجة إلى دليل شرعي [٥٢].
نسبه البعض إلى جمهور العلماء من السلف والخلف و الصحابة و التابعين [٥٣].
استدلّ على هذا الرأي بأدلّة نقلية وعقلية:
1 - الأدلّة النقلية
وهي عبارة عن آيات وروايات يبدو منها إثبات كون القبح والحسن مدركين قبل ورود الشرع:
منها: قوله تعالى: «لماذا تعبدونَ ما تنحتونَ واللّه خلقكم وما تعلمون» [٥٤]. فلو لم يكن الشرك قبيحا ولم يكن التوحيد حسنا ولم يكونا مدركين بالعقل لما خاطبهم اللّه بهذا الخطاب، ولما عاتبهم، وكان شركهم كأكلهم وشربهم وباقي نشاطاتهم العادية ليس قبيحا إلاّ أن ينهى عنه.
ومن قبيل هذه الآية آيات اُخرى، مثل: الآية 4 من سورة القصص، والآية 10 و 11 من سورة الشعراء، والآية 50 من سوره هود [٥٥].
ومنها: قوله تعالى: «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلّ لهم الطيّبات ويحرم عليهم الخبائث» [٥٦]. وهذه الآية تدلّ على أنّ هناك موارد من المعروف والمنكر حاصلة قبل إرسال الرسول ثابتة في ذاتها صفة الطيب أو الخبث، وأنّ ما عمله الرسول هو أمره بها أو نهيه عنها، ولو كانت هذه الصفات حاصلة بعد الأمر بها أو النهي عنها لقال: يأمرهم بما يأمرهم وينهاهم عمّا ينهاهم.
وآيات اُخرى مثل: الآية 90 من سورة النحل، والآية 21 من سورة الجاثية وغيرها [٥٧].
ومنها: قول حذيفة: يا رسول اللّه، إنّا كنّا في جاهلية وشرّ، فجاء اللّه بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شرّ؟ قال : «نعم، دعاة على أبواب جهنّم، من أجابهم إليها قذفوه فيها» [٥٨].
ووجه الدلالة أنّ الصحابي دعا ما قبل الإسلام شرّا، وهو من الصفات القبيحة للأفعال، وأقرّ الرسول قوله، ما يعني الإقرار بالصفات القبيحة لبعض الأفعال قبل أن يرد أمر بهامن الشارع.
2 - الأدلّة العقلية
وهي عبارة عن وجوه عقلية:
منها: قول الفقهاء بوجود علل وحكم ومناسبات للأحكام تدعو الشارع للحكم وفقها، ولا يتسنّى هذا إلاّ بعد معرفتهم بالمصالح والمفاسد الناشئة عن الأفعال، ما يعني أنّ من الأفعال ما هو حسن لذاته ومنه ما هو قبيح لذاته.
ومنها: ممّا جبلت عليه فطرة الإنسان هو التفرقة بين الأفعال واعتبار بعضها حسنة وبعضها الآخر قبيحه، وإنكار هذا الأمر إنكار للفطرة الإنسانية، غاية الأمر أنّ الشرع متوافق مع الفطرة فيأمر بما هو حسن وينهى عمّا هو قبيح.
واستدلّوا على عدم المؤاخذة الشرعية على ما يدركه العقل فقط، بل ينبغي وجود أمر أو نهي شرعي بأدلّة من الكتاب والسنّة.
منها: الآية الكريمة: «وما كُنّا معذّبين حتّى نبعث رسولاً» [٥٩] وذلك أنّ اللّه بإحسانه ورحمته لا يعذّب أحدا إلاّ بعد إرسال الرسل.
ومنها: قوله تعالى: «رُسلاً مبشّرين ومنذرين لئلاّ يكون للناس على اللّه حجّة بعد الرسل» [٦٠].
فمنطوق الآية أنّ اللّه بعث الرسل لكي يكونوا حجّة على الناس، ومفهومها: إنّ اللّه لا يعذّب أحدا حتّى تقوم الحجّة بالرسالة، فالإدراك ليس كافيا، بل لا بدّ من قيام الحجّة ببعثة الرسل.
وغيرها من الآيات من قبيل: الآية 131 من سورة الأنعام، والآية 134 من سورة طه [٦١].
واستدلّ نفاة الملازمة كذلك باُمور اُخرى من قبيل:
1 - الحسن والقبح ذاتيان، بينما الوجوب والحرمة شرعيان، ولا ملازمة بين الذاتي والشرعي [٦٢].
2 - برغم أنّ الحسن والقبح عقليان إلاّ أنّه لا يمكن الالتزام بالملازمة المزبورة باعتبار الآية الكريمة: «ومَا كُنّا معذّبين حتّى نبعثَ رسولاً» الظاهرة في أنّ العقاب لا يكون إلاّ بعد بعثة الرسول. وكذا غيرها من الأخبار ممّا تدلّ على أنّه لا حساب دون توسّط تبليغ الحجّة.
3 - حكم العقل بأنّه من البعيد إيكال اللّه بعض أحكامه إلى مجرّد إدراك العقول مع شدّة اختلافها في الإدراكات ما لم ينضبط بنصّ أو شارع وإلاّ أدّى إلى الاختلاف والتنازع [٦٣].
4 - إنّ الملازمة تحصل لكن الحاصل منها لا يسمّى حكما شرعيا، ولا يترتّب عليه العقاب والثواب؛ وذلك لأنّ الأحكام المستفادة من هذه الملازمة لم تبلّغ من الشرع، ولم يبلغنا التكليف بها؛ لأنّ وجود خطاب شرعي معتبر في تحقّق الحكم وليس مجرّد التصديق من الشارع.
وقد أورد الشيخ الأنصاري بعض الإشكالات على هذا الاستدلال [٦٤]، كما وردت استدلالات اُخرى كذلك، وعموم هذه الاستدلالات لا تخلو من نقاشات وردود [٦٥].
بحوث ذات صلة
وفي ذيل هذه القاعدة توجد عدّة بحوث من قبيل البحوث التالية:
1 ـ عكس القاعدة
هناك بحث نظري لا تبدو منه ثمرة عملية ذات صلة بقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، والبحث هو أنَّ ما حكم به الشرع هل يحكم به العقل كذلك؟ ذكرت هنا عدّة احتمالات ووجوه، وفي بعضها يوجد تطابق وصدق للقاعدة؛ باعتبار أنّ اللّه حكيم وعادل ولا يصدر منه أمر عبثي. وفي بعض تلك الوجوه يرد احتمال عدم إمكانية حكم العقل؛ باعتبار غياب الكثير من الاُمور والوجوه عن العقل، ولا يمكن للأخير إدراك كلّ مناطات الأحكام وملاكاتها [٦٦].
2 ـ إطاعة الحكم الشرعي المستكشف بالعقل
بعد فرض صحّة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع تناول بعض لزوم الحكم المستكشف بالعقل وما إذا كانت إطاعته واجبة أم لا؟
ذهب الأصوليون إلى وجوب إطاعته بينما ذهب الأخباريون إلى عدم وجوب إطاعته.
استدلّ الأصوليون على رأيهم باُمور:
منها: إنّ الشريعة الإسلامية خاتمة وشاملة وقد أغنت الإنسان عن كلّ تشريع، لكن ليس بالضرورة أن يكون التشريع له وجود عصر الرسول، بل يصدق على التشريع الذي يوجد بعده كذلك.
ومنها: إذا حصل القطع بالملازمة فلا وجه للتوقّف، فالقطع الطريقي حجّة.
واستدلّ الأخباريون على رأيهم بروايات من قبيل: عن أبي عبد اللّه: «إنّ من قولنا: إنّ اللّه يحتّج على العباد بما آتاهم وعرّفهم، ثُمّ أرسل إليهم رسولاً، وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهى، أمر فيه بالصلاة والصيام» [٦٧]. ووجه الدلالة في مفردة «أرسل» أي لعدم الاعتداد بما آتاهم وعرّفهم لولا الإرسال؛ لتمام الحجّة بدونه، فيدلّ على أنّ اللّه لا يحتجّ بالعقل وحده وهو المطلوب [٦٨].
وهناك بعض البحوث الاُخرى ملحقة بالملازمة المزبورة، من قبيل: إذا صدر أمر موافق لما حكم به العقل، مثل «أطيعوا اللّه والرسول» [٦٩] فهل هو أمر مولوي، أي أنّه أمر صادر من المولى بما هو مولى أو إرشادي، أي أنّه إرشاد من المولى لحكم العقل، وأنّه حكم من المولى كعاقل لا كمولى، وفي النتيجة هل يكون الأمر تأسيسيا أو تأكيديا؟ [٧٠]
المصادر
- ↑ . الردّ على المنطقيين 1: 421.
- ↑ . المسائل المشتركة بين اُصول الفقه واُصول الدين: 76.
- ↑ . رسالة في التحسين والتقبيح السبحاني: 6.
- ↑ . البحر المحيط 1: 134.
- ↑ . المستصفى 1: 69 - 70، البحر المحيط 1: 143، اُصول الفقه المظفر 1ـ2: 273 - 275.
- ↑ . رسالة في التحسين والتقبيح: 27 - 31.
- ↑ . الإحكام الآمدي 1ـ2: 78 و109 و126، البحر المحيط 1: 126 و 189، المستصفى 1: 70.
- ↑ . المعتمد 1: 336 و 337، المحصول الرازي 1: 22، الفائق 1: 169.
- ↑ . المعتمد 1: 336 و2: 413، المحصول الرازي 1: 22، نفائس الاُصول 1: 288 و 290.
- ↑ . الإبهاج شرح المنهاج 1: 61، التحبير شرح التحرير 2: 759، البحر المحيط 1: 135، نفائس الاُصول 1: 282.
- ↑ . التلخيص في اُصول الفقه 1: 154، البحر المحيط 1: 135.
- ↑ . ميزان الاُصول 1: 150.
- ↑ . الإحكام الآمدي 1ـ2: 72، البحر المحيط 1: 136 ـ 137، التحبير شرح التحرير 2: 761.
- ↑ . فواتح الرحموت 1: 29. مراجعه
- ↑ . علاقة علم اُصول الفقه بعلم الكلام: 236 - 237.
- ↑ . رسالة في التحسين والتقبيح السبحاني: 11 - 13.
- ↑ . البرهان 1: 8، التلخيص الجويني 1: 157، التحسين والتقبيح العقليان 1: 309 - 334.
- ↑ . الإسراء: 15.
- ↑ . البرهان 1: 9 - 11، الواضح في اُصول الفقه 1: 12 و 112، كشف الأسرار البخاري 4: 381 - 382، علاقة علم اُصول الفقه بعلم الكلام: 224، التحسين والتقبيح العقليان 1: 415 - 420.
- ↑ . اُصول الفقه المظفر 1ـ2: 286 ـ 288، رسالة في التحسين والتقبيح (السبحاني): 63 ـ 85، التحسين والتقبيح العقليان 1: 416 ـ 441.
- ↑ . التحسين والتقبيح العقليان 1: 339 - 341، آراء المعتزلة الاُصولية: 168 ـ 172، العقل العملي في اُصول الفقه: 92 ـ 93.
- ↑ . العقل العملي في اُصول الفقه: 94.
- ↑ . المصدر السابق: 91 ـ 92.
- ↑ . آراء المعتزلة الاُصولية: 169.
- ↑ . شرح تنقيح الفصول: 90، البحر المحيط 1: 144 - 145، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 280 - 281، آراء المعتزلة الاُصولية: 181 ـ 197.
- ↑ . البحر المحيط 1: 134 - 135، مسلم الثبوت 1: 25، إرشاد الفحول 1: 54.
- ↑ . رسالة في التحسين والتقبيح السبحاني: 48 - 50.
- ↑ . شرح الاُصول الخمسة: 209.
- ↑ . إرشاد الفحول 1: 60.
- ↑ . المنخول: 12.
- ↑ . شرح الاُصول الخمسة: 209.
- ↑ . اُصول الفقه المظفر 1ـ2: 288 - 290، رسالة في التحسين والتقبيح (السبحاني): 51 - 57.
- ↑ . يوسف: 109.
- ↑ . الروم: 8.
- ↑ . قواطع الأدلّة ابن السمعاني 2: 817، كشف الأسرار 4: 382، اُنظر: آراء المعتزلة الاُصولية: 168 ـ 172.
- ↑ . علاقة علم اُصول الفقه بعلم الكلام: 229 - 235.
- ↑ . المسودة: 421 - 434، تشنيف المسامع 1: 47.
- ↑ . التحسين والتقبيح العقليان 1: 470 - 500.
- ↑ . التحسين والتقبيح العقليان 1: 500 - 505.
- ↑ . الرسائل الأربع: 90 ـ 91.
- ↑ . اُنظر: رسالة في التحسين والتقبيح السبحاني: 86. التحسين والتقبيح العقليان، وقد اختصّ الجزء الثالث بهذا الشأن، وكذلك التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل اُصول الفقه، وقد اختصّ الجزء الثاني منه بهذا الشأن.
- ↑ . رسالة في التحسين والتقبيح السبحاني: 4 - 5.
- ↑ . الرسائل الأربع السبحاني: 7 ـ 8.
- ↑ . فوائد الاُصول 3: 58 ـ 60، اُصول الفقه المظفر 1ـ2: 291، رسالة في التحسين والتقبيح (السبحاني): 120.
- ↑ . الفصول الغروية: 337.
- ↑ . اُصول الفقه المظفر 1ـ2: 297.
- ↑ . رسالة في التحسين والتقبيح السبحاني: 122 - 124.
- ↑ . مستدرك الوسائل 17: 262، أوائل المقالات: 228.
- ↑ . مصباح الاُصول 2: 55 - 56.
- ↑ . اُصول الفقه المظفر 1ـ2: 293.
- ↑ . القوانين المحكمة: 249، فوائد الاُصول 3: 60 - 62. الفصول الغروية: 342 - 343.
- ↑ . تشنيف المسامع 1: 46.
- ↑ . التحسين والتقبيح العقليان 1: 402 - 414.
- ↑ . الصافات: 58 - 59.
- ↑ . مجموع فتاوى ابن تيمية 11: 681 - 682، التحسين والتقبيح العقليان 1: 456 - 458.
- ↑ . الأعراف: 157.
- ↑ . التحسين والتقبيح العقليان 1: 458 - 461.
- ↑ . صحيح البخاري 5 ـ 6: 46 ـ 47 كتاب المناقب باب 26 ح 133.
- ↑ . الإسراء: 15.
- ↑ . النساء: 65.
- ↑ . التحسين والتقبيح العقليان 1: 464 - 469.
- ↑ . تشنيف المسامع بجمع الجوامع 1: 133 - 139، الوافية: 175 - 177.
- ↑ . الوافية: 172 - 174.
- ↑ . اُنظر: الملازمة بين حكم العقل والشرع عند الشيخ الأنصاري: 131 ـ 132.
- ↑ . اُنظر: الفصول الغروية: 316 - 363، فوائد الاُصول 3: 57 - 64، منتهى الاُصول 2: 171 - 174.
- ↑ . الرسائل الأربع: 77 ـ 78.
- ↑ . الكافي 1: 164. كتاب التوحيد باب حجج اللّه على خلقه، ح 4.
- ↑ . الرسائل الأربع: 79 ـ 82، اُنظر: الوافية: 171 ـ 172، مطارح الأنظار 2: 386.
- ↑ . آل عمران: 32.
- ↑ . اُصول الفقه المظفر 1ـ2: 294 - 295.