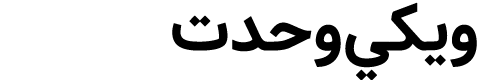الأشاعرة

| الاسم | الأشاعرة | ||
|---|---|---|---|
| اللقب والأسماء الأخرى | الجبرية والقدرية | ||
| المؤسّس | ابو الحسن الأشعري، | ||
| المعتقدات | الأصول الخمسة | أشهر الشخصيات | القاضي أبو بكر الباقلاني، أبو إسحاق الإسفراييني، عبد الملك الجويني، أبو حامد الغزالي، مير سيد شريف الجرجاني، سعد الدين التفتازاني، ملا علي القوشجي، عبد الوهاب الشعراني،محمد عبده، عبد العظيم الزرقاني |
الأشاعرة اسم لامع بين المدارس الكلامية لأهل السنة والجماعة، ويتبع نتاجاتها الفكرية أكثر أهل السنة في عصرنا الحاضر، مؤسس هذه المدرسة هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (260-324 هـ)، كان في البداية تلميذًا في مدرسة المعتزلة، وقضى أغلب عمره في مذهب الإعتزال ثم بعد انفصاله عنها، انضم إلى مدرسة أهل الحديث بهدف إيجاد توازن بين العقلانية المتطرفة للمعتزلة ونفور أهل الحديث المفرط من العقل، وأسس مذهباً جديداً سمي بإسمه فيما بعد، وحاول أدخال استدلال العقلي في تفسير آراء أهل الحديثـ، ومن أشهر الشخصيات هذه الفرقة هم: القاضي أبو بكر الباقلاني، أبو إسحاق الإسفراييني، عبد الملك الجويني، أبو حامد الغزالي، مير سيد شريف الجرجاني، سعد الدين التفتازاني، ملا علي القوشجي، عبد الوهاب الشعراني، محمد عبده، عبد العظيم الزرقاني، وتتميزها عن باق الفرق الإسلامية بمباني اعتقادية خاصة، ومن أبرزها: الله هو الخالق الوحيد لجميع الأفعال: تؤمن في تفسير التوحيد الأفعالي، بمعنى أن الله هو الخالق الوحيد للأفعال، والإنسان ليس خالقًا لأفعاله بل هو كاسب لها. إنكار الحسن والقبح العقلي: تعتقد أن الشرع هو المعيار في تحديد الحسن والقبح، وليس العقل. فلا يوجد فعل حسن أو قبيح بذاته إلا إذا حدد الشرع ذلك. الإيمان بالقضاء والقدر: تؤمن بقوة بالقضاء والقدر، ويعتقدون أن إرادة الله تحكم كل الأمور، بما في ذلك أفعال الإنسان، الذي يعتبر مجرد كاسب لأفعاله. رؤية الله في الآخرة: و تستدل بآيات القرآن على أن الله سيرى بالعين في الآخرة. قدم كلام الله: وتعتقد أن كلام الله قديم، وأن صفاته الخبرية يجب تفسيرها دون تشبيه أو تحديد للكيفية. عدم إتحاد الصفات الإلاهية بذات الله، أي إن صفاته غير ذاته. عموميٌة الإرادة الإلاهية والقضاء والقدر الإلاهيين لكل الأمور ومن ضمنها أفعال الإنسان، أي إن الإنسان ليس خالق لعمله،بل إن أعماله مكتسبة. قبول الأوصاف الخبرية لله بدون تشبيه الله بالمخلوقات وبدون تعيين الكيفية.
مذاهب أهل السنة والجماعة الكلامية
توزع أهل السنة والجماعة في صفوف مختلفة في أصولهم الكلامية، ولديهم مذاهب متنوعة، من بينها مذاهب المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، والأباضية والأشاعرة الأكثر بروزًا من غيرها.
تأسيسها
يتطلب تتبع جذور هذا الموضوع دراسات دقيقة وموسعة مع مناقشات طويلة وميدانية يجب تحليلها في مكانها، ومع ذلك، يمكن القول بإيجاز إن هذه المدرسة تأسست في وقت كان المعتزلة قد طُردوا من قبل بعض الخلفاء العباسيين وفقدوا أيضًا مواقعهم لدى الناس، وذلك لأن مؤسسي الاعتزال بسبب إفراطهم في العقلانية المستمدة من الفلسفة اليونانية ابتعدوا عن نصوص القرآن والروايات، مما جعل الناس يشككون في هذه المدرسة وأتباعها وينفضون عنها [١].
أبو الحسن الأشعري
ينحدر أبو الحسن الأشعري المولود في البصرة سنة 260 هـ والمتوفي في بغداد سنة 324 هـ في بغداد؛ من نسل أبي موسى الأشعري، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الأشعري حتى سن الأربعين تابعًا لمدرسة المعتزلة، ولكن في عام 320 هـ، بعد أن تبرأ من أفكار الاعتزال، وأسس مدرسته الجديدة[٢].
هدف الأشعري من إنشاء مدرسة الأشاعرة
الهدف الرئيسي لأبي الحسن الأشعري من إنشاء مدرسة الأشاعرة كان محاربة تيارين متطرفين: العقلانية المفرطة للمعتزلة والنصية المفرطة لأهل الحديث، وذلك لتأسيس مدرسة وسطية تعدل بين هذين الاتجاهين المتطرفين. كان المعتزلة يؤكدون على الأسس العقلية كأداة وحيدة للمعرفة وينفون كل ما يرونه غير متوافق مع الفهم العقلي، كما أنكروا الصفات الزائدة عن الذات وتحدثوا عن خلق كلام الله. وفي المقابل، وقف أهل الحديث الذين اعتمدوا على النصوص والمنقولات واتخذوا منهجًا معاديًا للعقل في تفسير الآيات وتجنبوا التأويل العقلي للقرآن، في هذا السياق، سعى الأشعري وأتباعه إلى مواجهة هذه الإفراطات والتفريطات واختاروا طريقًا وسطًا وأسسوا مدرسة عُرفت باسم الأشاعرة [٣].
تحوله من الاعتزال
فيذكر إبن عساكر وغيره أن أبا الحسن الأشعري اعتزل الناس مدة خمسة عشر يوما، وتفرغ في بيته للبحث والمطالعة، ثم خرج إلى الناس في المسجد الجامع، وأخبرهم أنه إنخلع مما كان يعتقده، كما ينخلع من ثوبه، ثم خلع ثوبا كان عليه ورمى بكتبه الجديدة للناس. ومع اتفاق الباحثين على رجوعه عن مذهب الاعتزال، إلا أنهم اختلفوا في تحديد سبب ذلك الرجوع:
- فقيل إن سبب رجوعه ما رآه في مذهب المعتزلة من عجز ظاهر في بعض جوانبه، فقد كان دائم السؤال لأساتذته عما أشكل عليه من مذهبهم.
- ومما يذكر أيضا في سبب رجوعه عن مذهب الاعتزال مع ما سبق، رؤيا رأى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
واختلف الباحثون كذلك حول المذهب الذي تحول إليه أبو الحسن الأشعري، فقيل تحول إلى مذهب الكلابية وعنه إلى مذهب أهل الحديث وهذا قول جمع من العلماء، وقيل تحول إلى مذهب الكلابية وبقي عليه، وكانت له آراء مستقلة توسط فيها بين المعتزلة والمثبتة نشأ عنها المذهب الأشعري وهو قول الأشعرية . ويعتمد أصحاب القول الأول - القائلين بتحوله إلى الكلابية ومنها إلى مذهب أهل الحديث - على ما كتبه الأشعري في الإبانة، ويقولون إنها من آخر كتبه، وفيها نصَّ على أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. إلا أن المقارنة الدقيقة بين ما كتبه في الإبانة ومذهب الكلابية لا تظهر كبير فرق بين المذهبين، فما قال به الكلابية قال به الأشعري، كإثبات الصفات الخبرية كالوجه واليدين وغيرهما، وما نفاه الكلابية نفاه الأشعري كنفيه قيام الأفعال الاختيارية بالله سبحانه، حيث ذهب إلى أن صفة الإرادة صفة أزلية قديمة، لا تتجدد لفعله ولا لإنشائه [٤].
كبار علماء الأشاعرة
في المدرسة الأشعرية، بعد أبي الحسن الأشعري، برز عدد من العلماء الكبار الذين يُعتبرون من أبرز الشخصيات في هذا المذهب، وفيما يلي أسماء بعض هؤلاء الأعلام حسب الترتيب الزمني:
- القاضي أبو بكر الباقلاني
- أبو إسحاق الإسفراييني
- عبد الملك الجويني
- أبو حامد الغزالي
- مير سيد شريف الجرجاني
- سعد الدين التفتازاني
- ملا علي القوشجي
- عبد الوهاب الشعراني
- محمد عبده
- عبد العظيم الزرقاني
- الشيخ محمود شلتوت [٥].
أهم المؤلفات الكلامية للأشاعرة
ترك الأشاعرة العديد من المؤلفات الكلامية المهمة، ومن أبرزها:
- اللمع لأبي الحسن الأشعري
- مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري
- الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري
- استحسان الخوض في علم الكلام لأبي الحسن الأشعري
- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لأبي بكر الباقلاني
- الشامل في أصول الدين لعبد الملك الجويني
- إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي
- الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي
- الأربعين في أصول الدين لأبي حامد الغزالي
- مجموعة رسائل الإمام الغزالي لأبي حامد الغزالي
- الملل والنحل لعبد الكريم الشهرستاني
- القضاء والقدر لفخر الدين الرازي
- المطالب العالية من العلم الإلهي لفخر الدين الرازي
- المحصل لفخر الدين الرازي
- معالم أصول الدين لفخر الدين الرازي
- المباحث المشرقية لفخر الدين الرازي
- تفسير مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (وهو تفسير)
- شرح المواقف لمير سيد شريف الجرجاني
- شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني
- شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني
- اليواقيت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني
- مناهل العرفان لعبد العظيم الزرقاني
- رسالة التوحيد لمحمد عبده [٦].
المباني الاعتقادية للأشاعرة
يتميز المذهب الأشعري بمباني اعتقادية خاصة، ومن أبرزها:
- الله هو الخالق الوحيد لجميع الأفعال: يؤمن الأشاعرة بالتوحيد الأفعالي، أي أن الله هو الخالق الوحيد للأفعال، والإنسان ليس خالقًا لأفعاله بل هو كاسب لها.
- إنكار الحسن والقبح العقلي: يعتقد الأشاعرة أن الشرع هو المعيار في تحديد الحسن والقبح، وليس العقل. فلا يوجد فعل حسن أو قبيح بذاته إلا إذا حدد الشرع ذلك.
- الإيمان بالقضاء والقدر: يؤمن الأشاعرة بقوة بالقضاء والقدر، ويعتقدون أن إرادة الله تحكم كل الأمور، بما في ذلك أفعال الإنسان، الذي يعتبر مجرد كاسب لأفعاله.
- رؤية الله في الآخرة: يستدل الأشاعرة بآيات القرآن على أن الله سيرى بالعين في الآخرة.
- قدم كلام الله: يعتقد الأشاعرة أن كلام الله قديم، وأن صفاته الخبرية يجب تفسيرها دون تشبيه أو تحديد للكيفية.
- عدم إتحاد الصفات الإلاهية بذات الله، أي إن صفاته غير ذاته.
- عموميٌة الإرادة الإلاهية والقضاء والقدر الإلاهيين لكل الأمور ومن ضمنها أفعال الإنسان، أي إن الإنسان ليس خالق لعمله،بل إن أعماله مكتسبة.
- قبول الأوصاف الخبرية لله بدون تشبيه الله بالمخلوقات وبدون تعيين الكيفية [٧].
تفسيرات قصيرة حول نظرية الكسب من منظور متكلمي الأشاعرة
الأشاعرة، بسبب إيمانهم القوي بالتوحيد الأفعال، أي أنهم لا يعترفون بخلق سوى الله ويعتبرونه مصدر جميع الأفعال، لا يمنحون الإنسان أي دور في الخلق، بل يعتبرون الفاعلية بمعنى الخلق بمثابة مشاركة في أفعال الله. لذلك، من وجهة نظرهم، الله هو الفاعل لجميع أفعال العباد، سواء كانت هذه الأفعال خيرًا أم شرًا. ولأن الأشاعرة رأوا أن هذا الاعتقاد يؤدي إلى القبول بالجبر والوقوع في مشكلة إنكار الثواب والعقاب، طرحوا نظرية الكسب، حيث يعتبرون الإنسان كاسبًا لأفعاله الاختيارية، وذلك لتبرير مسألة الجزاء على الأعمال. طرح مسألة الكسب يميزها عن مسألة خلق الفعل، وهذا ليس فقط رأي أبي الحسن الأشعري، بل جميع متكلمي أهل السنة (باستثناء المعتزلة) مثل الماتريدية وأهل الحديث، الذين يعتقدون أن الخلق مقصور على الفاعل الإلهي. من وجهة نظرهم، لا يوجد فاعل أو خالق سوى الله "لا مؤثر في الوجود إلا الله"، ولكن الأفعال تُكتسب عندما يكون الإنسان مختارًا، حيث يكتسب الفعل بقوة حادثة منحها الله له، وبالتالي يكون مسؤولًا عنه [٨].
أبو الحسن الأشعري (اختيار محدود للفاعل الكاسب)
يُفسر أبو الحسن الأشعري نظرية الكسب بطريقة لا تمنح الفاعل الكاسب سوى أدنى حد من الاختيار، فهو يرى أن حقيقة الكسب هي وقوع الفعل من الإنسان بقوة حادثة من الله، تُمنح له في لحظة وقوع الفعل. ويؤكد أن قدرة العبد لا تؤثر في وجود الفعل ولا في صفاته [٩].
أبو بكر الباقلاني (التمييز بين خلق الفعل وصفاته)
الباقلاني يميز بين خلق الفعل وصفاته، حيث يعتبر الخلق من الله والكسب من الإنسان. ومع ذلك، يرى أن قدرة الإنسان واختياره تؤثر في صفات الأفعال، على عكس الأشعري الذي نفى ذلك ، فالقدرة الإلهية هي التي تخلق الفعل، ولكن كون الفعل طاعة أو معصية يتحدد بقدرة العبد [١٠].
عبد الملك الجويني (الاعتراف بالفاعلية الطولية والتشابه مع الأمر بين الأمرين)
ينتقد الجويني في تعريفه لنظرية الكسب تفسير الأشعري وحتى الباقلاني، ويعتقد أن العبد يمتلك القدرة والاختيار، بالإضافة إلى أن قدرته هي في طول قدرة الله. هذا النوع من التفسير الذي يشير إلى القدرة والاختيار وكذلك وجود فاعلين طوليين، يكاد يكون غير مسبوق بين المتكلمين قبل الجويني، بالإضافة إلى أنه يشبه تفسير الإمامية للأمر بين الأمرين. يكتب: "أما نفي هذه القدرة والاستطاعة فمما يأباه العقل والحس، وأما إثبات قدرة لا أثر لها بوجه؛ فهو كنفي القدرة أصلا... فلا بد إذاً من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة لا على وجه الإحداث والخلق، فإن الخلق يشعر باستقلال إيجاده من العدم، والإنسان كما يحس من نفسه الاقتدار، يحس من نفسه أيضا عدم الاستقلال، فالفعل يستند وجوده إلى القدرة، والقدرة تستند وجودها إلى سبب آخر تكون نسبة القدرة إلى ذلك السبب كنسبة الفعل إلى القدرة. وكذلك يستند سبب إلى سبب آخر حتى ينتهي إلى مسبب الأسباب، فهو الخالق للأسباب ومسبباتها". أي أن العقل لا يمكن أن يقبل أن الإنسان لا يملك القدرة والاستطاعة في فعل ما، بالإضافة إلى أنه يفهم أن القدرة بلا تأثير هي مثل عدم القدرة، في هذه الحالة، يتم إثبات استناد الفعل حقيقة إلى العبد مع الاختلاف أن هذا الاستناد ليس على وجه الإحداث والخلق، لأن الخلق يكون حيث يمكن للخالق أن يوجد شيئًا من العدم بطريقة الابتكار والإبداع، ولكن الإنسان كما يدرك من جهة أنه يلعب دورًا مباشرًا في إنتاج الفعل، فإنه يدرك أيضًا أن خلق الفعل ليس من مسؤوليته، بل هناك فاعل آخر شريك في العمل. وبالتالي، فإن الفعل الذي يستند وجوده إلى القدرة والسبب، فإن هذا السبب والقدرة يستندان أيضًا إلى سبب وقدرة أخرى، وهذا الاستناد بشكل تسلسل الفاعلين ينتهي في النهاية إلى مسبب الأسباب وهو الله [١١].
أبو حامد الغزالي (الكسب لا يمنع مسؤولية العباد عن أفعالهم)
أبو حامد الغزالي أيضًا في تفسيره للكسب يدفع اتهام الجبر عن نفسه ويعتقد أن القول بأن الإنسان لا يملك أي اختيار في فعل ما هو خلاف الوجدان وفهم العقل. ويضيف أن الله منفرد في الخلق، ولكن انفراده في الخلق لا يمنع اكتساب الأفعال وخلق المسؤولية للعباد. "أن انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لا يخرجها عن كونها مقدورة للعباد على سبيل الاكتساب" [١٢].
فخر الرازي (العبد بوجود القدرة والداعي هو الفاعل الحقيقي لأفعاله)
يعتقد فخر الرازي في تفسير الكسب أن فعل العبد يتحقق عندما تكون لديه القدرة والداعي لفعل ذلك، وإذا تحقق كلاهما، فإن العبد يصبح فاعلًا حقيقيًا لفعل نفسه. يكتب: "إنا نعلم بالضرورة أن القادر على الفعل إذا دعاه الداعي إليه ولم يمنعه منه مانع، فإنه يحصل ذلك الفعل". أي أننا نعلم بالضرورة أن الشخص الذي يملك القدرة على فعل ما إذا اقترن ذلك بداعي (حافز) ولم يكن هناك مانع، فإن الفعل سيحدث بالتأكيد [١٣]. ويؤكد ادعاءه بشكل صريح في مكان آخر ويكتب: "المختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية الخاصة يجب الفعل، وعلى هذا التقدير يكون العبد فاعلاً على سبيل الحقيقة، ومع ذلك تكون الأفعال بأسرها واقعة بقضاء الله تعالى وقدره". أي أن المختار لدينا هو أنه عندما تتحقق القدرة والداعي الخاص معًا، يصبح الفعل واجبًا. وبالتالي، يصبح العبد فاعلًا حقيقيًا لفعل نفسه. ومع ذلك، فإن خلق الأفعال بشكل عام يتبع قضاء الله وقدره. مع الاعتراف الصريح لفخر الرازي بالفاعلية الحقيقية للإنسان، يتضح أنه لا يقف عند أي مفترق طرق، لأنه يعترف صراحة أن العبد بعد حصول القدرة مع الداعي الخاص بالفعل، يقوم به بقدرته وإرادته. وبالتالي، فإن ما يفعله يُنسب إليه حقيقة. في تفسير فخر الرازي، تم الإشارة إلى نقطتين. الأولى: أن اختيار الإنسان في تحديد نوع الفعل مؤثر. الثانية: أن الفعل يتبع قضاء الله وقدره، وهو تفسير أخذته الإمامية أيضًا في الأمر بين الأمرين. يعترف فخر الرازي في تفسير الكسب بوجود فاعلين طوليين في إحداث الفعل ويقبل به [١٤].
میر سید شریف جرجانی (تشابه تفسيره مع تفسير مؤسس مذهب الأشاعرة)
يُعرِّف میر سید شریف "الكسب" من منظور لغوي بطريقة توافق مبادئ الاختيار، ولكنه في تفسير نظرية الكسب يقترب من رأي أبي الحسن الأشعري، حيث يمنح الإنسان حصة صغيرة جدًا في الأفعال الصادرة عنه لتجنب الوقوع في اتهام الجبرية. فهو يكتب: «إن أفعال العباد الاختيارية تقع بقدرة الله سبحانه وتعالى (وحدها)، وليس لقدرتهم تأثير فيها، بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجِد في العبد قدرة واختيارًا، فإذا لم يكن هناك مانع، أوجد فيه فعله المقدور مقارنًا لهما، فيكون فعل العبد مخلوقًا لله إبداعًا وإحداثًا، ومكسوبًا للعبد. والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلًا له. وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري». أي أن الأفعال الاختيارية للعباد تقع بقدرة الله، وقدرة العبد لا تؤثر في إيجاد الفعل، بل إن الله تعالى جرى عادته بأن يخلق في عباده قدرة واختيارًا، حتى إذا لم يكن هناك مانع، يتحقق الفعل مقارنًا لتلك القدرة والاختيار. وبالتالي، فإن الفعل مخلوق لله تعالى إبداعًا وإحداثًا، وفي نفس الوقت، بما أن العبد يكتسبه، فهو مكسوب للعبد أيضًا، على الرغم من أن مقارنة القدرة والاختيار عند العبد لا تؤثر في إبداع أو إيجاد (خلق) الفعل، والعبد يُعتبر فقط محلًا للكسب بالنسبة للفعل المكسوب.
هذا الشخص يتجاوز ذلك لينكر حتى العلاقة السببية بين الأفعال، ويربط جميع أفعال الإنسان مباشرة بالله دون أي وسيط، مؤكدًا أن الإنسان لا يملك أي قدرة أو اختيار في إيجاد الفعل. فهو يكتب: «نحن نقول بأن جميع الممكنات المتكثرة التي لا تُحصى، مستندة بلا واسطة إلى الله تعالى، منزهة عن التركيب»[١٥]. أي أن الأشاعرة يعتقدون أن جميع الممكنات الكثيرة التي لا تُحصى، ترجع مباشرة إلى الله تعالى دون وسيط.
ملا علي القوشجي(إعطاء حصة صغيرة للعباد في إيجاد الفعل)
في تفسيره للكسب وخلق الأفعال، يتبع ملا علي القوشجي منهجًا ثابتًا يشبه إلى حد كبير منهج أسلافه، خصوصًا میر سید شریف جرجاني، حيث يمنح العبد حصة ضئيلة تسمى "الكسب" دون قدرة مؤثرة. فقد كتب: «والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من دون أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلًا له. ومعنى ذلك أن الفعل صادر من الله، غاية الأمر أن الإصدار منه يتقارن مع وصف من صفات العبد، وهو أنه إذا صار ذا قدرة غير مؤثرة وإرادة، كذلك يصدر الفعل من الله سبحانه مباشرة، فلا يكون للعبد دور سوى كونه محلًا له». أي أن المقصود بالكسب هو اقتران الفعل بقدرة العبد وإرادته دون أن يكون لتلك القدرة والإرادة تأثير أو دور في وجود الفعل، إلا أن يكون العبد محلًا للفعل. وبتحليل كلام القوشجي، يمكن القول إنه يعتبر الإنسان محلًا أو بشكل أدق، وعاءً لفعل الله، دون أن يكون لهذا المحل أي تأثير في خلق الفعل. فالكسب في نظره هو اقتران الإنسان بقدرة وإرادة يمنحهما الله له، مع توضيح أن هذه القدرة والإرادة الإلهية لا تؤدي إلا إلى جعل الإنسان محلًا لقبول فعل الله، دون أي تأثير آخر[١٦].
الكسب من منظور متكلمي الأشاعرة في القرون المتأخرة
من المناسب أن نلقي نظرة على آراء بعض متكلمي هذا المذهب الذين عاشوا في القرون اللاحقة، وبعضهم ينتمي إلى العصر الحديث. قبل ذلك، يجب أن نذكر أن متكلمي الأشاعرة في القرون المتأخرة قدموا تفسيرًا أكثر عقلانية للكسب، مما أدى إلى مزيد من الاهتمام بإرادة واختيار الفاعل في أداء أفعاله. وبناءً على ذلك، يدافع هؤلاء المتكلمون صراحة عن إرادة واختيار الإنسان في تفسير نظرية الكسب، ويبتعدون بهذا الرأي عن الأشاعرة السابقين، باستثناء الجويني، ويقتربون من رأي الإمامية في "الأمر بين الأمرين". هذا التقارب في الرأي يكون أحيانًا كبيرًا لدرجة أنه يصعب التمييز بين تفسير الجبر والاختيار الذي يقدمه متكلم إمامي المذهب، وبين ذلك الذي ينبع من آراء متكلمي الأشاعرة، وهو أمر جدير بالملاحظة [١٧].
عبد العظيم الزرقاني (اختيار مسار بين الجبر والاختيار من خلال تفسير آيات القرآن)
هذا المتكلم، للوصول إلى وجه جامع بين الجبر والاختيار، يقوم بدراسة كلتا المجموعتين من آيات القرآن التي تدافع من جهة عن الفاعلية المطلقة لله، أي التوحيد في الخالقية، ومن جهة أخرى تعتبر الإنسان فاعلاً لأفعاله، ويصل في النهاية إلى نتيجة مفادها أن الإيمان بأي من هاتين المجموعتين من الآيات لا يؤدي إلى تفسير كامل، وبالتالي تظل الحقيقة مخفية. لذلك، من المناسب أن نأخذ طريقاً وسطاً بين هاتين المجموعتين من الآيات ونتبع خط الاعتدال. في تفسيره لخلق أفعال العباد، يشير أولاً إلى الآيات التي تنسب الخلق فقط إلى الله، ويكتب: «في القرآن الكريم والسنة النبوية نصوص كثيرة على أن الله تعالى خالق كل شيء، وأن مرجع كل شيء إليه وحده، وأن هداية الخلق وضلالهم بيده سبحانه، مثل قوله عز وجل: الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، والله خلقكم وما تعملون، وإليه يرجع الأمر كله... وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى... وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل...». أي أن في كتاب الله وسنة نبيه نصوصاً كثيرة تدل على أن الله تعالى خالق كل شيء، وأن كل شيء يعود إليه، وأن الهداية والضلال بيده. هل هناك خالق غير الله؟! الله خلقكم وما تصنعون!... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعتقد الزرقاني أن من ينظر إلى هذه النصوص يعترف بأن كل الأمور تعود إلى الله وأنه في حكمته لا شريك له [١٨].. ثم يتناول الجانب الآخر من المسألة، وهو النقاش حول نسبة الفاعلية الصحيحة للإنسان في الأفعال الاختيارية، ويكتب: «إلى جانب هذا توجد نصوص كثيرة أيضاً من الكتاب والسنة تنسب أعمال العباد إليهم... «من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها» سورة الجاثية، آية 15 «إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها» سورة الإسراء آية 7 «قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب» سورة التوبة آية 105 و«تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون» سورة الزخرف، آية 72». يعتقد أن من ينظر إلى هذه النصوص القرآنية يدرك أن أفعال العباد منسوبة إليهم. ولهذا إذا قام الأشخاص بأعمال صالحة، فإنهم يستحقون الثواب، وإذا قاموا بأعمال سيئة، فإنهم يستحقون العقاب. ومع ذلك، مثل غيره من متكلمي الأشاعرة، يعتبر الزرقاني أن الخلق منحصر بالله والكسب منحصر بالإنسان.
محمد عبده (الاعتراف بوجود قوتين إلهية وبشرية لإحداث الفعل)
يعتقد محمد عبده أن في إحداث الأفعال الاختيارية للإنسان قوتان تعملان في وقت واحد، واحدة هي قوة الله والأخرى هي قوة الإنسان. يكتب: «يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنه موجود ولا يحتاج في ذلك إلى دليل يهديه ولا معلم يرشده، كذلك يشهد أنه مدرك لأعماله الاختيارية يزن نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته ثم يصدرها بقدرة ما فيه، ويعد إنكار شيء من ذلك مساوياً لإنكار وجوده في مجافاته لبداهة العقل». أي أن العقل السليم مع الحواس (الخمس) يشهد أن الإنسان يدرك وجوده وهذا الإدراك لا يحتاج إلى أي مرشد أو تعليم من أي معلم، بل هو فطري تماماً، أي أن الإنسان يدرك أعماله الاختيارية ويقيمها بعقله ويقدرها بإرادته ثم يحقق الفعل الذي قيمه بعقله وقدره بإرادته بالقوة الموجودة فيه. وبالطبع، من ينكر هذه الحقيقة وبداهة العقل، فإنه في الحقيقة ينكر وجود نفسه[١٩].
مكانة العقل عند الاشاعرة
واحدة من المسألة الضرورية عند الأشاعرة هي الإستفادة من العقل في تأيد الشرع ، ولا يعد هذا المر ضلالة، ولكن لايمكن الإستفادةمن العقل بدون التقيد بالنص، إذ في حالة مخالفة النص للعقل فالمقدم عندهم النص، ويرون أن العقل لابد أن يكون تابعا للنص. ولكن الأشاعرة لم يتقيدوا بهذه النظرية مطلقا {إن العقل مؤيد للنقل فقط} إذ تراهم في بعض الأحيان يعتمدون على العقل في إستدلالاتهم، وعلى النقل تارة أخرى.[٢٠] إن حركة أبوالحسن الأشعري من جهة أنها بدأت بالدعوة الى الإبتعاد عن العقل والتأويل، ولكن الميراث العقلي في آثار الأشعري له تأثير كبير في المجتمع الإسلامي من جهة أخرى. وبالرجوع الى كبار علماء الأشاعرة الذين جاءوا من بعد الأشعري كالباقلاني والجويني والغزالي والفخر الرازي فإن النزعة العقلية واضحة في كتاباتهم.
وصلات خارجية
الهوامش
- ↑ علی محمد ولوی، تاریخ علم الکلام والمذاهب الاسلامیة، ج 2، ص450
- ↑ حسین صابری، تاریخ الفرق اسلامیة، طهران، ج 1، ص 229
- ↑ ابن خلدون، مقدمه التاريخ، ج ۲، ص۹۴۲-۹۴۷
- ↑ الجاحظ، ابو عمر، التبيين، ص: 38-39
- ↑ حسین صابری، تاریخ فرق لاسلامیة، ج 1، ص 120 229
- ↑ حسین صابری، تاریخ فرق لاسلامیة، ج 1، ص 120 229
- ↑ حسین صابری، تاریخ فرق لاسلامیة، ج 1، ص 120 229
- ↑ ابوالحسن اشعری، اللمع، ص 74
- ↑ فخر الرازی، القضا و القدر، ص 32
- ↑ خواجه نصیرالدین الطوسی، تلخیص المحصّل، ص 325
- ↑ الشهرستانی عبدالکریم، الملل و النحل، ص 111 و 113
- ↑ ابوحامد الغزالی، احیاء علوم الدین، ص 249
- ↑ فخرالدین الرازی، القضا و القدر، ص 31
- ↑ فخرالدین رازی، المباحث المشرقیة، ص 517
- ↑ میر سید شریف الجرجانی، شرح المواقف، ص 123
- ↑ جعفر السبحانی، بحوث فی الملل و النحل، ج 9، ص 50
- ↑ عبدالوهاب شعرانی، الیواقیت و الجواهر، ج 1، ص 251
- ↑ عبدالعظیم الزرقانی، مناهل العرفان، ج 1، ص 506
- ↑ محمد عبده، رسالة التوحید، ج 1، ص 31
- ↑ أبوالحسن الأشعري، رسالة إستحسان الخوض في علم الكلام