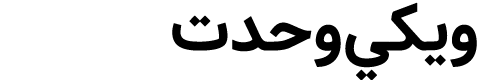عوامل التفرّق الثانوية
عوامل التفرّق الثانوية الأسباب التي تؤدّي ثانياً وبالعرض إلى حدوث ظاهرة التشتّت والتباعد بين أبناء الأُمّة الواحدة، فهي لوحدها لا تشكّل عامل تفرقة إلّاإذا انضمّت إلى العوامل الأصلية. وهذه العوامل أكثر ظهوراً وبروزاً، وهي ترتبط غالباً بطبيعة البشر، ولا يمكن إزالتها، بخلاف العوامل الأصلية.
ويمكن تلخيصها فيما يلي :
عوامل التفرّق الثانوية
اختلاف المذاهب
حين يدور الحديث عن وحدة المسلمين تطرح قضية الاختلاف المذهبي بين المسلمين نفسها باعتبارها أهمّ موانع الوحدة. والمسلمون في الواقع اختلفوا منذ القرن الأوّل الهجري في الأُصول والفروع، وعلى مرّ التاريخ ظهرت مدارس فقهية وعقائدية وسلوكية عديدة.
والمسلمون اليوم ينقسمون إلى سنّة و شيعة، السنّة على أربعة مذاهب مشهورة في الفروع وعلى مذهبين مشهورين في الأُصول، هما : المذهب الأشاعرة، ومذهب المعتزلة. ويوجد أيضاً «الأباضية»، ولهم مذهبهم الخاصّ في الفقه والكلام.
أمّا الشيعة فأشهرهم الإمامية الاثنا عشرية، ويوجد أيضاً الزيدية، والإسماعيلية، منهم من هو على هدى القرآن والسنّة، ومنهم من تسرّبت إليه عقائد باطلة.
ثمّ هناك بين أهل السنّة والشيعة فرق صوفية، لكلّ منها طريقتها الخاصّة في تهذيب النفس والسلوك،
وتلتزم هذه الفرق غالباً بما تلتزم به المذاهب الإسلامية في الفقه والعقيدة وإن تسرّب إلى بعضها شيء من الانحراف.
الهاجس الذي يقلق دعاة الوحدة من التعدّدية المذهبية هو التاريخ الطويل للنزاعات المذهبية الدامية بين أتباع الفرق الإسلامية
وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، لكن الذي يجب أن نتعمّق فيه هو سبب هذه النزاعات الدامية، هل هو مجرّد الاختلاف الفكري أو الفقهي؟ إنّنا نجد في مقاطع تاريخية كثيرة بل وفي عصرنا الراهن أجمل ألوان التعايش والتعاون والتعاضد بين الجماعات ذات التوجّهات الفكرية والاجتهادية المتباينة.
وهذا يعني أنّ الاختلاف ذاته ليس سبب الخلاف والنزاع. وبنظرة أدقّ نفهم أنّ السبب يعود إلى «الجهل» أو إلى «الأغراض الدنيوية»، فالجهل هو الذي دفع الخوارج لأن يشهروا السيف بوجه المسلمين، ودفع بخوارج عصرنا لأن يكفّروا المسلمين ويستحلّوا دماءهم، وهذا اللون من التعامل مرفوض كلّ الرفض في نظر الإسلام.
والأغراض الدنيوية هي التي أجّجت نار الحروب الطائفية في مقاطع كثيرة من التاريخ، ولاتزال مصالح الحكم والسلطة تلعب دورها في إثارة النزاعات الدينية، والدين منها براء، ولاتزال يد القوى المتجبّرة واضحة كلّ الوضوح في النزاع بين أهل السنّة والشيعة، بل وفي إثارة النزاعات بين أبناء المذهب الواحد.
متى ما كانت الحالة بعيدة عن الجهل وعن الأغراض الدنيوية فلا تجد ثمّة سوى التفاهم والحوار والبحث العلمي على أساس الدليل والبرهان والاحترام المتبادل.
ويمكن الاستدلال بسبر أقوال بعض العلماء في المقام..
يقول المرحوم الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء في مقال له تحت عنوان «بيان للمسلمين» : «المسلمون بعد اتّفاقهم كلمة واحدة على أنّ القرآن العزيز وحي من اللّٰه جلّ شأنه وأنّ العمل به واجب، ومنكر كونه وحياً كافر، والقرآن صريح في لزوم الاتّفاق والإخاء والنهي عن التفرّق والعداء، وقد جعل المسلمين إخوة، فقال عزّ شأنه : (إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)، (وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللّٰهِ جَمِيعاً وَ لاٰ تَفَرَّقُوا) (إِنَّ اَلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كٰانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ)، إلى كثير من أمثالها، فبعد اتّفاقهم على وجوب الأخذ بنصوص الكتاب الكريم لهم مهما بلغ الخلاف بينهم في غيره،
فإنّ رابطة القرآن تجمعهم في كثير من الأُصول والفروع، تجمعهم في أشدّ الروابط من التوحيد والنبوّة والقبلة وأمثالها من الأركان والدعائم،
واختلاف الرأي فيما يستنبط أو يفهم من القرآن في بعض النواحي اختلاف اجتهادي لا يوجب التباغض والتعادي. نعم، أعظم فرق جوهري، بل لعلّه الفارق الوحيد بين الطائفتين السنّة والشيعة
هو قضية الإمامة، حيث وقع الفرقتان منها على طرفي الخطّ، فالشيعة ترى أنّ الإمامة أصل من أُصول الدين، وهي رديفة التوحيد والنبوّة، وأنّها منوطة بالنصّ من اللّٰه ورسوله، وليس للأُمّة فيها من الرأي والاختيار شيء، كما لا اختيار لهم في النبوّة، بخلاف إخواننا من أهل السنّة، فهم متّفقون على عدم كونها من أُصول الدين
ومختلفون بين قائل بوجوب نصب الإمام على الرعية بالإجماع ونحوه، وبين قائل بأنّها قضية سياسية ليست من الدين في شيء لا من أُصوله ولا من فروعه، ولكن مع هذا التباعد الشاسع بين الفريقين في هذه القضية هل تجد الشيعة تقول : إنّ من لا يقول بالإمامة غير مسلم؟ كلّا ومعاذ اللّٰه، أو تجد السنّة تقول : إنّ القائل بالإمامة خارج عن الإسلام ؟ لا وكلّا. إذاً، فالقول بالإمامة وعدمه لا علاقة له بالجامعة الإسلامية وأحكامها من حرمة دم المسلم وعرضه وماله، ووجوب أُخوّته وحفظ حرمته، وعدم جواز غيبته، إلى كثير من أمثال ذلك من حقوق المسلم على أخيه».
والمرحوم العلّامة السيّد شرف الدين العاملي يعقد في كتابه «الفصول المهمّة في تأليف الأُمّة» فصولاً يتحدّث فيها بالتفصيل عن العلاقة الطبيعية التي تربط أهل السنّة والشيعة باعتبارهم جميعاً مسلمين، يعترف كلّ منهما بما له وعليه من حقوق وواجبات تجاه المسلم الآخر.
والعلّامة الفقيد الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر السابق يقول في مقال له تحت عنوان «بيان للمسلمين» : «إنّ الدين الإسلامي قائم على نوعين من الأحكام :
أحدهما : أحكام ثابتة، يجب الإيمان بها، ولا يسوغ الاختلاف فيها، وليس من شأنها أن تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان، ولا أن تخضع لبحث الباحثين واجتهاد المجتهدين. ذلك بأنّها ثابتة عن اللّٰه تعالى بطريق يقيني لا يحتمل الشكّ، واضحة في معانيها، ليس فيها شي من الإبهام أو الغموض.
والثاني : أحكام اجتهادية نظرية مرتبطة بالمصالح التي تختلف باختلاف ظروفها وأحوالها، أو راجعة إلى الفهم والاستنباط اللذين يختلفان باختلاف العقول والأفهام، أو واردة بطريق لا يرقى إلى درجة العلم واليقين، ولا يتجاوز مرتبة الظنّ والرجحان.
والنوع الأوّل من الأحكام - وهو القطعي في روايته ودلالته - هو الأساس الذي أوجب اللّٰه على المسلمين أن يبنوا على صرحه وحدتهم غير متنازعين، وربط به عزّهم وقوّتهم وهيبتهم في أعين خصومهم والمتربّصين بهم.
والمسلمون كلّهم مؤمنون به أيماناً ثابتاً لا يتزعزع، لا فرق في ذلك بين طائفة منهم وطائفة. وإنّ جميع الآيات التي جاءت في النهي عن التفرّق وذمّ الاختلاف والتحذير منه، وضرب الأمثال بما كان من الأُمم السابقة حين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البيّنات، إنّما تعني الاختلاف والتفرّق في هذا النوع من الأحكام، ومن ذلك قوله تعالى : (إِنَّ اَلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كٰانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) (سورة الأنعام : 159)، (وَ لاٰ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اِخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَهُمُ اَلْبَيِّنٰاتُ) (سورة آل عمران : 105)، (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللّٰهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنّٰاسَ عَلَيْهٰا لاٰ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اَللّٰهِ ذٰلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ اَلنّٰاسِ لاٰ يَعْلَمُونَ*`مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَ اِتَّقُوهُ وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ لاٰ تَكُونُوا مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ*`مِنَ اَلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كٰانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمٰا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ). (سورم الروم : 30 - 32)، فهذا هو الاختلاف المذموم المنهي عنه في كتاب اللّٰه تعالى.
أمّا النوع الثاني من الأحكام فإنّ الاختلاف فيه أمر طبيعي ؛ لأنّ العقول تتفاوت، والمصالح تختلف، والروايات تتعارض، ولا يعقل في مثل هذا النوع أن يخلو مجتمع من الاختلاف، ويكون جميع أفراده على رأي واحد في جميع شؤونه
وهذا النوع من الاختلاف غير مذموم في الإسلام ما دام المختلفون مخلصين في بحثهم باذلين وسعهم في تعرّف الحقّ واستبانته، بل إنّه ليترتّب عليه كثير من المصالح، وتتّسع به دائرة الفكر، ويندفع به كثير من الحرج والعسر، وليس من شأنه أن يفضي ولا ينبغي أن يفضي بالمسلمين إلى التنازع والتفرّق، ويدفع بهم إلى التقاطع والتنابز.
ولقد كان أصحاب رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، والتابعون لهم بإحسان، والائمّة (عليهم الرضوان) يختلفون، ويدفع بعضهم حجّة بعض، ويجادلون عن آرائهم بالتي هي أحسن
ويدعون إلى سبيل ربّهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم نسمع أنّ أحداً منهم رمى غيره بسوء، أو قذفه ببهتان، ولا أنّ هذا الاختلاف بينهم كان ذريعة للعداوة والبغضاء، ولا أنّ آراءهم فيما اختلفوا فيه قد اتّخذت من قواعد الإيمان وأُصول الشريعة التي يعدّ مخالفها كافراً أو عاصياً للّٰه تعالى.
وقد كانوا يتحامون الخوض في النظريات وفتح باب الآراء في العقائد وأُصول الدين، ويحتمون فيها بالمأثور ؛ سدّاً لذريعة الفتنة، وحرصاً على وحدة الأُمّة، وتفرّغاً لما فيه عزّهم وسعادتهم وارتفاع شأنهم، ولذلك كانوا أقوياء ذوي عزّة ومهابة : (أَشِدّٰاءُ عَلَى اَلْكُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَيْنَهُمْ) (سورة الفتح : 29)...».
فعليه الاختلاف المذهبي نفسه ليس مدعاة للنزاع، اللهمّ إلّاإذا اقترن بحالة الجهل أو استغلّته الأطماع الدنيوية، حينئذٍ تثور النزاعات وتسفك الدماء باسم الدين، وليس للدين في الواقع دور فيها، بل إنّها تتعارض مع روح الدين وشريعته السمحاء.
تعدّد الحكومات
حالة التجزئة القائمة في عالمنا الإسلامي جرّت إلى حروب ونزاعات حدودية وغير حدودية كثيرة.. فهل تعدّد الحكومات بطبيعته يؤدّي إلى الاختلاف والنزاع ؟ ! لو نظرنا إلى الساحة العالمية لوجدنا أنّ البلدان التي تملك زمام أُمورها تتعاون مع بعضها تعاوناً يكاد يلغي الحدود بينها.
هذه الأسواق المشتركة والأحلاف المشتركة والاتّفاقيات المشتركة بين بعض بلدان العالم تثبت إمكان توحّد جهود بلدان العالم رغم تعدّد حكوماتها. التعدّدية إذاً في الأجهزة الحاكمة لا يؤدّي بذاته الى نزاع، بل إنّ النزاعات تنشب بسبب طغيان حاكم من الحكّام واستفحال روح التسلّط والعدوان فيه، أو بسبب تدخّل القوى الكبرى ودفعها لعملائها كي يحقّقوا عن طريق العدوان أطماعها.
الإسلام يرفض العدوان والطغيان، ويرفض الخضوع لإرادة المستكبرين، ويضع كلّ الضمانات للحيلولة دون هذه الحالة، وليس وراء النزاعات بين بلدان العالم الإسلامي سوى غياب الروح الدينية والالتزام الديني.
بين بلدان المسلمين كلّ الداعي للتعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والأمني - العسكري، لكن ضعف الدوافع الدينية، وفقدان الإرادة المستقلّة عند بعض حكّام هذه البلدان يحول دون الوحدة المنشودة، بل إنّ الطغيان أحياناً أو العمالة أحياناً أُخرى يؤدّي إلى هذه النزاعات المشهودة في عالمنا الإسلامي.
الاختلافات القومية
الاختلافات القومية حقيقة قرّرها القرآن الكريم، وعبّر عنها بالشعوب والقبائل، حيث قال سبحانه : (يٰا أَيُّهَا اَلنّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثىٰ وَ جَعَلْنٰاكُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ) (سورة الحُجرات : 13).
والآية الكريمة تبيّن الحقائق التالية :
أ - كما أنّ البشر مخلوقون بطبيعتهم من ذكر وأُنثى، كذلك مخلوقون بطبيعتهم من شعوب وقبائل، وهذه حقيقة ثابتة في الخلقة البشرية.
ب - إنّ الهدف من هذا الاختلاف هو «التعارف». وكما أنّ تعارف الذكر والأُنثى يخلق النماء والخصب البشري واستمرار الحياة الإنسانية، كذلك تعارف الشعوب والقبائل المختلفة يؤدّي إلى تلاقح الثقافات والأفكار والكفاءات لينتج الخصب الحضاري في حياة البشر.
ج - إنّ معيار التفاضل بين الأفراد والجماعات هو الرقي في سلّم التكامل الذي عبّر عنه القرآن بالتقوى.
واستطاع الإسلام أن يسجّل أفضل صور التفاعل بين الشعوب المسلمة، وأجمل ألوان التعايش بين القوميات المختلفة، ولعلّ اجتماع سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي بين صحابة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله كان مقدّراً له أن يكون رمزاً للامتزاج الحضاري بين آسيا وأُوروبّا وأفريقيا في بوتقة الإسلام.
غير أنّ النعرات الجاهلية القائمة على أساس غياب الروح الدينية واستفحال الذاتيات الضيّقة لعبت دورها على مرّ التاريخ في إثارة النزاعات القومية بين المسلمين، وكان لحكّام بني أُميّة وولاتهم دور مخجل في إثارة التمييز العنصري،
وفي عصرنا الحديث لعبت السياسة الاستعمارية دوراً بغيضاً في إثارة العنصريات القومية بين شعوب بلدان العالم الإسلامي، بل بين قوميات البلد الواحد، ونشأت في العالم الإسلامي أحزاب تتبنّى التعصّب القومي تقليداً للغرب أو عمالة له، جاهلة أو متجاهلة أنّ التعصّب القومي أحرق الغرب وأدخله في حربين عالميتين إضافة إلى حروب طاحنة محلّية، حتّى صحا على نفسه، وألغى التعصّب القومي، وأحلّ مكانه التعاون والتفاهم.
الاختلاف القومي اذن ليس مدعاة بنفسه للخلاف والنزاع، بل هو عامل إثراء وإنماء إن كان في ظلّ التعارف والتعاون، وهذا ما دعا إليه دين الفطرة.
اختلاف اللغة
لم يلغ الإسلام لغات الشعوب المفتوحة وإن شجّع على تعلّم اللغة العربية، ولا أدلّ على ذلك من تعايش العربية مع لغات العالم الإسلامي، ومن تحدّث الأجيال العربية المهاجرة بلغات المهجر منذ القرن الهجري الأوّل، فإنّ كثيراً من العلوم دوّنت باللغات الإسلامية إضافة إلى اللغة العربية
غير أنّ إقبال المسلمين على تعلّم العربية ظاهرة مشهودة على مرّ التاريخ، يغذّيها حبّ المسلمين لفهم القرآن والحديث ونصوص الدين المبين.
والواقع أنّ اللغة تسهم إلى حدٍّ كبير في إحلال التفاهم بين أبناء الأُمّة، ولا يمكن أن تكتمل وحدة الأُمّة إلّاإذا اقترنت بوحدة لغوية بينها.
واللغة العربية باعتبارها لغة القرآن قادرة على أن تكون لغة التفاهم بين المسلمين، شرط أن تبذل الجهود لإحيائها في البلدان غير العربية، بل وحتّى في البلدان العربية التي غلبتها اللهجات العامية وسيطرت على ألسنة العرب بدل العربية الفصحى، أليس من المؤسف أن تتحدّث الدول المسلمة في اجتماعاتها باللغة الإنجليزية والفرنسية، ولا تتحدّث بلغة دينها وقرآنها وتراثها، وهي اللغة العربية ؟ !