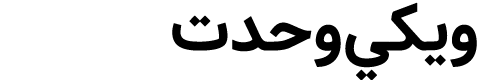عوائق الصحوة الإسلامية
العقبات والعراقيل التي تقف عائقاً دون ترشيد الصحوة المباركة للأُمّة الإسلامية. ويمكن إيرادها فيما يلي:
1 - تشكيك وتحريف وتخطئة الدين.
ممّا دأبت عليه قوى الشرّ والطغيان في كلّ زمان ومكان، سواء في ذلك عهود النبوّات السابقة أو العهود الإسلامية السالفة أو عصرنا الحاضر، وذلك عند استيلائهم على الشعوب الضعيفة التي يبغون نهبها، هو قيامهم بمجموعة ممارسات تخريبية يحاولون من خلالها إحباط المشاريع الإصلاحية لتلك الشعوب وهبط عزائمها. فتراهم يستسيغون لكلّ بلد وعند كلّ حقبة من الزمن أُسلوباً معيّناً لمواجهة الشعوب وإبادتها، تتمثّل في التشكيك بمعتقدات تلك الشعوب، أو تخطئة مبادئهم الفكرية،
أو تحريفها عن مواضعها المقصودة. الممارسات التي تؤدّي بالنهاية إلى زعزعة استقرار الأُمّة، وفقدان هويتها العقيدية، والانسلاخ عمّا تعتنق من قيم ومثل وأُصول.
وهي المحاولات الشرسة التي راح ينفّذها المستعمرون وأذنابهم في منطقتنا الإسلامية من أجل تذويب صحوتها المناهضة. ذلك بعدما طغى إعلامهم المضلّل على كلّ شيء، بحيث صيّر الحقّ باطلاً والباطل حقّاً، مستندين في إجرامهم الشيطاني هذا إلى شعارهم الخؤون (الغاية تبرّر الوسيلة)!
ففي بعض هذه التجارب التخريبية التي عاصرناها، راح الأعداء يخطّئون أو يشكّكون أو يحرّفون نفس الفكرة التي يتبنّاها المسلمون،
كما بالنسبة لأتباع الديانة العيسوية، حيث أخذوا يشيعون في أوساط السذّج من الناس وكأنّهم عثروا على ما يسعدهم في الدارين شبهتهم المضحكة من أنّ الإسلام دين العنف والإرهاب مستندين إلى قوله تعالى: (فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ) (سورة البقرة: 194)،
والحال أنّ دينهم العيسوي بزعمهم يدعو إلى التسامح والرحمة والودّ حتّى بالنسبة إلى الأعداء، كما في الإصحاح الخامس من إنجيل متّى!
كما عملوا عن طريق التزوير والتشويه، فراحوا يغيّرون المعاني والمفاهيم المقصودة في الشريعة الإسلامية، ويعرضونها في معنى آخر لا يمتّ إلى الدين بصلة زاعمين أنّه المعنى المفضّل والمقصود لهذه المفاهيم والتعاليم والمصطلحات الدينية، كالمحاولات اليائسة لبعض أتباع الأنظمة الوضعية الحديثة، والتي كانت - ولاتزال - تطالب بمزج شيء من أحكام ومعتقدات الإسلام وشيء من متبنّيات الماركسية، ليستخلصوا من هذا المزيج مذهباً اقتصادياً حديثاً يزعمونه الأفضل لمجابهة الرأسمالية أوّلاً، ولسدّ الفراغ الذي يعاني منه الاقتصاد الإسلامي بزعمهم ثانياً!
وكذا المحاولة المدروسة للبعض من أتباع الديانة الإسلامية، وذلك منذ بزوغ فجر الإسلام،
حيث انتهجوا مسلك الرهبنة والاعتزال والتصوّف زاعمين أنّ المسلم المتعبّد يجب عليه أن يصلح نفسه ويهذّب غرائزه من الدنس فحسب، أمّا معاشرة الآخرين وإرشادهم وصدّهم عن الانحرافات أو حتّى النهي عن المنكر وجهاد أعداء الدين، فذلك غير ضروري له وهو متروك لأهله وأوانه!
وكذا ما أُثير حول المرأة وحقوقها من أبحاث، حيث صرّح الكثير منهم بإجحاف الإسلام للمرأة،
وغصب حقوقها في مجموعة واسعة من المجالات، والحال أنّ الغرب قد راعى العدالة في شأنها!
ومن المؤسف حقّاً أنّ معظم هؤلاء المزيّفين للحقائق، إمّا هم من المستشرقين الذين لا صلة ولا معرفة لهم بتعاليم الإسلام، وإمّا من الجهلة المحسوبين على الإسلام والذين يفتقرون إلى الاختصاص في المجالات الدينية. فمكائد هؤلاء طالما أثّرت في نفوس الضعاف من أبناء أُمتنا، فآمنوا ببعض هذه المفاهيم والمصطلحات الإسلامية، لكن بمعناها المشبوه والمحرّف.
من هذا المنطلق يلزم على علماء المسلمين وروّاد مسيرتهم أن يعالجوا الموارد المثيرة للشكوك إن كانت موجودة في متبنّياتهم الفكرية؛ كي لا يستغلّها الأعداء والمفرّقون بين المسلمين كحربة لتخطئة الدين ورموزه.
كما وأنّهم يلزم بهم أن يعوا ويدركوا معاني مصطلحات المذاهب الأُخرى؛ حتّى لا يتّهمون بالتحريف والسذاجة،
وبذلك لا يقدّمون خدمة للأجانب والأعداء، فيخطّئوا الديانة الإسلامية بأكملها.
2 - الخلافات المذهبية.
في خصوص الخلافات المذهبية بين المسلمين لا يمكننا سوى الاعتراف بأنّ معظم هذه الخلافات والفتن، وكذا استخدام لغة الطعن والجرح وتعكير الأجواء في المناسبات والأماكن العامّة، ليست من الإسلام كدين معروف بدعوته للوحدة ونبذ الخلاف: (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) (سورة الأنبياء: 92)، بل هي لقضايا طارئة، وحواجز نفسية، وجهل عوام الأُمّة، وسياسات الحكّام المغرضين، وبتبعها كيفية استنباط النصوص من قبل بعض الفقهاء وإصدار الفتاوى الشاذّة على ضوئها، فهي التي سبّبت الويلات للإسلام والمسلمين فيما بعد وحتّى يومنا هذا، وإلّا فإن كان حصول هذه الخلافات والحوارات المرافقة لها بداعي تبيّن الحقائق التأريخية والمباني الفقهية والأُسس العقائدية فحسب،
ولكي يعيها أبناء الأُمّة ويختاروا ما يشاؤون، فلا بأس بها، وهي محبّذة لدى القرآن والسنّة، أمّا في فترتنا الحالية - وهي زمن امتداد الصحوة الإسلامية - فيلزم الجميع أخذ العبر من الماضي؛ لكي نستعين بها في حلّ المشاكل المستقبلية المحتملة التي قد تحيط بمذاهبنا وإسلامنا العزيز.
وذلك بالتركيز على ما يلي:
أ - القضاء على الجهل المذهبي الذي ابتلي به أتباع بعض الفرق الإسلامية، خصوصاً الجهل الذي يعاني منه عدد غير قليل من علماء المسلمين، حيث لا يعرفون الكثير من متبنّيات الفرق الإسلامية الأُخرى، لكنّهم يحكمون على تلك الفرق بما شاؤوا جهلاً وبغياً،
فينسبون إليهم أُموراً لا يعتقدون بها، والحال أنّ مصدرها هو كتب الأعداء والمستشرقين الذين لا يريدون للأُمّة الإسلامية بجميع فصائلها خيراً، فيسمعون من الأغيار ولا يسمعون من أصحاب الفكرة أنفسهم كالشائعات والأوهام التي يتلقّاها علماء الأُمّة، فيحكمون استناداً إليها على شرعية أو عدم شرعية مذهب إسلامي آخر بما لا يرضي اللّه ورسوله.
ب - يبدو أنّ هاجس التذويب والاضمحلال الذي يتخوّف منه أتباع بعض المذاهب، قد أثّر أثره عليهم، فصاروا يتخيّلون اندحار وفناء مذاهبهم ومعتقداتهم إذا ما تناسوا الخلافات المذهبية، فتراهم يصرّون على هذه الخلافات ويأجّجون نارها صيانة لبقاء مذاهبهم بحسب زعمهم،
ولا سيّما في البلدان التي يشكّل فيها هؤلاء المتخوّفون الأقلّية من أبنائها. لكن الصحيح عكس ذلك تماماً، حيث إنّ الدعوة إلى الحوار الهادئ وحلّ المشاكل العالقة بصورة موضوعية إن كانت موجودة، والسماح لأتباع كلّ مذهب بعدم التنازل عن ما لا يمكنه التغاضي عنه، هو المفروض والمعقول في زمن الصحوة.
إذاً المشكلة ليست مشكلة دمج المذاهب وتذويب معتقداتها، بل كلّ ما في الأمر هو تقريبها الذي يعني: التركيز على مشتركاتهم الفكرية في بادئ الأمر،
وما أكثرها بين المسلمين، ومن ثمّ توحيد صفوفهم وسواعدهم أمام الأعداء والأجانب، حيث هو تجسيد لفريضة البراءة ومن يلزم التبرّي منه من أعداء أُمّتنا، وضرورة اتّخاذ موقف موحّد منهم، كلّ القضية هذه لا أكثر.
ج - ظاهرة الطعن والجرح والتفسيق والتكفير، وبغضّ النظر عن المؤدّيات التي انتجتها حتّى الآن في أُمّة محمّد صلى الله عليه و آله، هي ظاهرة بعيدة عن الموضوعية المدعوين نحن إليها، مضافاً إلى أنّها لاتنسجم مع الأخلاق الإسلامية العالية ومعتقداته الغالية.
فالمفروض بعلماء وأتباع جميع المذاهب الإسلامية أن يقفوا دون كلّ من يحاول إثارة النعرات المذهبية واللاموضوعية من أبناء مذاهبهم، ويمنعوهم من استخدام قدراتهم البيانية والبنانية والمالية في تأجيج نيران الخصومة بين المسلمين، كالأموال الباهضة التي تصرف سنوياً من قبل بعض الفرق المحسوبة على الإسلام، وذلك لأجل إقناع سائر المسلمين بأنّ الشيعة هم كفرة ولا تجوز ذبيحتهم ولا يجوز التزاوج معهم، بل إنّ في قتلهم أجراً وصواباً! ونعوذ باللّه من مضلّات الفتن.
وأخيراً،
ينبغي أن لا يُنسى دور الاستكبار العالمي وعملائه في المنطقة الإسلامية من أجل استغلال عواطف المسلمين وجرّهم نحو هذه الخلافات اللامرضية لدى العقل والشرع. فقاعدة (فرّق تسد) الاستعمارية ليست بغائبة عن أذهاننا، بعدما عرفناهم بخطّتهم
الخبيثة هذه قد ولّدوا الكثير من البغضاء والحروب في القرون الثلاثة الأخيرة ما بيننا، دون أن يستشعر الكثير منّا لذلك.
3 - الخلافات القومية واللغوية.
من الآفات المهدّدة لصحوة أُمتنا الإسلامية والمانعة عن رشدها هي الخلافات التي تثار بين الحين والآخر فيما بين فئات عرقية منتمية إلى إسلامنا العزيز، أو مجاميع مسلمة لا فارق بينها سوى اللغة التي يتحدّثون بها، حيث إنّ لهذه العلّة دورها البليغ في تأجيج نيران الفتن بين المسلمين من جانب،
والإضرار بصحوتهم المتنامية من جانب آخر.
فنحن وإن كنّا بحسب فطرتنا الدينية وشعائرنا القرآنية نعتبر أنّ الاختلافات القومية واللغوية آيات إلهية تدلّ على عظمة المبدع الخالق الذي صوّر مخلوقاته بصور شتّى، كما ورد ذلك في الآية 3 من سورة الحجرات والآية 32 من سورة الروم في الذكر الحكيم،
وكما صرنا لأجل ذلك نبجّل إسلامنا العزيز ونبيّه الكريم، حيث استطاعا من هذا المنطلق أن يجمعا بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وأبي ذرّ العربي، يجمعهم في خندق واحد؛ كي يرفعوا لواءً واحداً، ويهدفوا منهجاً موحّداً هو الإسلام العزيز، لكن أبالسة الإنس من الطواغيت وأصحاب القدرة والثروة وبتعبتهم الجهلة، طالما استثمروا هذه الاختلافات التكوينية التي صوّرها اللّه بين عباده، كوسيلة تمزيقية لأغراضهم الخؤونة، حيث إنّ عمر هذه الخطوات الخيانية قديم بقدم عمر البشر نفسه.
يكفينا للاستدلال على صحّة هذا الكلام مراجعة التأريخ وموسوعاته الضخمة للتعرّف على الكثير من الحروب والمشاحنات والافتراقات التي حدثت بين أبناء البشر، بل بين أبناء الأُمّة الواحدة،
بل وحتّى بين أصحاب الهدف الواحد، بعدما ابتلوا بالإثنينية والنفاق. وذلك يعود إمّا لاختلاف في أقوام هؤلاء قد صار سبباً لتفاخر بعضهم على بعض، وإمّا لاختلاف في لغاتهم دعاهم إلى التفاخر والتعصّب أيضاً.
فنحن في عصرنا هذا - وهو عصر الصحوة الإسلامية - يستوجب علينا ومن أجل الرجوع إلى إيماننا الحقيقي بالله وبالغيب وبالمثل أن نعي خطورة تلك المفاهيم الرجعية
الضيّقة وما تسبّب لنا من مشاكل إذا ما سمحنا لها بالاستفحال في أوساطنا، ونحاول بشتّى الطرق الإعلامية والتربوية والمهرجانية أن نفهم أبناء أُمّتنا المجيدة أنّ الإسلام الأصيل لا يتّفق مع القومية الحديثة بمعناها الغربي والرجعي بتاتاً،
ذلك بعدما ثبت لنا بالبيّنة والوجدان أنّ حبّ الوطن واللغة والعشيرة والأمجاد يختلف عن التعصّب لها وعن تفضيلها على كلّ شيء حتّى على الدين الإسلامي! كما ونبيّن لهم أنّ خطّة الأعداء والمستكبرين في البحث عن أمجاد السالفين والإشادة بتراثهم الإلحادي المندرس ما هي إلّامكيدة لحجب المسلمين عن إسلامهم العزيز ورسالته العالمية، حيث إنّهم يحاولون أن يدخلوا حبّاً وولاءً غير حبّ اللّه وولائه في قلوب المسلمين.
4 - التنفيذ الخاطئ للإسلام.
من أجل أن تكون الصحوة الإسلامية المعاصرة ناصعة ومهذّبة في بيان أهدافها ونشر متبنّياتها للعالمين كافّة، يلزم بها أن تزيل كلّ ما يشوّه سمعتها ويشوب صبغتها من أخطاء فكرية وعملية تلصق بالإسلام، والحال أنّ الإسلام الأصيل بريء منها كلّ البراءة،
أو أنّها مبالغ فيها. ذلك سواء في أوساط غير المسلمين الذين ينظرون إلى الإسلام بنظرة الريب والترديد، أم في أوساط المسلمين أنفسهم، حيث من المحتمل أن يتأثّروا بهذه المشوّهات والأخطاء.
فنحن لا يمكننا أن ننكر وجود مجموعة من الأعمال والطقوس التي تؤدّى باسم الدين الإسلامي على يد أتباع بعض الفرق والمذاهب الإسلامية،
والحال أنّها اجتهادات مذهبية قد يكون المبدع لها بعض مؤسّسي تلك المذاهب أو ساستهم أو مريديهم الجهلة.
ومع كلّ الأسف فإنّ البعض من هذه الأعمال والطقوس إلى حدّ هي سخيفة أو عنيفة بحيث شوّهت وجه الإسلام المشهود بتعاليمه الراقية ومعتقداته المتينة وسلوكيته المثالية، وصار الكثير من أبناء الغرب مسلمين وغير مسلمين وبتضليل من الإعلام الاستكباري الخؤون يتخوّفون من الإسلام، وهم مستغربون لأفعال هذه الفرق المتشدّدة والمغالية التي تعمل ما تعمل باسم الإسلام والصحابة وأئمّة الدين. خير مثال لها هي الظاهرة الطالبانية في
أفغانستان، حيث إنّها بتنفيذها الخاطئ والمزوّر للإسلام قد شوّهت على نفسها ابتداءً، ثمّ على الإسلام ككلّ.
إنّ الصحوة الإسلامية المعاصرة، وإن كانت التقارير والأرقام تشير إلى نموّها وازدهارها يوماً بعد يوم، لكن وجود هذا التخلّف في أوساط المنتسبين للإسلام حقيقة يلزم بنا مواجهته ومعالجته، وكذلك إفهام الجميع بأنّ المقياس الحقيقي لتبيين الإسلام الواقعي وتشريعاته الناصعة هو ذات هذا الإسلام وتشريعاته المتحدّث عنها، وليس كلّ ما يقوم به المنتسبون إليه.
إنّ المصلحين من روّاد المسيرة الإسلامية بما فيهم معظم علماء المذاهب الواعين كانوا - ولا يزالون - يميّزون بين النظرية الإسلامية الراقية، وبين ما قد يقوم به أو ينفّذه بعض المحسوبين على الإسلام من تنفيذ خاطئ ومردود، أي: ذلك التنفيذ القاصر المشبوه، والذي يتجلّى بظاهر ديني وصبغة مذهبية، لكنّه معارض لحكم الكتاب والسنّة، كما ويحتاط الفقهاء في مشروعيته.
5 - الفرق الضالّة.
لا شكّ أنّ ديننا الإسلامي الحنيف هو أفضل الأديان وأنزهها ظاهراً ومحتوىً، ولذلك شاءت الإرادة الإلهية أن تكون رسالته خاتمة الرسالات، لكنّه كغيره من الأديان والمشاريع السليمة والنزيهة قد ابتلي بالانشقاق والتفرقة لأسباب سياسية وعشائرية ومزاجية معروفة، لا حاجة لذكرها الآن.
وقد استمرّت ظاهرة نشوء الأحزاب والفرق الفكرية والعقائدية المغالية والمضلّلة، والتي أثبتت التجارب والوثائق فيما بعد أنّ نشوء الكثير منها كان بأمر من الاستعمار وبصرف الأموال الباهضة من قبله.
وما الظاهرة البهائية والماسونية والعلمانية وعبدة الشيطان والتحزّبات الإلحادية الأُخرى إلّامصاديق حيّة للخبث الاستعماري في بلداننا. هذا مضافاً إلى الزمرة الصهيونية باعتبارها تشكيلة مذهبية متعصّبة يعارضها الكثير من يهود العالم، حيث إنّ يد الاستكبار العالمي جلية في إنشائها ودعمها أيضاً، فإنّ القاسم المشترك
بينها جميعاً، سواء التي تظاهرت بالتضليل الإلحادي أم التي سارت وسادت في انحرافها المذهبي، هو تآزرهم على تضليل المسلمين وإبعاد الإسلام عن قيادة الأُمم.
فمن المآسي التي نعانيها جرّاء نشوء ووجود هذه الفرق المتمرّدة عن الإسلام الأصيل هو تصوّر الكثير من الغربيّين بل وحتّى بعض المسلمين بأنّ ما يقوم ويعتقد به هؤلاء من أفكار وممارسات هو جزء من الإسلام، وأنّهم يمثّلون الإسلام الحقيقي النازل على رسول اللّه صلى الله عليه و آله.
ومن هذا المنطلق فإنّ الكثير من الآفات والأمراض الاجتماعية والأخلاقية التي ابتليت بها أُمّتنا الإسلامية في العقود الأخيرة، كالخلافات القومية والمذهبية، والتشكيك في الدين، والجمود، والتحجّر، والتجدّد الخاطئ، والتطرّف، والتحلّل الأخلاقي، والتذويب، والتحريف، والتنفيذ الخاطئ للإسلام، وغيرها، يعود سببها إلى هذه الفرق المتطرّفة والضالّة عن الإسلام، دع عنك الصهيونية والعلمانية المعاديتين للإسلام من الأساس.
إذاً فنحن ملزمون بالتصدّي لهذه الفرق الضالّة، وإقامة حوارات عقيدية معهم إن كانوا مستعدّين لها، أو فضحهم والتشهير بمعتقداتهم وأفعالهم عند الضرورة؛ كي نصون بذلك صحوتنا المباركة من هذه الآفة الفتّاكة ونرشدها نحو الصواب المطلوب.
6 - الجهل.
إنّ المقصود في المقام هو جهل مجموعة من أبناء أُمّتنا عمّا يدور حولهم من مجريات وتغيّرات اجتماعية وسياسية وفكرية، تخصّهم أو تخصّ غيرهم، وكذلك مسؤوليات ومهام هم أولى بتحمّل عبئها من غيرهم.
فإنّ الجهل وإن كان بجميع صوره معيباً على المسلم والداعية إلى اللّه - ولا سيّما ذلك الجهل الذي يرتبط بدينه ووظائفه العملية - ولكن عند بحثنا عن الأخطار التي تواجه الإسلام والمسلمين في زمن الصحوة الإسلامية يشترط بالمسلم أن يكون محيطاً وملمّاً بالأحداث الاجتماعية والسياسية التي يستغلّها الأعداء للنفوذ في الجبهة الإسلامية، ولو
بالقدر المستطاع والمسموح.
فحقّاً لو تدبّرنا في الكثير من النواقص التي عاشتها أُمّتنا الإسلامية في سنيها المتأخّرة، بحيث أصبحنا مسيّرين من قبل غيرنا ولسنا من المنذرين ولا الهادين ولا المبشّرين الذين وصفهم القرآن، ألم يكن الجهل بحقائق ديننا وبما يدور حولنا من أحداث هو البوّابة الرئيسية لسقوطنا فيما صرنا إليه، فصار الكثير من المسلمين لا يميّز بين الإسلام المحمّدي الأصيل وبين الإسلام المستورد من الغرب وعملائه، كما نبّه على ذلك الإمام الخميني قدس سره؟
أو ليست الصفات الذميمة والحالات السلبية التي ابتلينا بها، كالاستنكاف عن قبول الحقّ،
والاستكبار على اللّه والخلق، والإصرار على الذنب، وإفشار الأسرار، وبغي بعضنا على بعض، وتبرّج النساء وتعرّيهن، والإسراف، والتكبّر، والتهاون، والتجرّي، وجحود الحقّ، والجزع، والحمية الجاهلية، وحبّ الدنيا، والخذلان، والإضرار، والرياء، والغدر، والغرور، والخيانات الأُسرية، والغضب، والتشتّت، والقساوة، والهجران، ونسيان المسؤولية، والكفر بالنعم، وغيرها، أو ليست كلّها من نتائج الجهل؟
هذا، والكثير من الناس في بلادنا الإسلامية صاروا يعتبرون بعض هذه الصفات الذميمة والمحرّمة شرعاً، كتبرّج النساء وتعرّيهن، والإسراف، والتبذير، والرياء، والخيانات الأُسرية، ونسيان المسؤولية، والافتتان بالدنيا، هي من علائم التحضّر والتحرّر، وراحوا يعيبون على من لا يشاركهم في الاتّصاف بها!
فهي في الواقع صارت أرضية مناسبة لغزو بلادنا الإسلامية من قبل مستكبري الغرب والشرق، حين يرون الجهل والظلم مخيمين علينا، بحيث أصبحت الأُمّة بمعزل عن دينها وعن قياداتها الشرعية.
إذن لا يغالي من يعتبر أنّ الجهل ألدّ أعداء المسلمين، وبزواله يغنم المسلمون مواقع كثيرة تصدّ العدوان الغازي من التسلّل والتخريب، سواء كان هذا الغازي عدواناً عسكرياً ملموساً، أو أحزاباً علمانية مضلّلة،
أو أفكاراً إلحادية مستوردة، أو مناهج دراسية منحرفة،
أو حتّى جهل بعضنا نحن المسلمين بأفكار ومعتقدات البعض الآخر من أتباع الفرق الإسلامية، والذي طالما سبّب الشحناء والتفرقة فيما بيننا.
7 - الحروب وسلب الأمان.
من الأُسس المؤثّرة غاية التأثير في تحقيق السعادة البشرية هو الأمن والأمان، حيث تزدهر به المجتمعات من الجوانب العلمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية وحتّى السلوكية، وبذلك يعيش أفراد تلك الأُمم أيّام رقيهم وتعاليهم الباعث بالفخر والسرور والتقدّم.
لكن الاستراتيجية المعهودة والمدروسة التي سار عليها الاستكبار العالمي ولا سيّما بعد نمو الصحوة الإسلامية الأخيرة هي إشعال نيران الفتن والحروب بين المسلمين وحكوماتهم؛ لكي يغنم بالتالي أُموراً:
أوّلها: إشغال المسلمين بأنفسهم وبمشاكلهم وبالأحقاد التي تتولّد في مشاعرهم تجاه الآخرين من أبناء أُمتهم.
ثانيها: تنفيذ المراحل المتبقّية من المشروع الصهيوني الاحتلالي في المنطقة الإسلامية شيئاً فشيئاً، دون أن يتحسّس أبناء الأُمّة لذلك.
ثالثها: بيع أسلحتهم الفتّاكة والمدمّرة على الدول الإسلامية المتصارعة فيما بينها من جانب، ونهب ثرواتهم الغالية والعزيزة بثمن بخس من جانب آخر.
رابعها: تطوير كفاءاتهم العسكرية والتقنية والفنّية بغية تصنيع أحدث الأسلحة وأبشعها، وتهديد الدول الأُخرى بها من جانب، وتضعيف بل إماتة الطاقات والقدرات العلمية في الدول الإسلامية من جهة أُخرى، وبالتالي جعلها أدوات مستهلكة فحسب، لذلك لم يخطئ من يقول: بأنّ أكثر الفروع والاختصاصات العلمية والتقنية تطوّراً وتقدّماً من غيره في أزمتنا المتأخّرة هو فنّ واختصاص التقتيل، وبتعبير أكثر تأدّباً: هو فنّ شنّ الحروب وإزهاق الأرواح!
لذلك يجدر بكبار الأُمّة الإسلامية وساستهم ومخلصيهم أن يبعثوا روح التضحية والمقاومة والمثابرة في نفوس أتباع هذه الأُمّة المضطهدة من أجل الاستعانة بقدراتهم عند الضرورة.
8 - التحلّل الخُلقي.
ممّا لا ريب فيه أنّ اللّه سبحانه وتعالى قد زوّد الإنسان بمجموعة من الغرائز، فأراد لها أن تكون منظّمة لحاجاته الفطرية والشعورية، كما وأنّها تدفعه نحو إنجاز قراراته العقلية وسمّوه الروحي، إذاً قرارات العقل السليم لا تتكامل إلّابتفاعلها مع هذه الغرائز المهذّبة للإنسان من الدنس والخسّة.
لكن الواقع الذي يعيشه البشر في أزمتنا المتأخّرة هذه - ولا سيّما في الغرب المتهرّب من الدين والنبوّات - يعاكس مقولتنا هذه تماماً، فإنّ معظم ساستهم ورعاياهم ومفكّريهم وجهلتهم ذهبوا إلى أنّ المدار والمناط في العلاقات الاجتماعية والأخلاقية هو إرضاء هذه الغرائز، بل وإشباعها أكثر من حاجاتها، وإن أدّى ذلك - وكما بالفعل قد أدّى - إلى انتشار الفساد وانعدام الخلق!
وهو ليس بغريب على شعوب يذهب لذلك بعض مفكّريها من أمثال «وليام جيمس» الأمريكي و «فرويد» اليهودي، ويقرّه بعض باباواتهم بالصمت وغضّ الطرف تارة، وبالتأييد أحياناً أُخر، كما أقرّت وشرّعت بعض كنائس بريطانيا زواج أبناء الجنس الواحد، واعتبرته مشروعاً!
أمّا نحن الآن فنتحدّث عن ديننا الإسلامي ورسالته الغرّاء التي طالما أصبحت في مهب الرياح الغربية الفاسدة ومطمعاً لعصاباتهم الشرورة وساحة مستعدّة لنشر سلوكياتهم المرفوضة بحكم العقل والنبوّات. ذلك لكي يفصل الإنسان المؤمن ارتباطه المعنوي باللّه وبالقيّم من جانب، ويتناسى مسؤولياته الاجتماعية من جانب آخر.
إذن لا بدّ للمتسلّطين على رقاب شعوبنا الإسلامية وبلداننا التوحيدية أن يكفّوا عن عمالتهم ويعوا خطورة واقعنا المؤسف؛ لكي لا يغزونا الأعداء من كلّ صوب وحدب،
ولا يسرقوا منّا ما نمتاز به على سائر الأُمم من خير، ونحافظ على سلامة شبابنا وشاباتنا من كلّ الأمواج اللاخلقية الغازية، ونصون أنفسنا وأهلينا من التقليد الأعمى للغرب.
فمن أجل أن نقي صحوتنا الإسلامية المعاصرة من الأخطار اللاخُلقية والمكائد
الجنسية المحتوشة بأبنائها، ينبغي بنا التركيز على تعديل أنظمتنا التعليمية والتربوية في بلداننا قبل كلّ شيء، كما وأنّ لتهذيب وسائل إعلامنا الناطقة والمرئية دوراً هامّاً في علاج هذا المعضل. هذا مضافاً إلى ضرورة دعم وترشيد جميع المنابر الإسلامية الأُخرى والمنشورات الدينية والحوارات الإسلامية والمعاهد الدراسية من أجل الوصول للهدف.
9 - العلمنة.
وهي: فصل الدين عن الحكم والسياسة والثقافة والاقتصاد وكلّ ما يرتبط بالحياة الدنيوية. فبزعم دعاة هذه النظرية أنّ الدين يدعو إلى النموّ الروحي والإيمان بالغيب والمثل لا أكثر. أمّا الدنيا وما فيها من خصائص سياسية واقتصادية ورفاهية وما شابهها فلا رأي للإسلام فيها، بل يقف دونها كمعارض.
وقد ذهب قسم آخر منهم إلى أنّ الحكم والسياسة ظاهرتان اجتماعيتان،
وأنّ أبناء كلّ زمن هم الذين يقدّرون ما يستسيغونه لمتطلّبات أزمنتهم، فالآن وبعدما نفدت أيّام رقي الإسلام وعصر ازدهاره فلا ضرورة بل لا إمكان للرجوع إليه والأخذ منه. فهؤلاء جميعاً يدعون إلى العلمانية بعد ما افترضوا أنّ الدين شيء والدولة شيء آخر لا يمكن الجمع بينهما بعدما تجرّدا بعضهما عن بعض.
وبعدما تيقّن المستعمرون الماركسيّون الشرقيّون أو الإمبرياليّون الغربيّون أنّ الإسلام الأصيل والمناهض هو أكبر الموانع التي تقف أمام خيلائهم وسطوتهم، أخذوا يشيعون فكرة العلمنة واللادينية من أجل تخدير الشعوب، وذلك عن طريق ترويج إسلام مشوّه ومتهاون هم اختلقوه.
وما المواجهة الشرسة والدموية التي اتّخذوها في محاربة الدين الإسلامي وقمع رجاله ومفكّريه في العهود الأخيرة، كالسيّد جمال الدين الأسد آبادي والإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر والمفكّر القدير سيّد قطب، إلّاشواهد حيّة تثبت خوف العلمانية من رجال الدين العاملين وكرههم لهؤلاء الأعلام.
ولذلك عقيب التغيير الروحي والفكري والخلقي الذي شاهدناه ونشاهده في معظم
مجتمعاتنا الإسلامية، ولذلك بسبب إلغاء التشريعات والنظم الدينية من قبل الحكومات بتهم واهية كرجعية الإسلام أو عنفه أو ضخامة أخطاء بعض منتسبيه، واستبدالها بنظم وتشريعات وضعية قد استوردت من الغرب الكافر، قد ازداد الترويج للعلمانية في بلادنا الإسلامية العريقة بانتمائها للإسلام.
10 - العولمة.
إنّ مصطلح العولمة وإن كان حديث الصدور في الموسوعات الفكرية والسياسية العالمية، لكن نستطيع أن نجد له مرادفاً في المفاهيم الإسلامية التي سبقت الغرب بضرورة تبنّي المسلمين لهذا المعنى، وهو مفهوم العالمية استناداً إلى الآية: (وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنّاسِ بَشِيراً وَ نَذِيراً) (سورة سبأ: 28)، مع فارقين بين العالمية الإسلامية والعولمة الغربية، وهما:
أوّلاً:
الإسلام كلّه خير وحقّ وبشائر، وحينما يدعو إلى العالمية يقصد إيصال الخير والحقّ إلى الجميع ومن كلّ الأبواب التي تأتي بالخير والحقّ للعالمين.
أمّا العولمة الغربية فكلّ ما يستنتج منها هو استثمار فئة من البشر الفئات الأُخرى استثماراً سلبياً ظالماً، حيث تفنى به الفئات البشرية الضعيفة والمستضعفة.
ثانياً:
ما يبدو من العولمة الغربية هو أنّها تبدأ بالاستعمار والسيطرة الاقتصادية على الشعوب، لتنتهي بالسيطرة الثقافية التي تعتبر الغاية القصوى بالنسبة إلى الغرب، ولا سيّما أمريكا المنادية بالعولمة الجديدة، في حين أنّ عالمية الإسلام تعني إيصال الخير والحقّ في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأمنية والعلمية والتربوية والسياسية والحقوقية، مادّية ومعنوية، دنيوية وأُخروية، للبشر كلّهم،
وليس للمسلمين فحسب.
ومنه يتبيّن خطورة الدعوات الأمريكية الصهيونية بالعولمة، والتي لو تحقّقت بحذافيرها وبقي المسلمون والموحّدون مكتوفي الأيدي أمامها دون ردّ ومواجهة، لما بقي من الأديان وتعاليمها ومعنوياتها على الكرة الأرضية من أثر. ولو أردنا ذكر أهداف العولمة الأمريكية الصهيونية باختصار فهي تنحصر في أُمور:
أ - الاقتصاد الحرّ والمبيح لجميع المحرّمات، وإبادة كلّ مشروع اقتصادي مستنبط من الإسلام وتعاليمه.
ب - التجارات والاستثمارات العالمية تكون مطلقة، دون أن تحدّ بصياغة أخلاقية معيّنة تمنعها عن الهيمنة والاستبداد والظلم والإجحاف.
ج - إماتة جميع الثقافات الإقليمية، بما في ذلك تعاليم الأديان والآداب والسنن المحلّية ولا سيّما قطاع التعليم والتربية، واستبدالها بثقافة مستوردة تبيح كلّ شيء وتنفي كلّ قيد.
د - نشر وسائل الإعلام والارتباط حتّى تصل كلّ بيت وغرفة، ومهمّتها إفساد أرواح الناس قبل أجسادهم، وبذلك تقترب المسافات بين جميع أبناء البشر من أجل مسخهم.
ه - يكون للجنس والعلاقات اللاشرعية واللاعقلية بين الذكر والأُنثى الدور الرئيسي في ثقافة العولمة وأخلاقيتها.
و - يعزل الدين ورجاله وحماته عن جميع المظاهر الحياتية، وهو يعني فناءه التدريجي.
11 - خبث وسائل الإعلام.
إنّ الخباثة والدجل والنفاق والفجور والشذوذ أصبح دأب وسجية الكثير من وسائل الإعلام في العالم، ولا سيّما الغرب الحقود الذي بنى أُسس معتقداته وأخلاقياته على الاقتصاد المحرّم، والشذوذ الجنسي، والسياسة الماكرة، والأفكار الإلحادية، والابتعاد عن الفطرة السليمة.
12 - الاستشراق والتبشير.
نسبة إلى المستشرقين والمبشّرين المبعوثين من قبل الغرب المستعمر إلى ديارنا الإسلامية، فإنّهما وإن كانا من حيث الوظيفة والمهمّة يختلفان، كما تصرّح بذلك القواميس السياسية والتجسّسية، لكن هدفهما بالتالي يصبّ في مصبّ واحد، وهو إعداد الأرضية المناسبة للغزو العسكري والإعلامي والثقافي الذي يخطّط له الصليبيّون منذ مئات السنين،
بغية احتلال الدول الإسلامية والاستيلاء على ثرواتهم،
وبالتالي منعهم من التعاطف الفكري والسلوكي مع الإسلام وثقافته العالمية.
وبالنسبة للدواعي التي دفعت بالاستعمار الأُوروبّي سابقاً والأمريكي مؤخّراً لإنشاء اللجان التجسّسية والتبليغية وبعثها إلى البلاد الإسلامية، فهي عديدة:
منها: منع الشعوب الأُوروبيّة وكذا النصارى الذين يعيشون في البلاد الإسلامية بسلم وأمان من التعرّف على الإسلام ومعايشته وتقبّله كمعتقد. ذلك بعدما صرّح القرآن وأثبتت التجارب وجود تقارب نسبي بين بعض مجالات التعاليم الإسلامية والمسيحية، كما شهد بذلك قرآننا الكريم في الآيتين 82 و 83 من سورة المائدة بقوله: (لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اَلَّذِينَ قالُوا إِنّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَ رُهْباناً وَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ * وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى اَلرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ اَلدَّمْعِ مِمّا عَرَفُوا مِنَ اَلْحَقِّ...)، وهي الحقيقة التي أثبتها واقعنا المعاصر في أُوروبّا الصليبية، بعيد رفع بعض الحواجز الحدودية بين الغرب والشرق الإسلامي،
وكذا عقيب تطوّر وسائل الإعلام وتقنية شبكات الاتّصال، فصار الأُوروبيّون يفدون نحو الإسلام ويعتنقونه أفواجاً وأُسراً، وبذلك أصبحوا مصداقاً لسورة النصر القرآنية.
ومنها: إعداد العدّة لأسيادهم المستعمرين، وذلك بغية الاستيلاء على المسلمين ونهب ثرواتهم وتحطيم رسالتهم الخالدة، وأخيراً الانتقام وأخذ ثأر هزائم الحروب الصليبية منهم.
ولا ينكر وجود مجموعة قليلة من هؤلاء المستشرقين قدموا إلى بلادنا وهم يبغون الدراسة العلمية والتحقيق الشفّاف عن الإسلام والمسلمين فحسب، دون أيّ هدف آخر، أو أنّ ثلّة نادرة من المبشّرين وفدوا لتبليغ النصرانية وتقديم المعونات للمسلمين باعتبارها ديانة حقّة بزعمهم، لكن هؤلاء القلائل من المستشرقين لا يمثّلون كلّ المشروع الاستعماري المتحدّث عنه، كي يقول قائل: إنّهم محقّقون وباحثون ينتمون إلى جهات علمية، لا هدف لها سوى التتبّع في تراث العالم الثالث وأديانه العريقة كالإسلام. وكذلك
الحال بالنسبة للمبشّرين، إن كان فيهم من تلبّس بلباس التبشير لخدمة دينه عن صدق.
13 - الجمود والتحجّر.
إنّ العقل موهبة عظيمة تمنّن بها اللّه سبحانه وتعالى على عباده دون غيرهم من المخلوقات، وبذلك نالوا الكرامة الإلهية التي فضّلوا بها على الكثير من المخلوقات، كما هو مضمون الآية (70) من سورة الإسراء: (وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ اَلطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً)، أمّا في روايات النبي صلى الله عليه و آله وأحاديث آل بيته الكرام، وكذلك أقوال سائر روّاد الشريعة والفكر، فحدّث ولا حرج من النصوص والأقوال الدالّة على عظمة العقل وضرورة تفاعل المسلم مع قراراته والاستنجاد به في جميع المنعطفات الدينية والدنيوية. وهذا الأمر هو الذي دفع بأتباع أهل بيت النبوّة إلّا القلائل منهم أن يجعلوه عنصراً هامّاً من مصادر التشريع والتقنين في زمن غيبة النبي صلى الله عليه و آله والمعصومين عليهم السلام، أي: فيما إذا أوجد العقل يقيناً غير مشوب بالشكّ والظنّ والاستحسانات الذوقية لدى الفقيه المستنبط للحكم. وبذلك سهّلوا على أنفسهم وأتباعهم حلّ الكثير من المعضلات العلمية والعملية المسموح للفقيه الاجتهاد فيها. أمّا بالنسبة لسائر المذاهب الإسلامية فمنهم من فتح الباب على العقل لإبداء الرأي على مصراعيه، بحيث فوّض إليه أمر استنباط الأحكام الشرعية المبتنية على الظنّ والشكّ والقياس أو حتّى غيره أيضاً، ومنهم من أغلق هذا الباب على الفقيه المستنبط إغلاقاً تامّاً، بعدما اعتقد وصرّح بعدم قابلية العقل المحدود الضعيف لهذه المهمّة.
فجمود المتحجّرين على النصوص وعدم استعانتهم بالعقل الموهبة الإلهية العظمى كما كان سلعة مربحة بيد المستشرقين الغربيّين وبعض المأجورين من المسلمين حتّى الآن، حيث عمّموا جمود هذه الفئات القليلة على الإسلام والمسلمين، وافتروا عليهم بالتخلّف والرجعية، فلا ريب أنّهم سيستمرّون كذلك بافتراءاتهم النكراء تلك إذا لم يعالج روّاد الصحوة الإسلامية هذا الداء من أوساط المسلمين، فيزيلونهم عن الساحة وعن إبداء الرأي باسم الإسلام والمسلمين.
14 - الاختراق الثقافي.
المقصود منه: المكائد التثقيفية التي يقوم بها أعداء الإسلام في عصرنا الحاضر بغية النفوذ إلى كيان المسلمين والإشراف على ثقافتهم، وبالتالي خلق ثقافة جديدة باسم الإسلام تحقّق طموحات المستكبرين قبل كلّ شيء. لكن الأصل والمهمّ لدى المستكبرين في هذه العملية هو أن تنفّذ على يد المسلمين وعن طريق مساعي محسوبة على الإسلام إن أمكن. ذلك لكي يكون الاختراق المذكور أكثر تأثيراً على الشعوب الإسلامية، وأسرع نفوذاً في ثقافتهم الأصيلة واستبدالها بثقافة مستوردة مشوّهة. الاختراق الذي قد يتجلّى بصورة شتّى:
منها: الازدواجية الفكرية، وهي أخذ شيء من الإسلام وشيء آخر من التيّارات الوضعية المستوردة ثمّ دمجها، وأخيراً اعتبار ذلك هو الإسلام الأصيل المتفهّم لتطوّرات العصر الحاضر، الأمر الذي دعا البعض ممّن ينتسبون إلى الإسلام أن يقولوا برجعيته، وأنّه أتى بأحكام تناسب العصر الجاهلي الذي بعث فيه رسول اللّه صلى الله عليه و آله، أمّا عصرنا الحاضر المتطوّر فلا مجال للإسلام الرجعي فيه بتاتاً، وهذه العملية هي عين النفاق الذي تحدّث عنه القرآن في تبيين زيف المنافقين الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ثمّ يحسبونه أنّه من عند اللّه.
ومنها: تحقير الهوية الإسلامية، حيث اتّخذ رموز الاستكبار العالمي حقيقة تطوّرهم العلمي والتقني ذريعة للتنكيل بالإسلام والمسلمين وتحقير عقيدتهم التوحيدية التي اعتبروها متخلّفة ورجعية بزعمهم. وهو ما صدّقه الكثير من الجهلة والسذّج، وإن كانوا يتظاهرون بالثقافة والتحضّر.
ومنها: التقليد والتبعية العمياء للغرب في كلّ صغيرة وكبيرة.
ومنها: الدعوة إلى التجدّد والتحضّر، لكن بمفومهما الخاطئ والفارغ عن الحقيقة.
ومنها: هروب الكفاءات الإسلامية من بلدانهم، ولجوؤهم إلى غيرها من البلاد.
منها: استخدام مأجورين متظاهرين بالإسلام بغية تصدّيهم المناصب الثقافية
والتعليمية والتربوية وحتّى الدينية.
ومن الجدير بالذكر أنّ جميع ما تقدّم من بحث في هذا المصطلح قد خطّته يراعة الشيخ محمّد جواد البستاني، فلاحظ.