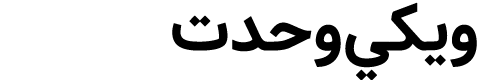السياسات التقريبية
السياسات التقريبية: هي مجموعة الإجراءات العملية في إطار تنفيذ استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية لدفع عجلة التقريب إلى الأمام، ومعرفة المعايير التي من المفروض الالتزام بها عند إجراء تلكم السياسات. وتتناول هذه المقالة هذا الموضوع الحيوي.
يمكن تلخيص وضع سياسات وبرامج استراتيجية ومرحلية مفيدة للتقريب بالنقاط التالية:
1 ـ إنّ من واجب كلّ الأطراف الإسلامية الحريصة على الوحدة، والتي تعي بقوّة وشفّافية معالم خطر الحروب المذهبية التي يصنعها ساسة الغرب بفعل سياساتهم اليومية وتواطؤ فئات من كلّ الاتّجاهات والمذاهب ـ وذلك سواء عن وعي أم غير وعي ـ مع هذه السياسات، إنّ من واجب هذه الأطراف أن تكشف بوضوح لكلّ القوى الرسمية والسياسية والشعبية النتائج التدميرية للفتنة المذهبية، وأن تتحرّك بقوّة نحو كلّ القوى المعنية بالشأن الإسلامي؛ لعمل كلّ ما من شأنه أن يلجم الفتنة ويمنع تداعياتها التي لن ينجو منها أحد، وحثّها على الأقلّ لعدم التوسّل بالعنوان المذهبي لخدمة سياسات ومصالح لا تخدم مصالح الوطن والأمّة. أمّا حالة التكفير فلا بدّ من إدانتها وفضحها بكلّ صراحة، ومن الإقلاع عن التغطية عليها لحسابات ضيّقة؛ لأنّ حسابات الأُمّة في وجودها ومصيرها وسلمها ومستقبلها أكبر من أيّة حسابات أُخرى، هذا عدا عن أيّة صورة مسيئة وخطيرة قدّمها منطق التكفير للإسلام في العالم.
2 ـ التحرّك بشكل خاصّ نحو الهيئات العلمائية والمرجعيات الدينية، وإقناعها بإصدار مواقف واضحة من أُولئك الذين يهشّمون الوحدة بين المسلمين ويضربون التفاعل في ما بينهم خوفاً منهم أو من الشارع العامّ، بما يكرّس سيطرة المتطرّفين على الأرض، بذريعة حماية المذهب من الفريق المقابل. وفي هذا الإطار لا بدّ لجميع الشخصيات العلمائية الكبرى وللمرجعيات الدينية من كلّ المذاهب أن تتّخذ مواقف فاعلة وفي وقت واحد من الأعمال والممارسات العصبوية والفئوية، حتّى لا يعتبر البعض أنّ إصداره لوحده الموقف أو الفتوى قد يشكّل قوّة للآخر المختلف معه، وبذلك تتمّ مواجهة الشارع العاطفي والملتهب مذهبياً، والذي بات يحمل «منطقاً» يمنع العقلاء من أنّ يتحرّكوا بحرّية. إنّ رفع الصوت بجرأة من كلّ العلماء لتصويب حركة الشارع وتوجيهه بالاتّجاه الصحيح بدلاً من الخضوع لمنطقه هو أمر ضروري وواجب ديني وأخلاقي وعلى كلّ المستويات، وبذلك أيضاً تستكمل المساعي الوحدوية.
3 ـ تحريك عناصر التقارب على مستوى المواقع الفاعلة في الأُمّة، بحيث لا تقتصر على المواقع العليا؛ وذلك لإيجاد واقع التقارب في برامج الحوزات الدينية، والمؤسّسات الإسلامية العلمية، وفي التوجيه في المساجد والتجمّعات العامّة، سواء أكانت أحزاباً أم جمعيات أم لجاناً.. وكم هو ضروري في هذا المجال إيجاد مواقع عمل مشتركة تساهم في انصهار المسلمين وتفاعلهم من أجل أن يتجسّد هذا التفاعل في التجمّعات الطلّابية أو العمّالية وفي النوادي الفكرية والثقافية، وفي مواجهة الظلم اللاحق بقضايا المسلمين الأساسية وبشخصياتهم وبرموزهم، فلا يقف كلّ في موقعه ويتحرّك من دون تنسيق مع الآخر.. ولا شكّ في أنّ التحرّك المشترك تجاه القضايا الإسلامية يساعد في إرساء مشاعره وحدوية وتعاطف بين المسلمين، لا سيّما إزاء قضايا تتّصل بالقدس والإساءات المتكرّرة للرسول (صلّى الله عليه وآله) والنيل من الإسلام كدين، وبذلك تتهيّأ عقول المسلمين ونفوسهم لتنظيم خلافاتهم الأُخرى والتقارب في ما بينهم.
4 ـ تفعيل المواقع الأساسية التي تتيح للمسلمين تعزيز ارتباطهم، من قبيل: فريضة الحجّ، والتجمّعات العلمائية الموجودة، والمؤتمرات والندوات الوحدوية، والمنظّمات الإسلامية الوحدوية، مثل: منظّمة المؤتمر الإسلامي ومؤسّسات التقريب، والتأكيد على المناخ التفاعلي بين كبار العلماء والمفكّرين وقادة الرأي، بحيث يتلاقون في إطار صحّي وبشكل دوري لتدارس قضاياهم الفقهية والفكرية والتاريخية والعقيدية بعيداً عن أجواء التوتّر والانفعال.
5 ـ السعي الحثيث للشخصيات التي تحمل الهمّ الوحدوي للإطلالة الدائمة على المؤسّسات الإعلامية، ولا سيّما الفضائية؛ لوضع الأُمور في نصابها، وذلك على حساب المؤجّجين للفتنة.
6 ـ اعتماد تربية إسلامية فاعلة تعمل على توجيه المجتمع بكلّ مواقعه على تقبّل الآخر، واحترام الاختلاف الموجود فيه، واعتباره مصدر غنى لا مصدر أزمة ومشكلة.. وفي هذا الإطار كم هو مهمّ إشاعة العناوين التوحيدية واعتماد كتاب ديني وحدوي يؤكّد الآراء المشتركة ويعرض الخلافات بحكمة وموضوعية.
7 ـ وضع ظاهرة التحوّل في الانتماء المذهبي عند بعض الأشخاص في حدودها، وهي حالة حدثت قديماً وراهناً في الاتّجاهين، وهي ظاهرة غير خطرة عندما تتمّ بوسائلها المشروعة وفي ظروف صحّية، أي: حين لا تنطلق من خطّة مدروسة تسيء إلى وحدة المسلمين وقوّتهم.
8 ـ النظر في جدّية إلى النتائج الوخيمة لتأجيج الخلاف المذهبي، والذي يبدو أنّه سيتحوّل إلى ذريعة لنفي الدين واستبداله بالعلمانية كحلّ لقضايا المجتمع! ولإبعاد الدين عن الساحة العامّة، وإسقاط موقع الإسلام ودوره في صنع المستقبل.
9 ـ نشر المعرفة وتعميم العلم، فلقد أعطى الإسلام لطلب العلم غاية الأهمّية: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) (سورة الزمر: 9)، وكفى أنّ الآية الأُولى التي أوحى الله بها على رسوله الأمين محمّد (صلّى الله عليه وآله) قد أمرته بالقراءة.. كونها مفتاح العلم والمعرفة، وهي مبدأ كلّ حركة إيجابية، وأردفتها بالقلم حيث الوسيلة لتقييد العلم وتطويره ونشره وتخليده: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَق * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) (سورة العلق: 1 ـ 5).
والإسلام لم يحصر نوعية العلم في مجال الدين فقط، بل أطلق مجالاته في رحاب المجالات كلّها، ما عدا علوم الإفساد والتدمير.
فالعلم في الإسلام داعيةُ خير ونضج وثبات للشخصية الموزونة، وعكسه الجهل، حيث يجعل صاحبه مُختلّ الموازين ومذبذب المواقف وجسراً إلى الشرّ والرذيلة، لذلك حاربه الإسلام وحذّر المسلمين منه.
فينبغي توسيع دائرة الفعل الثقافي، وترشيد المسلمين إلى قيمة الوعي والمطالعة، وتوفير كافّة مستلزمات القراءة والتعلّم، بدءاً من البصائر القرآنية وعلوم النبي وأهل البيت، مروراً بما ورد عن كبار الصحابة المنتجبين والعلماء الصالحين، وانتهاءً بكلّ أبواب العلوم الإنسانية وما تحتاجه البشرية في تقويم مسيرتها الحضارية.
10 ـ التربية الصالحة، فهي ليست علماً ومعلومات وتعليماً ونظريات فحسب، بل هي فنّ تفعيل العلم وتطبيق المعلومات وإيصال التعليم إلى مستوى الإنتاج والأثر المتحرّك، ولا يتحرّك الخير والمحبّة والتآلف والسلم الأهلي كمشروع على أرض الواقع ما لم تُزرَع في النفس البشرية حوافز إيمانية ودوافع إسنادية من الداخل.. وهذا ما تُناط به التربية المعنوية وتتكفّله التزكية الروحية وأهمّية الخلوة الفكرية حتّى يتحلّق صاحبها إلى آفاق الكون وفي أعماق الأنفس، فيكتشف كم للتعاون على البِرّ والتقوى من ضرورة وسعة مصاديق في الحياة!
والإنسان ينمو نحو العظمة بنموّه النفسي والروحي والمعنوي؛ إذ على قدر التزكية والنزاهة وملكة التقوى وقوّة النفس سيتّخذ قراراته الإيجابية بشجاعة ومثابرة، ويتجاوز العقبات أمام التقريب والوحدة، ويقوم بتضحية الجزء في سبيل مصلحة الكلّ حسب مدارج الأهمّ ثمّ المهمّ وقواعد التوافق العامّ. ولا يتأتّى اتّخاذ مثل هذه القراءات الصعبة والكبيرة إلّا بخلفية روحية مركزها النفس المطمئنة.
ولعلّ من أهمّ زوايا التربية في سياق التقريب بين الناس تلك المتّصلة منها بالعواطف الإنسانية، ومركزها النفس المشبّعة بقيم الحبّ للخير على وجه الإطلاق حتّى يُحصَر البغض في موارد قليلة وعلى ضبط أخلاقي موزون، فلا يُوجّه ضدّ كلّ مَن طرأ خلاف معه في الرأي أو العقيدة المبنية على دليل.
إنّ هذه النفس هي التي توجّه صاحبها نحو الاعتدال في الموقف من الآخر، ولا تتصادم بدوافع مرضية كما هي السائدة في أكثر الخلافات بين المسلمين.
وبذلك يجب تثبيت هذه الناحية التربوية (أي: تنمية العواطف) أساساً لبناء الشخصية الوحدوية ذات المرونة الصادقة؛ إذ لن يقف صاحبها حائلاً دون الوحدة بين المؤمنين ومانعاً للتقريب بين المسلمين، بل لن يقف ضدّ أيّ مشروع تعارفي تعاوني مع الإنسان الآخر لتعميق أواصر المحبّة الإنسانية ومدّ جسور لقاء الحضارات بين الشعوب.
11 ـ وجود الحكّام الصالحين، فباعتبار أنّ تأثيرات السلطة الحاكمة على وضع العباد وأوضاع البلاد قويّة ومباشرة وأثرها على الصلاح أو الفساد أمرٌ محسوم بلا نقاش، ترى الإسلام قد أولى اهتماماً كبيراً بمسألة الحكم والحاكم والحكومة.
فما هو نوع الحكم؟ هل حكم الله أو حكم الجاهلية؟! ومن يكون الحاكم، هل بصفات خليفة الله أو بصفات الجاهليّين؟! وكيف يجب أن تكون الحكومة، هل بسياسات مستقلّة أو بتبعية وذيلية؟!
الإجابة على هذه الأسئلة هي التي تحدّد مسار التقريب والوحدة أو مغارات التفريق والفتنة.
ويستمدّ بحث الولاية والإمامة والخلافة أهمّيته من أهمّية الإجابة على هذه الأسئلة المتقدّمة. وبالتالي فإنّ الإمامة الإبراهيمية تُمهّد للوحدة الإسلامية وتُمسك بزمام الأُمّة على طريق التعاون والتناصح والتعاضد لتحقيق العبادة التوحيدية لله الواحد الأحد الفرد الصمد.
وفي دراسة موضوعية تعتمد منهجيّة الحياد والإنصاف يمكن استنتاج النتيجة التالية: إنّ الحاكم بمقدار صلاحه وحكمته وعدله يبني صرح الوحدة ويشيّد بنيان الأخوّة، وهو بمقدار فساده وحُمقه وظلمه يهدم ويفرّق ويزرع بذور العداوة والبغضاء بين الناس.
12 ـ وجود العلماء الربّانيّين، فليس من شكٍّ أنّ العالَم الربّاني يقوم بدور أساسي في توحيد الكلمة بناءً على كلمة التوحيد: (لا إله إلّا الله).. تلك هي رسالته الأُولى والأخيرة مادام يجلس في موقع الوراثة لدور الأنبياء وخاتمهم سيّد المرسلين محمّد (صلّى الله عليه وآله).
والربّانية أدقّ صفة للعالم الذي يربّي الناس بأخلاق الربّ الغفور الرزّاق لكلّ العباد. فكونه عالماً يسير على نهج الأنبياء والرسل يُحمّله مسؤولية التقريب بين وجهات النظر لتسبيل الوحدة بين عباد الله، بمعنى تسهيل التعاون على البرّ والتقوى بينهم وتعطيل التعاون على الإثم والعدوان.
والعالم الربّاني هو الذي يُلزم نفسه بمواقف الإصلاح بين الآخرين ويُجنّبها عن الصِدام بهم، ويرى ممارسة هذه الأخلاقية الاجتماعية واجباً شرعياً وليس خياراً استحبابيّاً يمكنه الاستغناء عنه متى شاء وأراد.
وبناءً عليه إذا كان الإصلاح والتقريب صدقة يُحبّها الله تعالى لعموم الأُمّة، فإنّها لخصوص العلماء الربّانيّين تعلو إلى درجة المسؤولية التي لا تتجزّأ عن بقيّة مسؤولياتهم الشرعية.
فالعالم قد وضع نفسه في موقع لا مفرّ له من إيفاء دور التقريب والسعي في سبيل الوحدة وكسب القوّة للأُمّة على شتّى الميادين، فكلّ فكرة وكلّ كلمة وكلّ خطوة يكون مسؤولاً عنها يوم القيامة إنْ لم تتّجه نحو بناء الوحدة القائمة على أُسس المحبّة والأُخوّة والتسامح والتلاحم لحمل أمانة الإسلام العظيمة كما حملها النبي الأكرم وأهل بيته الطاهرون والصحابة الأوفياء والتابعون لهم بإحسان على مرّ العصور.
13 ـ التمتّع بالروح الجماعية، فهي البدلة عن النزعة الأحادية التي نبذها الإسلام لينمّي في الإنسان روح العمل الجماعي؛ لأنّه دين أُمّة، وليس دين فرد أو جماعة وأُسرة.
إنّ نظرة فاحصة على المنظومة الفكرية والأحكام الشرعية للإسلام تُثبت القيمة العالية للمشاريع الجماعية.. فالخطاب القرآني خطاب الجمع، والدعوة إلى الحقّ موجّهة إلى الجماعة، وحتّى العبادات تختزن الأهداف الجمعية، فمن صلاة الجماعة وفضلها على صلاة الفرادى، إلى مناسك الحجّ وفعاليّات هذا المؤتمر الجماهيري السنوي العامّ، إلى أجر الآداب الاجتماعية وثواب التزاور والتهادي والتعاون بين الناس، إلى بركات السير في الأرض والسفر للتعارف بين الشعوب والقبائل.. كلّ ذلك تمهيداً للأنشطة الجماعية المشتركة، مضافاً إلى تأكيد الإسلام على نشر السلام بين الأنام، ممّا يستلزم بناء الذات على أُسس القبول بالآخر والتعاطي معه بروح جماعية وحُبّ الخير للإنسان إلى درجة الإيثار.
14 ـ تعزيز عملية الإنفاق، فهي سبيل البرّ والأُخوّة، ولن تنال أُمّة برّاً في حياتها ما لم ينفق أغنياؤها وأثرياؤها ممّا رزقهم الله في سبيل وحدتها وقوّتها ورفعتها ودوام عزّها وبقاء مجدها وكرامة أجيالها وتماسكها على خطّ الأُخوّة، حيث الأبناء يتأثّرون بمواقف آبائهم بطريقة وبأُخرى خيراً أو شرّاً.
ولا أحد ينكر أنّ المال يشكّل قوّةً أساسية في تشييد المشاريع الكبرى على طريق التقريب والوحدة لأجزاء المجتمع وتقدّم الأُمم، وعلى نفس القياس يُشكّل المال خطراً على التقريب والوحدة وسبباً لتخلّف الأُمّم.. والاتّجاهان كلاهما تصنعهما ثقافة البرّ وإرادة الأُخوّة أو ثقافة الفسق وإرادة العداوة.
15 ـ مقاومة الأطماع الأجنبية، وهي ليست بالأمر الهيّن، ولكنّها أمرٌ ممكن. ويتمّ ذلك: بالعودة إلى شروط الإمكان من حيث البناء الفكري والتنوير الثقافي، وتكثيف الأعمالية العلمية والدراساتية، ونشر مراكز الأبحاث والمعرفة، وتأسيس المكتبات العامّة للمطالعة. وكذلك من حيث الدروس التربوية المركّزة أخلاقياً لتقويم السلوك الفردي والأُسري والاجتماعي. وكذلك من حيث التعاقد في المشتركات وتكريس مفاهيم العطاء والإيثار والحبّ للغير كما الحبّ للنفس. وأيضاً من حيث توظيف الإمكانات الحكومية واهتمام العلماء بتحقيق الأهداف السامية للأُمّة الإسلامية.
عند هذه الشروط تستعيد الوحدة روحها ومصداقيتها، حتّى يستسلم الاستعمار ويقرّ للأُمّة حقوقها، فيعلن الخروج من الباب على أن لا يعود من الشبّاك!
فليست الأطماع الاقتصادية، ولا الإملاءات السياسية، ولا التواجد العسكري للدول الاستعمارية الكبرى في بلادنا اليوم وبشكلها السافر، إلّا لأنّنا نفتقد شروط الاستقلال والحرّية ومعاني الأُخوّة وما تحتاجه الوحدة من مسلتزمات حقيقية خارجة عن نطاق المجاملات والشعارات.
المصدر
موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح 1: 80.
موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح\تأليف: محمّد جاسم الساعدي\نشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية-طهران\الطبعة الأولى-2010م.