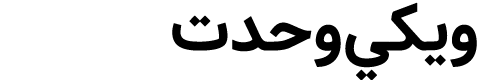مناشئ الاختلاف في فهم السنّة
مناشئ الاختلاف في فهم السنّة هي جذور الاختلاف في فهم السنّة الشريفة. ويمكن ملاحظتها فيما يلي:
مناشئ الاختلاف في فهم السنّة
1 - الاختلاف في مصادر السنّة.
لم يكن الاختلاف في رواية السنّة ودرايتها متأخّراً أو وليد العصور الحديثة، بل كان منذ وفاة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله موجوداً بين الصحابة، وقد نقلت كتب الحديث والسيرة والتاريخ قضايا كثيرة اختلف فيها الصحابة فيما بينهم، إمّا في الرواية وصدور الحديث عن الرسول صلى الله عليه و آله، أو في فهم الأحاديث ودراية معانيها ودلالاتها، وكان هذا الاختلاف سبباً لتأمّل العلماء والدارسين في حجّية ما ينقل عنهم، وهل أن ما يروى عنهم سنّة أم رأي؟ وهل ما ينسب إليهم ينسب إلى الرسول صلى الله عليه و آله أو يتوقّف فيه عليهم؟
وكانت هذه النقاط مدار بحث وجدل بين الأُصوليّين والمحدّثين عبر التاريخ:
فقه اختلفوا أوّلاً في مسمّى الصحابي، ومن هو، فهل أنّ الصحابي هو مطلق من رأي النبي صلى الله عليه و آله ولو لساعة من نهار؟ أو أنّ الصحابي هو من رآه صلى الله عليه و آله واختصّ به اختصاص المصحوب وطالت مدّة صحبته؟ وهل الأخير هو من أخذ العلم عنه؟ أم أنّه كلّ من صحبه وإن لم يرو عنه؟
واختلفوا أيضاً في مدّة الصحبة ونوعها، فبين موسّع لتشمل الصحبة كلّ من رأى الرسول صلى الله عليه و آله مؤمناً كان أم منافقاً، وبين مضيّق للمسمّى وحصره لمن صحبه زمناً معيّناً كسنة أو سنتين أو غزا غزوة معه.
وكما اختلف في مسمّى الصحابي، اختلف أيضاً في عدالته، وبالتالي إطلاق العدالة على سائر الصحابة، من دون تمييز وتحقيق.
واختلف أيضاً في ما ينسب إليهم من آراء وتفسير وفتاوى، هل هو يعبّر عن رأي الرسول صلى الله عليه و آله، فيؤخذ به، وذلك لأنّهم راوه وشاهدوه عن قرب، وبالتالي فما قالوا به كان عن حسّ ومشاهدة، وهو رأي ذهب إليه جملة من العلماء، كالحاكم في تفسيره والسيوطي والزركشي، وفي مقابل ذلك نجد رأياً آخر، تبنّاه فريق آخر من العلماء ومال إليه المتأخّرون، وهو أنّ ما يروى عنهم يعبّر عن رأيهم ونظرهم واستنباطهم، وليس من
الضرورة أن يكون ذلك قول رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله أو رأيه.
وإذا كان ما رواه الصحابي هو رأيه ونظره واجتهاده، فهل رأيه حجّة يجوز العمل به، أو أنّه مجرّد رأي قابل للخطأ والصواب، فيجب التأكّد من صحّته وسقمه؟
لذا لم يكن هذا القول على إطلاقه هو الراجح المعتمد والمستقرّ عند جمهور العلماء من الأُصوليّين والفقهاء الذين فصّلوا فيما يصدر عن الصحابة والتابعين من مأثورات، بين ما هو صادر عنها للنبي صلى الله عليه و آله، وما هو صادر عن آرائهم الذاتية واجتهادهم الخاصّ، وهذا مقول أيضاً في علماء الأُمّة من بعدهم من التابعين وتابعيهم من باب أولى. فجمهور العلماء على أنّ رأي الصحابي ليس بحجّة من متأخّري الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة.
2 - الاختلاف في رواية السنّة ودرايتها.
وإذا ما انتقلنا بالبحث إلى سنّة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله، فإنّنا سنواجه موارد خلافية تتعلّق بأسانيد الأحاديث ومتونها، وفي ذلك يقول النووي في شرح خطبة مسلم صاحب الصحيح: «المراد من علم الحديث: تحقيق معاني المتون وتحقيق علم الإسناد والمعلّل، والعلّة عبارة عن معنى في الحديث خفي يقتضي ضعف الحديث مع أنّ ظاهره السلامة منها، وتكون العلّة تارةً في المتن، وتارةً في الإسناد. وليس المراد من هذا العلم مجرّد السماع ولا الإسماع ولا الكتابة، بل الاعتناء بتحقيقه، والبحث عن خفي معاني المتون والأسانيد، والفكر في ذلك، ودوام الاعتناء به، ومراجعة أهل المعرفة، ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه».
وقد اتّسعت علوم الحديث، حتّى قيل: إنّها تبلغ المئة، وهي تتوزّع على قسمين: علوم السند، والتي تتركّز على دراسة طريق الحديث وأحوال رواته من حيث التوثيق والإسناد، والنسبة إلى الرسول صلى الله عليه و آله أو غيره، وعلوم المتن من حيث دراسة المعنى وشذوذه وإنكاره وعلله واضطرابه.
ومع أنّ الأُمّة مجتمعة على مبدأ التمسّك بالسنّة النبوية، إلّاأنّ هناك مسائل تفصيلية
متعلّقة بها قد اختلف فيها، ومن أهمّها مسألة توثيق الرواة، وبالتالي تصحيح السند.
وإذا ما غضضنا النظر عن مسألة الاختلاف في مسمّى الصحابي وعدالته، ممّا يوجد مفصّلاً في كتب الأُصوليّين والمحدّثين، فإنّ كتب الجرح والتعديل اختلفت في توثيق الرواة من بعدهم، وقد تجد في الرجل الواحد آراء مختلفة، يوثّقه بعض، ويضعّفه آخرون.
وقد يختلف أيضاً في فهم متون الأحاديث، من حيث دلالتها، وعمومها وخصوصها، وإطلاقها وتقييدها، وإحكامها ونسخها، وغير ذلك من مباحث السنّة.
3 - تسلّل الإسرائيليّات إلى كتب الرواية والتفسير.
ثمّة حقيقة ثابتة تاريخية تواجهنا على مستوى تراثنا الديني، وخصوصاً المروي منه، وهي دخول الإسرائيليات إلى الفكر الإسلامي، وكثرة الأحاديث الموضوعة «المختلقة»، والتي يتعارض الكثير منها مع أُصول العقيدة، والتي أخذت طريقها إلى كتب التفسير والحديث والسيرة؛ لأسباب كثيرة، كان منها: عدم التدقيق في مناقشة متون الأحاديث، والتركيز على دراسة السند فقط، وربّما حتّى التساهل في قبول الأحاديث في غير الأحكام الشرعية، تحت عنوان «التسامح في أدلّة السنن»، فقد تسلّلت إلى كتب التفسير والحديث أساطير قديمة والكثير من الانحرافات والأباطيل، ولأنّ غالب ما يروى منها يرجع في أصله إلى مصدر يهودي فقد أطلق عليها علماء التفسير والحديث لفظ (الإسرائيليّات)، من باب التغليب للّون اليهودي على غيره، حيث كان اليهود أشدّ أهل الكتاب صلة بالمسلمين وثقافتهم كانت أوسع من ثقافات غيرهم.
وقد أُطلق لفظ الإسرائيليّات بالخصوص على ما نقل عن النصارى الذين دخلوا الإسلام، ككعب الأحبار وتميم الداري وابن جريج وغيرهم؛ لأنّهم كانوا يرجعون في أكثر ذلك إلى كتب بني إسرائيل، وأسفار الأنبياء منها على وجه الخصوص.
وقد شكّلت الإسرائيليّات قسماً معتدّاً به من الروايات التفسيرية، حتّى عدّها بعض الباحثين المصدر الرابع من مصادر الصحابة في التفسير بالمأثور، وأخذت هذه
الإسرائيليّات طريقها إلى معظم كتب التفسير، متسلّلة من بعضها إلى البعض الآخر.
ونجد الكثير من هذه الروايات قد تسلّلت إلى كتب الحديث فضلاً عن التفسير، وكانت هذه الروايات المستند في بعض الآراء، وكلّ ذلك يدعو إلى ضرورة تعميق دراسات متون الحديث دراسة تفحّص وتحقيق وتدقيق، دون الاعتماد السطحي على ما ينقل، أو التداول المتساهل والمتسرّع لكلّ ما يروى.
4 - آثار حركة الوضع.
وفي اتّجاه آخر نجد حركة الوضع في الحديث، ويقصد بالوضع: اختلاق الحديث ونسبته إلى الرسول صلى الله عليه و آله أو غيره، والتي قد تعود بداياتها إلى عهد الرسول صلى الله عليه و آله.
فإنّنا نجد نصّاً عن الإمام علي عليه السلام يشير بوضوح إلى ذلك، إذ يقول: «إنّ في أيدي الناس حقّاً وباطلاً، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعامّاً وخاصّاً، ومحكماً ومتشابهاً، وحفظاً ووهماً. ولقد كذب على رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله على عهده حتّى قام خطيباً، فقال: من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار».
وقد اتّسعت حركة الوضع لأسباب سياسية ومذهبية، فوضعت كلّ فرقة أحاديث في نصرة مذهبها، أو في ذمّ الفرق المناوئة.
ثمّ ظهرت طائفة أُخرى تضع الحديث «تعبّداً» و «تقرّباً» إلى اللّٰه بحسب ظنّهم! فقد ذهب بعض المتصوّفة إلى جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب، ترغيباً للناس في الطاعة وزجراً لهم عن المعصية! وانتشر وضع الحديث عند هؤلاء وأمثالهم، حتّى روي عن عبيد اللّٰه النوازيري، قال: «سمعت يحيى بن سعيد القطّان يقول: ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير والزهد».
ودخلت الزندقة حركة الوضع، والزنادقة يراد بهم الذين قصدوا إفساد الشريعة وإيقاع الشكّ في قلوب العوام والتلاعب بالدين.
وقد كان في هؤلاء الزنادقة من يأخذ من شيخ مغفّل كتابه، فيدسّ في كتابه ما ليس من حديثه، فيرويه ذلك الشيخ ظنّاً منه أنّ ذلك من حديثه.
ودخل سوق الوضع القصّاصون الذين وضعوا الأحاديث والأخبار والقصص لأسباب سياسية، أو لأسباب معيشية لاجتذاب العامّة.
وتطوّر الأمر في القرن الثاني؛ إذ انتشر القصّاصون، وكان همّ أحدهم أن يجيء بالغرائب ويكثر من الرقائق، وإذا كان بعض القصّاصين من أهل العلم والحديث، فإنّ الأمر انتهى في القرن الثالث إلى أنّ اسم القاصّ أصبح لقباً عامّياً مبتذلاً، وأكثر المتصدّرين في الوعظ إنّما يكونون من أهل الحديث والمتّسعين في العلوم، ولا حاجة إلى الكلام عنهم، ولم يزد المتصوّفة في الأخبار إلّاما يزعمون أنّهم احتووه بعلم خاصّ، واللّٰه أعلم بغيبه.
ومن هذا الطريق دخلت كثير من الموضوعات، خصوصاً في السيرة وقصص الأنبياء والمعاجز والفضائل، فامتلأت الكتب بالأساطير، وتناقلوها واحداً عن واحد، حتّى غدت عند الكثيرين من المسلّمات.
وكلّ هذه الأسباب أدّت إلى الاختلاف في قبول الروايات والاعتماد عليها، وبالتالي الاختلاف في الآراء والأفكار المشتقّة منها، وكذلك بعض الأحكام المستنبطة منها.