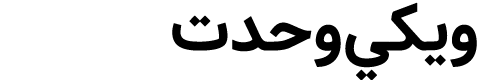مقوّمات الوحدة الإسلامية
مقوّمات الوحدة الإسلامية هي الركائز الأساسية والقواعد الراسخة والأُصول الثابتة التي ترتكز عليها الوحدة الإسلامية. ولهذه المقوّمات أبعاد مختلفة يمكن توضيحها فيما يلي:
مقوّمات الوحدة الإسلامية
=== أوّلاً: البعد الديني. ===
يمثّل البعد الديني أهمّ عناصر وحدة الأُمّة الإسلامية، فالدين هو الركيزة الأساسية التي تبتني عليها بقية العناصر، فوحدة الأُمّة الإسلامية تمثّل بناء متكاملاً له أساس ثابت راسخ الأركان يحمل البناء كلّه، ألا وهو الدين، أو هي كالشجرة لها جذور ضاربة في الأرض وبدونها لا يكون للشجرة كيان ولا حتّى وجود، ومن هذه الجذور تمتدّ الساق والفروع والأغصان.
ويتمثّل البعد الديني في العقيدة الواحدة بإله واحد ونبي واحد وكتاب واحد وعبادة واحدة. فالجميع يتّجهون في صلاتهم في مواعيد محدّدة إلى اللّٰه نحو قبلة واحدة أينما كانوا في أيّ مكان من العالم، ويجمع بينهم الصيام في شهر معيّن، ويجمع الحجّ بينهم من كلّ الأجناس والأقطار طائفين حول كعبة واحدة في حرم اللّٰه الآمن تنجذب إليها أفئدتهم من كلّ فجّ عميق: (لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ) (سورة الحجّ: 28)، وهذا التجمّع الكبير في الحجّ يعدّ رمزاً حيّاً لوحدة الأُمّة الإسلامية كلّها، فهؤلاء ممثّلوها من كلّ مكان يجمعهم هدف واحد، ويربط بين قلوبهم رباط واحد، يجعل منهم جميعاً أُخوة متحابين متآلفين بأمر اللّٰه.
ويعبّر القرآن الكريم عن هذا المعنى الإيماني بقوله تعالى: (وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللّٰهِ جَمِيعاً وَ لاٰ تَفَرَّقُوا) (سورة آل عمران: 103)، وهذه الوحدة الروحية من شأنها أن تقضي على كلّ ما يعكّر صفو الأُمّة أو يعمل على تقطيع أوصالها، فمادام الربّ واحداً والدين واحداً فلا مجال للتناقض في أُمور الدين.
والاعتصام بحبل اللّٰه ليس مجرّد شعار يرفعه المسلمون، وإنّما له متطلّبات لا يتحقّق بدونها، ولا يقع عند اللّٰه موقع القبول إلّاإذا تحقّقت وقام المعتصمون بتبعاتها على الوجه الذي رسمه اللّٰه في كتابه طريقاً لكمال الإنسانية ورقيها، فهو يقضي بتنحية الشهوات والأهواء التي تثيرها العصبيات القبلية والعرقية والمذهبية، ويقضي بالنظر السريع في تنقية العقائد والعبادات وسائر التعاليم الإلهية ممّا يشوبها ويكدّر صفوها من صور الشرك
والابتداع الذي هيّأ لخصوم الإسلام أن يقولوا بتعدّدية الإسلام ويزعموا أنّ الإسلام ليس ديناً واحداً وإنّما هو أديان متعدّدة تختلف باختلاف الأقاليم والمذاهب: (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوٰاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاّٰ كَذِباً) (سورة الكهف: 5).
ثانياً: البعد الإنساني.
ويتّضح البعد الإنساني لوحدة الأُمّة الإسلامية جلياً في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهّرة، فاللّٰه سبحانه وتعالى يلفت نظرنا إلى وحدة الأصل الإنساني. فالناس جميعاً قد خلقهم اللّٰه من نفس واحدة: (يٰا أَيُّهَا اَلنّٰاسُ اِتَّقُوا رَبَّكُمُ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وٰاحِدَةٍ) (سورة النساء: 1)، ورسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يؤكّد هذا المعنى أيضاً في قوله: «يا أيّها الناس، ألا إنّ ربّكم واحد وأباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلّابالتقوى».
والإسلام لا يفصل هذا البعد الإنساني عن البعد الديني المشار إليه كما كانت تفعل - ولاتزال - بعض الآيديولوجيات والفلسفات في القديم والحديث التي تصل بالإنسان إلى حدّ التأليه وتجعله صاحب السلطان الأوحد في هذا الكون!
ويبيّن لنا القرآن الكريم أنّ الإنسان الذي ينكر أصله أو يجحد خالقه هو إنسان يعمل ضدّ طبيعته وفطرته التي فطره اللّٰه عليها. فاللّٰه سبحانه قد أخذ عليه ميثاقاً لا يجوز له أن يتجاهله أو يغفل عنه؛ لأنّه مركوز في أصل فطرته.
وفي ذلك يقول القرآن الكريم: (وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ شَهِدْنٰا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ إِنّٰا كُنّٰا عَنْ هٰذٰا غٰافِلِينَ) (سورة الأعراف: 172). ومن بين القلائل من فلاسفة الغرب الذين أكّدوا هذا المعنى كان الفيلسوف الفرنسي «ديكارت» الذي قال: «والحقّ أنّه لا ينبغي أن نعجب من أنّ اللّٰه حين خلقني غرس فيّ هذه الفكرة - أي: فكرة وجود اللّٰه - لكي تكون علامة للصانع مطبوعة على صنعته».
وهذا الارتباط الوثيق بين كلّ من البعد الديني والبعد الإنساني في وحدة الأُمّة الإسلامية له دلالة هامّة؛ إذ يعني أنّ هذه الأُمّة التي أراد اللّٰه لها أن تكون خير أُمّة أُخرجت
للناس من شأنها أن تكون عنصر أمان واستقرار في هذا العالم، فهي أُمّة ترتبط بخالقها بعلاقة العبودية له سبحانه، وترتبط بغيرها من بني البشر بعلاقة الإنسانية التي لا تنسى عبوديتها لخالق الكون كلّه.
وهذه الصلة الوثيقة باللّٰه إذا استقامت فإنّها كفيلة بتصحيح مسار الأُمّة الإسلامية في هذا الوجود، وبذلك تتحقّق خيريتها، إنّها أُمّة تسع الإنسان أينما كان وأنّى كان، وتشمل برعايتها وأمنها كلّ من يعيش على أرضها.
ثالثاً: البعد الاجتماعي.
وإذا كانت الأُمّة الإسلامية ترتبط فيما بينها بروابط العقيدة والإنسانية فإنّ محصّلة هذين البعدين هي الأُخوّة التي هي أقوى من أُخوّة النسب. ومن هنا كان قول القرآن الكريم: (إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (سورة الحجرات: 10). وعندما أراد النبي صلى الله عليه و آله أن يؤسّس قواعد المجتمع الإسلامي في المدينة بعد الهجرة آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فتآلفت قلوبهم بفضل اللّٰه، وقد امتنّ اللّٰه على المؤمنين بهذا التآلف، فقال: (فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوٰاناً) (سورة آل عمران: 103). وهذه الأُخوّة لها حقّها، فهي تتضمّن بعداً عاطفياً يتمثّل في المشاركة الوجدانية، فكلّ فرد من أفراد الأُمّة الإسلامية يشعر بآلام وآمال أُمّته؛ لأنّه جزء منها يحسّ بإحساسها ويسعد لسعادتها ويتألّم لألمها. ومن هنا كان قول النبي صلى الله عليه و آله: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى».
ولكن مجرّد المشاركة الوجدانية - وذلك مع أهمّيتها - لا تكفي، ولا بدّ أن يترجم هذا الشعور الداخلي إلى عمل فعّال يكون من شأنه النهوض بالأُمّة وبأفرادها. ومن هنا كان مبدأ التكافل في الإسلام بمثابة ترجمة عملية لذلك الشعور الباطني لدى المسلم. وقد جعل الإسلام هذا المبدأ عبادة مفروضة يتعبّد بها المسلم ويتقرّب بها إلى ربّه، وهي فريضة الزكاة.
وقد آن الأوان ليخرج المسلمون من دائرة المشاركة الوجدانية السلبية إلى المشاركة
الإيجابية المؤثّرة، وذلك بوضع الخطط المفصّلة لإقامة بنيان التكافل بين أبناء الأُمّة الإسلامية. وقد آن الأوان للأُمم الإسلامية أن تنصهر في بوتقة الوحدة الحقيقية للأُمّة الإسلامية بتحقيق مبدأ التكافل والخروج من سجن الفرديات المنعزلة والقوميات المنفصلة إلى محيط الجماعة الكبرى التي أرادها اللّٰه أن تكون خير أُمّة أُخرجت للناس، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن باللّٰه، وتقيم التعاون فيما بينها على البرّ والتقوى، لا على الإثم والعدوان.
رابعاً: البعد الجغرافي.
لقد جعل اللّٰه للأُمّة الإسلامية من وضعها الجغرافي الذي تتميّز به في هذا العالم وحدة طبيعية جامعة في رقعة مترامية الأطراف في كلّ من قارتي آسيا وأفريقيا، فضلاً عن أنّها تمتدّ إلى بعض أجزاء من أُوروبّا. ومن المعروف أنّ الإسلام قد انتشر في جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا بقوّته الذاتية دون أن يدخل إلى هذه البلاد جيش مسلم لفتحها.
ومن نعم اللّٰه على المسلمين أنّ هذه المناطق المترامية الأطراف الملتحمة الأجزاء - والتي تشكّل بلاد العالم الإسلامي - تشتمل على الكثير من المعادن والكنوز النفطية وغير النفطية التي لو أُحسن استغلالها لجعلت من العالم الإسلامي قوّة يحسب لها ألف حساب.
وفضلاً عن هذه الكنوز في باطن الأرض توجد هناك في العالم الإسلامي مناطق شاسعة يمكن استصلاحها بمجهودات قليلة وزراعتها بشتّى المحاصيل لتكون سلّة غذاء للعالم الإسلامي كلّه. وبذلك يتحقّق للمسلمين الاكتفاء الذاتي في غذائهم، الأمر الذي يساعدهم على استقلاليتهم في إرادتهم وفي قراراتهم، فمن المعروف أنّ من لا يملك غذاءه لا يملك قراره.
وهذه الوحدة الجغرافية من شأنها أن تمحو بين أقطار العالم الإسلامي تلك الحواجز الإقليمية المصطنعة في قضايا الاقتصاد والإنتاج.
خامساً: البعد الحضاري.
الإسلام ليس دين طقوس تعبّدية جامدة، إنّه دين للحياة بكلّ أبعادها. والأُمّة
الإسلامية أُمّة أراد اللّٰه لها أن تكون صاحبة رسالة دينية وحضارية في هذا العالم، ومن هنا كان وصفها بأنّها خير أُمّة أُخرجت للناس.
وقد رسم القرآن الكريم للإنسان الإطار العامّ في كلّ أُموره الدينية والدنيوية، واستخلف اللّٰه الإنسان في الأرض، وكلّفه بعمارتها وصنع الحضارة فيها، ووعد المؤمنين العاملين بالتمكين لهم في الأرض، وكتب لهم العزّة والنصر. وتحقيق ذلك كلّه أمر منوط بالإنسان وبتأييد من اللّٰه تعالى.
وقد أدرك المسلمون الأوائل ذلك كلّه، وعملوا على تحقيقه، وقد تحقّق لهم بالفعل ما أرادوا وما أراده اللّٰه منهم. وبذلك أقاموا صرحاً شامخاً لحضارة عريقة كانت من أطول الحضارات عمراً في التاريخ. وقد اشترك علماء الأُمّة الإسلامية من كلّ جنس ولون في إقامة هذا الصرح الحضاري بدافع من الإسلام الذي رفع من شأن العلم والعلماء واعتبر مداد العلماء مساوياً لدماء الشهداء أو أفضل، وجعل العلماء أخشى الناس للّٰهتعالى.
وسارت جهود علماء المسلمين في مجالات العلوم الدينية والدنيوية جنباً إلى جنب في تكامل رائع، فقد أدركوا أنّ الحضارة تعني تقدّماً مادّياً وروحياً وأخلاقياً، وبذلك قدّموا للإنسانية خدمة كبرى في الوقت الذي كان فيه العالم غير الإسلامي لايزال يعيش في جهالة جهلاء. وترك لنا الأسلاف تراثاً ضخماً يعدّ أغنى تراث في العالم يعبّر عن وحدة جهود علماء الأُمّة الإسلامية بصورة رائعة، ويشترك المسلمون اليوم في كلّ مكان في العالم الإسلامي في الاعتزاز بهذا التراث.
وقد آن الأوان للأُمّة الإسلامية أن تتوحّد جهودها مرّة أُخرى في سبيل النهوض بالأُمّة والارتقاء بها حضارياً بما يؤكّد شخصيتها المتميّزة ويحافظ على ذاتيتها مسترشدة في ذلك بتعاليم الإسلام الشاملة وبالجوانب الإيجابية المشرقة في تراثنا.
فلا يليق بالأُمّة الإسلامية أن تظلّ في عالمنا المعاصر قابعة في مقاعد المتفرّجين الذين لا يشاركون في صنع الحضارة، ويكتفون بدور المستهلك لما تنتجه الحضارة التي يصنعها غيرنا، في الوقت الذي لا تعرف البشرية فيه ديناً آخر غير الإسلام يشتمل على كلّ
المقوّمات والأُسس التي تحقّق للبشرية أفضل المستويات الحضارية مادّياً وروحياً وأخلاقياً.
والرسالة الدينية الحضارية المنوطة بالأُمّة الإسلامية لا يمكن تأديتها والقيام بحقّها إلّا إذا توحّدت جهود الأُمّة دينياً وفكرياً وحضارياً. وواجبها يفرض عليها في هذا الصدد أن تقدّم للعالم هذه الرسالة الدينية الحضارية في صورة أُنموذج متحقّق في عالم الواقع، فليس بالأقوال تؤدّى الرسالات الكبرى، ولكن بترجمة الأقوال إلى برامج عمل. ومن هنا جاء اللوم والمقت في القرآن الكريم للمؤمنين الذين يقولون ما لا يفعلون: (يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اَللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ) (سورة الصفّ: 2-3).
سادساً: البعد المصيري.
وإذا كانت الأُمّة الإسلامية ترتبط فيما بينها برباط ديني واحد وتجمعها وحدة جغرافية طبيعية ولها رسالة نورانية حضارية في هذا الوجود؛ فإنّ ذلك يعني أنّ لها غايات واحدة وأهدافاً مشتركة، ويعني في النهاية أنّ لها مصيراً واحداً.
ومن أجل حماية هذا المصير الواحد وصوناً للمبادئ السامية والمثل العليا التي تقوم بها ومن أجلها الأُمّة الإسلامية فلا بدّ من إعداد القوّة اللازمة لدرء الأخطار التي تحيط بها، سواء كانت هذه الأخطار قائمة بالفعل أو محتملة الوقوع، أي: سواء كانت منظورة أم غير منظورة، فالقوّة في كلا الحالين ضرورية. وفي هذا الصدد يقول القرآن الكريم: (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ اَلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اَللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاٰ تَعْلَمُونَهُمُ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ) (سورة الأنفال: 60).
والهدف الذي من أجله يدعو القرآن الكريم إلى هذا الاستعداد الحربي بكلّ ما أُوتينا من قوّة لا يرمي إلى التخريب والتدمير أو الاستعباد والاستعمار أو سلب الآخرين أموالهم وأوطانهم وأمنهم، وإنّما يرمي إلى دفع شرّ الأعداء وردعهم وتخليص المستضعفين من أيدي الظالمين المعتدين، وإفساح الطريق أمام دعوة الخير الذي يريده اللّٰه لعباده. وقيام هذه القوّة يعدّ من أقوى وسائل السلم الذي أمر اللّٰه به، فهي قوّة تحمي السلم والأمان والاستقرار.
ومثل هذه القوّة لا تتأتّى إلّابوحدة الأُمّة الإسلامية، فهذه الوحدة هي السدّ المنيع والحصن الحصين في وجه كلّ الأطماع التي تستهدف إضعاف الأُمّة الإسلامية وإثارة الفتن والخصومات بين أبنائها.
وعلى الأُمّة الإسلامية صاحبة المصير المشترك أن تعيد النظر في قائمة الأولويات للقضايا والهموم التي تحيط بها في عالمنا المعاصر، فتشغل نفسها لا بالقضايا الهامشية، بل بالقضايا المصيرية، وعلى رأسها قضية التخلّف التي تمثّل الهمّ الأكبر للأُمّة الإسلامية اليوم. والتخلّف المعني هنا تخلّف متعدّد الجوانب يشمل المجالات الروحية والمادّية والأخلاقية والعلمية والحضارية بصفة عامّة، وتلك قضية مصيرية لا يجوز التهاون فيها أو التفريط في معالجتها بما تستحقّه من اهتمام وعناية.
هذا، ويمكن تقرير مقومّات الوحدة الإسلامية بهذه الصورة أيضاً:
1 - وجود الأرض.
فالأرض مستقرّ الإسلام، وهي الدار التي يأوي إليها المؤمنون، وعليها تقوم دولة الإسلام، ومنها تنطلق دعوته: (وَ اَلَّذِينَ تَبَوَّؤُا اَلدّٰارَ وَ اَلْإِيمٰانَ مِنْ قَبْلِهِمْ) (سورة الحشر: 9).
ولا بدّ أن تكون هذه الأرض خاضعة لحكم الإسلام وسيطرة أهله؛ مصداقاً لقوله عزّ وجلّ: (وَعَدَ اَللّٰهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اَلْأَرْضِ كَمَا اِسْتَخْلَفَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اَلَّذِي اِرْتَضىٰ لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً) (سورة النور: 55)، ويقول النبي صلى الله عليه و آله: «بشّر هذه الأُمّة بالسناء والرفعة بالدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب».
وأن تكون آمنة منيعة محمية الحدود والثغور، كما أمر بذلك ربّ العباد، فقال: (يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِصْبِرُوا وَ صٰابِرُوا وَ رٰابِطُوا) (سورة آل عمران: 200)، ويقول النبي صلى الله عليه و آله:
«رباط يوم خير من صيام شهر أو قيامه». إنّ الأرض الموصوفة بهذه الصفات هي درع الإيمان، وبيضة الإسلام، ومهجر المستضعفين من المؤمنين، وملجأ الخائفين، ومأوى الفارّين بدينهم من الفتن.
2 - تقرير الأُخوّة بين أفراد الأُمّة الإسلامية.
فقد جعل الإسلام الأُخوّة آصرة تربط بين المسلمين، ونسباً يدخل فيه كلّ مسلم، ورابطة متينة تجمع بين صغيرهم وكبيرهم وقويهم وضعيفهم ومحسنهم ومسيئهم.
والأُخوّة في الإسلام ليست كلمة مرسلة لا مدلول لها أو شعاراً أجوف لا معنى من ورائه، بل هي حقيقة راسخة في الحياة الإسلامية وخليقة قائمة بين المسلمين، لها آثارها في واقعهم ولها مظاهرها في سلوكهم ومختلف أحوالهم؛ لأنّها لازمة للإيمان ومنبثقة عنه، ومن ثمّ فهي تابعة له في الوجود والعدم وفي الظهور والخفاء.
وقد جعل الإسلام آثار الأُخوّة الإسلامية أُموراً ثلاثة:
أوّلها:
وجوب الحبّ المتبادل بين المسلمين، كما يقرّره قول اللّٰه عزّ وجلّ: (إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اَلرَّحْمٰنُ وُدًّا) (سورة مريم: 96). ويقول النبي صلى الله عليه و آله: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنّة حتّى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتّى تحابّوا. أو لا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم». ولكي ينتشر الحبّ بين أفراد الأُمّة الإسلامية ويتداولونه بينهم أمر النبي صلى الله عليه و آله كلّ مسلم، فقال: «إذا أحبّ الرجل أخاه، فليخبره أنّه يحبّه».
ثانيها:
وضع نظام الحقوق بين أبناء الإسلام، فقد شرّع الإسلام نظام الحقوق بين المسلمين وجعل العمل به أمراً لازماً للأُخوّة في الدين، وجعله مظهراً لقوّة اليقين وصدق الإيمان، وهي حقوق شملت كلّ جوانب الحياة وأحوال المسلمين كافّة، ما ظهر منها وما بطن، وما خفي منها وما انتشر.
ثالثها:
وضع نظام التكافل والتآزر بين الأُخوة في اللّٰه، وهو من لوازم الأُخوّة وشعبها، كما يفيده قول النبي صلى الله عليه و آله: «المؤمن أخو المؤمن، يكفّ عنه ضيعته، ويحوطه من ورائه».
والتكافل في نظام الإسلام يجب أن يقوم بين المسلمين في مختلف صور المعاش وشتّى مرافق الحياة، ومن ثمّ كان التكافل في الإسلام شاملاً لكلّ مظاهر الحياة وأنواع السلوك.
3 - تشريع القيادة الواحدة للأُمّة المسلمة.
بمعنى جعلها كتلة واحدة غير قابلة للتقطيع أو التشرذم، والتأكيد على السمع والطاعة لولاة الأمر ما أطاعوا اللّٰه وأقاموا شريعته.
وحفاظاً على وحدة الأُمّة من التصدّع والشقاق وحماية لجماعتها من شرّ الفتنة والزلازل، جعل الإسلام العلاقة بين الراعي والرعية مبنية على المودّة والرحمة والرعاية الصالحة والاحترام المتبادل بين الطرفين.
4 - اعتصام أهل الإسلام بالكتاب والسنّة.
بمعنى اجتماعهم عليهما واتّفاقهم على العمل بهما مصداقاً لقول اللّٰه عزّ وجلّ: (وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللّٰهِ جَمِيعاً وَ لاٰ تَفَرَّقُوا) (سورة آل عمران: 103)، وقوله سبحانه: (وَ أَنَّ هٰذٰا صِرٰاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لاٰ تَتَّبِعُوا اَلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) (سورة الأنعام: 153).
والاستمساك بالكتاب والسنّة والتزام أحكامها سلوكاً وخلقاً وعقيدة ممّا يستلزمه الإيمان الصادق واليقين الراسخ، وممّا يجمع المؤمنين على مرجع واحد، يرجعون إلى توجيهه في أُمور دينهم ودنياهم، ويحكّمونه فيما شجر بينهم، فلا يجدون في صدورهم حرجاً من قضائه، ويسلّمون لحكمه تسليماً تامّاً؛ لكونهم يعلمون أنّه القول الفصل والمرجع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبذلك تتألّف قلوبهم على الحقّ ويجتمعون على اتّباع سبيله.
5 -تشريع القبلة الواحدة.
أي: تشريع القبلة الواحدة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ إذ يجب على كلّ مسلم حيثما كان من الأرض أن يستقبل المسجد الحرام، كما أمره بذلك ربّ العباد، فقال:
(فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) (سورة البقرة: 144).
إنّ شعور المسلم بكونه يستقبل القبلة التي يستقبلها إخوته المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها يجعله ينجذب تلقائياً إلى أهل ملّته، ويعدّ نفسه فرداً من أفراد الأُمّة الإسلامية وعضواً من أعضاء جسدها، وإن كان لا يعرف منها أحداً ولا يعرفه منهم أحد على سبيل المثال.
6 -تقرير المساواة بين أفراد الأُمّة.
وذلك باعتبارهم جميعاً بمنزلة واحدة من الحقّ والعدل والاحترام، فلا يعلو بعضهم على بعض بمال أو جاه أو منصب أو نسب، ولا يفخر أحد منهم على أحد بقبيلة أو شعب أو عشيرة، فاختلاف الناس في أوطانهم وأعمالهم ومناصبهم لا يعدّ في الإسلام مدعاة للتفاخر والتفاضل والتعالي، ولا يعتبر معياراً صادقاً للتمييز بين الناس وتقديم بعضهم على بعض، كما بيّن ذلك سبحانه وتعالى بقوله: (يٰا أَيُّهَا اَلنّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثىٰ وَ جَعَلْنٰاكُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ) (سورة الحجرات: 13).
7 -الإحساس بالمسؤولية المشتركة والمتبادلة، والاتّصاف بالسماحة الإسلامية.