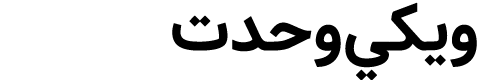مسئولية الدولة عن نجاح الترابط الأسري
الترابط الأسري طريق المجتمع الرَّاقي
مسئولية الدولة عن نجاح الترابط الأسري إنَّ الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، بل هي العنوان الكاشف لحالة أفراده وطبائعهم وسلوكياتهم، فالمجتمعات مهما كان حجمها، تبدأ بالفرد الذي لا يكون له وجود إلاَّ من خلال الأسرة، وهي الدائرة الأولى والأقرب التي يتعلم منها كيف يتعامل مع من حوله،
ذلك أنَّ سلوكيات الفرد ومفردات لغته مكتسبة في جانب كبير منها، كما أنَّ اتجاهاته نحو القضايا التي يتعرض لها في حياته يغترف فيها من معين الأسرة، وقد يتقمص شخصية والده ويحاكيه. خاصَّة في سنواته الأولى التي تدوم تجاربها طويلاً، لذا كانت سلوكيات الأبناء والقيم التي يتحلون بها، تعبيراً عن حالة الأسرة ذاتها، كما أنَّ سيرة الأسرة التربوية وسمتها كفيلتان بمعرفة كيف تكون حالة أبنائها، باعتبار أن المحيط الأولي للفرد يترك آثاراً سلوكية ونفسية من الصعب محوها.
ومن هنا تعددت المهام المنوط بالأسرة القيام بها تجاه أفرادها، سواء في الجانب التربوي أو الاجتماعي أو الثقافي، لأنَّ قيام الأسرة بدورها تجاه أبنائها، يوفر الكثير من الجهد والوقت والمال على العديد من المؤسسات التربوية بكلِّ أشكالها، كما أنَّ تقاعسها عن هذا الدور يجعل من الصعب على أية مؤسسة أنْ تكون بديلاً عنها فيه أو تحتلُّ مكانها،
وهو ما يدلُّ على أنَّها المؤسسة التربوية الأهم، وبصلاحها يصلح المجتمع، بل هي المؤسسة الأنجح قبل قيام المؤسسات كافة، وإلاَّ فمن أين إستقى القادة العظام عبر العصور الذين غيروا مسارات التاريخ قيمهم، وتعلموا كيف تكون القيادة في وقت لم يكن فيه ما نراه الآن من مؤسسات تربوية غير الأسرة.
فللأسرة دوراً مهماً في حياتنا، وهي رسالة واضحة في التنشئة السليمة للأبناء،
وهو ما يعني أنْ يقوم جناحاها وهما الأب والأم بدورهما، فالأمومة والأبوة لا توثق بشهادة ميلاد فقط، لكنها دور ورسالة يجب أنْ يقوم بها كلُّ طرفٍ، حتى يخرج للمجتمع قيمة إنسانية راشدة تجعل لحياته معنى. وممَّا لا شك فيه أنَّ وعْي الأسرة بالأسلوب الأمثل لتربية الأبناء دون إفراط أو تفريط، يسهم في توثيق النسيج الاجتماعي للمجتمع، فالتدليل المفرط للأبناء يخرج للمجتمع نمطاً من الأشخاص يميلون إلى النزعات الفردية وحبِّ التملك، واليأس والإحباط عند أول تعثر، والهشاشة النفسية وعدم القدرة على تحمل المسؤولية أو الصبر والجلد وقوة التحمل عند مواجهة التحديات، وهؤلاء لا يعتمد عليهم ولا يعول في بناء أوطانهم،
لأنهم اعتادوا على الاعتماد على غيرهم. كما أن الإفراط في القسوة في التعامل معهم والاعتقاد أن التربية بالعنف تصنع الرجال فهم يجانبه الصواب، لأن العنف والقسوة يولدان لدى الطفل الخوف من إبداء الفكرة، فضلاً عن القيام بسلوك، وهو ما من شأنه وأد الدافعية لديه، وانطواؤه على نفسه، والعجز عن اتخاذ قرار ما، وقد يفضي في النهاية إلى انسحابه من الحياة الاجتماعية.
إنَّ الأسرة هي مصنع الرجال، وإذا أردت أن تحكم على مستقبل أية أمة، فما عليك إلاَّ التحقق من نهج الأسر في التعامل مع أبنائهم الذين سيكونون آباء وأمهات المستقبل.
إنَّ قيم حب الوطن والتضحية من أجله والانتماء والولاء له، والبذل بالجهد والمال في سبيل رفعته والدفاع عنه ضد ما يهدده أو ينال من أبنائه، لا يمكن أنْ يدركها، فضلاً عن تعلمها، الفرد الذي يعيش في أسرة مفككة، ولا أعني بذلك حدوث انفصال بين الوالدين، ولكن قد يجتمع أفراد الأسرة تحت سقف واحد بأجسادهم وتتباعد أفكارهم، وقد تصل إلى حدِّ الصِّدام، وهو ما يشير إلى أهمية دور الأسرة في غرس القيم التي تحظى بالرضى العام والاتفاق المجتمعي، بحيث يكون من شذَّ عنها شذَّ عن العقد الاجتماعي، والتراضي العام الذي يتمُّ عبر الحوار والتَّوجيه الاجتماعي والتواصل بين الأجيال الذي حافظ على قيم المجتمع وتوازنه مع الانفتاح على الثقافات كافة، استناداً إلى واقع ثقافي واجتماعي متين.
الدُّولة المسئولة تجاه المجتمع مسبوقة بالمسئولية تجاه الأسرة
لم يوجد مجتمع عبر التاريخ أقام بناءه على غير الأسر وبذلك تعدُّ الأسرة عنوان قوة تماسك المجتمع أو ضعفه لأنَّها مأخوذة من الأسر وهي القوة والشدة، فهي تمثل الدرع الحصين لأفرادها، باعتبار أنَّ كلاًّ من الزوجين يعتبر درعا للآخر.
وفي ظل هذه العلاقة يزن ميزان العدل التزاماتها فبينما تتحمل الام تبعات الحمل والولادة والارضاع والرعاية يتحمل الرجل مسئولية الكسب والانفاق لتوفير سبل الراحة المادية مقابل بذل الام النفسي والعاطفي والجسدي. فتتكامل المسئوليات لتتنتج وحدة اجتماعية متجانسة هي الاسرة المستقرة الامنة بالمودة والرحمة. ومن هذا المنطلق إعتبر الاسلام الاسرة اللبنة الاساسية في المجتمع واحاطها بالتشريعات والاحكام التي تجعلها واحة سكن وأمان للأفراد. ولحماية الأسرة بنى الاسلام المجتمعات في ادارتها وتنظيم شؤونها مع تعيين مصدر القوامة فيها على اساس الشورى وتبادل الرأي، يشاور الرئيس المرؤس، والحاكم المحكوم؛ وهي اساس لكل مجتمع حتى مجتمع الرجل وزوجته في البيت والاسرة؛ ولم يجعل للرجل ولا للمرأة حقُّ الإستئثار به دون الرجوع إلى صاحبه .
حيث كانت الأسرة هي نواة المجتمع فعلى الدول الإهتمام ببناء نظام عائلي قوي، والأسرية المتماسكة والمزدهرة، التي تتبنَّى القيم العائلية الأصيلة للزواج، وتحافظ على صلات رحم قوية، والإبقاء على علاقات وطيدة بين أفراد الأسرة. والتواصل القوي بين الأطفال والآباء والأجداد؛ ليُحظى كبار السنّ بمكانتهم المحترمة ضمن الأسر، واحترام العادات والتقاليد الصحيحة التي تدعم الدور المتنامي للأعضاء دعماً تامّاً حماية للأسرة من كافة أشكال التمييز في العمل والمجتمع. فمؤشر الترابط الأسري هو مؤشر مركب يقيس الروابط الاجتماعية بين أفراد الأسرة ويشمل: العلاقات بين الوالدين، علاقات أولياء الأمور مع الأبناء، والعلاقات بين الأطفال، والعلاقات مع العائلات الكبيرة.ولحماية الأسرة لابدَّ أنْ تُعتمد على ثلاثة محاور أساسية وهي: المحور الديني، المحور الإجتماعي والمحور السلطاني. ومن هنا على الدولة بما هي الوازع السلطاني، أنْ تهتمَّ بالأسرة من جهات:
1. إقامة نظم التأمينات الاجتماعية بأنواعها المختلفة.
2. الرقابة الرشيدة على وسائل الإعلام ومنع تقديم النماذج السيئة التي تصرف الشباب عن التفكير في الزواج والتي تشجع على الفساد والانحلال وتؤدي إلى تفكك الأسر وانهيارها.
3. أنْ تتضمن مناهج التعليم في مختلف المراحل كلٌّ حسب مستواه الثقافة العلمية اللازمة لتهيئة كلِّ طالب وطالبة لتكوين أسرة ونجاحها، وفق الضوابط الشرعية.
4. السعي في سبيل تثقيف الأسر وتوعيتها بأهمية التلاحم الأسري، ودوره في الحفاظ على الهوية، وعادات المجتمع. وتطبيق أساليب مبتكرة لإشراك الآباء والأبناء ومختلف فئات المجتمع.
5. وعلى الدولة على المستوى الاتحادي، عبر وزارة تنمية المجتمع بوضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج تنمية المجتمع، بإطلاقها العديد من المبادرات لتعزيز تماسك الأسرة وتلاحمها.
لزوم تفعيل ثقافتنا الإسلامية أمام العولمة الثقافية
إنَّ الإسلام حيث لم يجئ إلاَّ لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة؛ وهذه المصالح الحقيقية إنَّما تتحقق بضمان أمن الناس في الدنيا والآخرة. وهذا الأمن الذي يكفله الإسلام للناس في الدنيا هو الأمن المادي والأمن الأسري والأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والنفسي والأمن الروحي والأمن الجماعي والأمن الفردي. والقرآن الكريم بما يتضمَّن من أحكام وضوابط وقيم وعلاقات وأخلاقيات وسلوكيات تضمِّن الأمن الأسري والاقتصادي والاجتماعي لكلِّ الناس داخلَ حدودِ مجتمعٍ آمنٍ ودولة سياسية قوية. وهذا الأمن الشامل لكل أبناء الوطن، والأمن الشامل للمجتمع، والدولة الديمقراطية بكل جوانبه، يعني تطبيق النظم الإسلامية بأركانها وضوابطها وشروطها، لكن هذا يعني بدوره تربية الناس وتنشئتهم على أساس الثقافة الإسلامية واحترام هذه الضوابط والقيم والنظم. وهذا لا يتم إلا إذا كانت هناك أسر آمنة قوية مستكملة الأركان والبناء والوظائف، تؤدي أدوارها في إطار أمن روحي ونفسي واجتماعي واقتصادي. ولهذا كانت الأسرة والأمن الأسري وبناء الأسرة وتحديد وظائفها وأدوارها وأساليب وأركان وشروط إنشائها وحقوق وواجبات كلِّ فردٍ فيها،
وأساليب التربية وأساليب مواجهة الأزمات والمشكلات داخلها، هو المعجزة الكبرى التي تحقق بناء المجتمع والدولة الآمنة القوية، وأساليب بناء الأسرة وتحديد وظائفها وحقوق كل فرد فيها وتحديد أدوارها ووظائفها كمؤسسة تحقق الأمن الشامل وبناء وتربية الأبناء، وكمؤسسة تحقق المودة والصحة والسكن داخل المجتمع، وكجهاز وحيد له حق إمداد المجتمع بأعضاء جُدد هم مواطني الدولة.
فما أكَّدتْ عليه الأمم المتحدة من هذه الأبعاد الثقافية وارتباطها بالتنمية، والأفكار المطروحة في تقرير الأمم المتحدة حول التنوع البشري الخلاَّق يحتاج إلى مناقشة نقدية فاحصة من جانب علماء المسلمين في ضوء مبادئ شريعتنا الإسلامية، ونحن في حاجة أيضا إلى تفعيل ثقافتنا الإسلامية، التي تجعل من العلم ومن العمل ومن التفكير، ومن تطوير وتحسين الاقتصاد والتعليم والصحة،
وتحسين نوعية الحياة الإنسانية كلَّه عبادة لله بالمعني الواسع، بشرط توافر النية والانطلاق من المنطلقات الإسلامية من جهة، والالتزام بالضوابط الشرعية من جهة أخري. وكلُّ هذا يطرح بالضرورة قضية التنشئة الاجتماعية والتربية الإسلامية وبناء الشخصية الإسلامية القادرة علي التفاعل مع معطيات العصر أخذا وعطاء، علي خلفية المعيارية الإسلامية التي تحدِّد ماذا تأخذ وماذا نترك، أو الجمع بين الأصالة والمعاصرة، فلا حاضر لأمَّةٍ تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمَّةٍ تنسي فضائلها، ولا أمل في نهضة إلاَّ بإعادة إحياء قيمنا الإسلامية الأصيلة في إطلاق الطاقات وحرية الفكر والإبداع والعمل المنتج، في ضوء سياسات اجتماعية واقتصادية وتربوية واضحة، وخطط عملية محددة .
وإذا كان الصِّدام بين الدين والعلم، أو بين العقل والنقل في الغرب كان حتميا، ولم يكن من الممكن لهم أنْ ينهضوا إلاَّ إذا تخلَّصتْ من التسلط الكهنوتي الذي يحول دون ظهور العلماء والمبدعين، والاستفادة بفكرهم، فإنَّ الإسلام يجعل من طلب العلم ومن الإبداع في كل المجالات العلمية والتكنولوجية عبادة لله، يتقرَّب بها الناس إلى خالقهم، إذا التزموا بمنظومة العقيدة والقيم العليا في الإسلام، وفي مقدمتها التقوي والعدل وحقوق الإنسان وحرياته، وعدم الاعتداء والدعوة إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة.
وهناك حقيقة التي نؤمن بها، وهي إتِّجاهٌ يتبناه علماء ومفكِّرو الغربيين يدعوا إلى فرض نوع من الهيمنة الثقافية على كلِّ دول العالم؛ تعزيزاً لمصالحها الاقتصادية والعسكرية والإستراتيجية.
لكن في مقابل هذا الاتجاه الداعم للعولمة الشاملة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والإعلامية. هناك اتجاه مناهض للعولمة في كل أنحاء العالم، للدفاع عن التعدد الثقافي الخلاق بين الثقافات. والناظر في هذه المبادئ يجد أنَّ الإسلام قد أكَّد عليها من خلال الضوابط الشرعية، فالتعددية سنة من سنن الله، ويجب أنْ نبُرَّ ونُقسط لغير المسلمين داخل المجتمع المسلم، بشرط أنْ يكونوا مسالمين ومعاهدين. فهذه المباديء حول حقوق الإنسان وحرياته، والقيم الداعمة للتنمية، والمرتكزات الثقافية للتنمية ونهضة المجتمعات، وحوار الحضارات، والاتجاه السلمي في تسويه المنازعات، والبعد عن العنصرية والاستعلاء واحتقار المخالفين في الدين واللغة والجنس واللون، قد تمَّ تطبيقها في دولة النبي (صلَّى الله عليه وآله). لكن مفهوم هذه المبادئ، ومضامينها الإسلامية أكثر رحابة وسعة وأخلاقية وإنسانية، من مفهومها ومضامينها في الفكر الوضعي، والسبب ببساطة أنَّها في الإسلام تستند إلى مبادئ عُليا نزل بها الوحي، وأمر بها خالق الإنسان والكون، وهو اعلم بكلِّ ما خلق ومن خلق: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}.