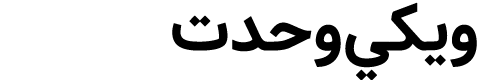القدرية
القدریة فرقة أنشئت بمرکزیة أفعال اختيارية إنسان. كانوا يعتقدون أن الإيمان بالقدر المسبق الإلهي في أفعال الإنسان، لا يتوافق مع كونه مختاراً ومريدًا في القيام بهذه الأعمال، وفي هذه الحالة لن تكون التكليفات وعقوبات الأفراد المخطئين عادلة، ومن جهة أخرى، كلما كانت أفعال الإنسان تتعلق بالقضاء والقدر الإلهي، ستُنسَب أعماله السيئة إلى الله، وهذا الأمر يتعارض مع تنزّه الله وسموه عن القباحات والمساوئ.
ملخص اعتقاد القدريّة
أ: المسألة المطروحة لدى القدريّة كانت أفعال الإنسان الاختيارية، والقدر المسبق لله.
ب: كانوا يعتقدون أن أفعال الإنسان الاختيارية خارجة عن دائرة القدر المسبق الإلهي. بمعنى آخر، القدر الإلهي ليس له أي تدخل في أفعال البشر الاختيارية.
ج: دافعهم عن هذا الاعتقاد كان الدفاع عن اختيار الإنسان والعدل الإلهي.
تاريخ ظهورهم وقادتهم
القدريّة واحدة من أقدم الفرق الكلامية التي ظهرت في العالم الإسلامي. التاريخ الدقيق لظهورهم غير واضح، ولكن من الواضح أنهم كانوا موجودين وناشطين في النصف الثاني من القرن الأول الهجري. ومع ذلك، لا يُقصد بذلك أن فكرة القدريّة لم تكن موجودة بين المسلمين قبل ذلك، بل المقصود هو أن هذا الاعتقاد لم يكن موجودًا كفرقة خاصة قبل ذلك، لأن كتّاب الملل والنحل يذكرون معبد جهنّي كواحد من رواد القدريّة، في حين أن تاريخ مقتله كُتب في السنة الثمانين الهجرية. قُتِل على يد عبد الملك مروان أو حجاج. من بين القادة والمروجين لفكر القدريّة، غيلان دمشقي، الذي قُتِل في السنة 112 هجرية على يد هشام بن عبد الملك، وبعده أصبح جعد بن درهم ثالث زعيم للقدريّة، الذي قُتِل أيضًا في السنة 124 هجرية على يد خالد بن عبد الله القسري. قال بغدادي في هذا الصدد: «ثم حدث في زمان المتأخرين من الصحابة خلاف القدريّة في القدر والاستطاعة من معبد الجهنّي وغيلان الدمشقي والجعد بن درهم. . .»[١]. كما اعتبر شهرستاني تاريخ نشوء القدريّة عصر المتأخرين صحابة وذكر معبد الجهنّي وغيلان الدمشقي ويونس أسواري كقادة للقدريّة.[٢]. من الرواية التي نقلها طبرسي في كتاب الاحتجاج، يتضح أن حسن بصري (توفي 110 هجرية) كان أيضًا من مؤيدي فكرة القدر، حيث جاء في تلك الرواية أن حسن بصري ذهب للقاء الإمام الباقر (عليه السلام)، فقال له الإمام: سمعت أنك تعتقد أن الله قد ترك أفعال عباده لهم. ثم حذّره من هذا الاعتقاد، وقال: «إياك أن تقول بالتفويض. . .»[٣] وحسن بصري سكت ولم يتحدث. سكوته في هذا الموقف يدل على أنه كان يعتقد بذلك. كما روى سيد مرتضى عن داود بن أبي هند أن حسن بصري كان يقول: «كل شيء بقضاء الله وقدره إلا المعاصي»[٤].
القدريّة والأمويون
كانت علاقة القدريّة بالحكام الأمويين علاقة عدائية وصراعية، لأن الأمويين عادة ما كانوا يفسرون القضاء والقدر الإلهي بطريقة تذكّر بإجبار الإنسان على أفعاله. كانوا يستخدمون مثل هذا التفسير الجبري للقضاء والقدر الإلهي - الذي كان للأسف شعبيًا أيضًا - لتبرير سياساتهم الاستبدادية. يروي ابن قتيبة (توفي 276 ق) أنه عندما أجبر معاوية مجموعة من المهاجرين والأنصار على مبايعة يزيد بالترغيب والتهديد، وتعرض للاعتراض من عائشة، أجاب: «إن أمر يزيد قضاء من القضاء»[٥]. الحكام الأمويون الآخرون أيضًا اتبعوا أسلوب معاوية، كما قال أبو علي جبائي: أول من دافع عن عقيدة الجبر من الحكام الأمويين كان معاوية. كان يُسند كل أعماله إلى القضاء والقدر الإلهي وبهذا كان يتذرع أمام المعارضين. بعده، أصبح هذا النوع من السياسة شائعًا بين الحكام الأمويين[٦].
صواب وخطأ القدريّة
كانت القدريّة على صواب في معارضتها لعقيدة الجبر ودفاعها عن اختيار الإنسان والعدل الإلهي، لكن في الطريقة التي اختاروها، أي إنكار القدر الإلهي في أفعال الإنسان، كانوا مخطئين، لأن هذا يعني أن الإنسان يعمل في أفعاله مستقلًا عن مشيئة وقدر الله، مما يتعارض مع أصل التوحيد في الخالق والتدبير، وبعبارة أخرى، يحد من دائرة سلطنة وقوة الله، مما يؤدي إلى نوع من الثنوية والشرك في مقام الخلق والتدبير.
نقد القدريّة في روايات المعصومين
ورد النقد على القدريّة في روايات الأئمة أهل البيت (عليهم السلام) التي نذكر بعضها:
1- شيخ صدوق في كتاب ثواب الأعمال روى عن الإمام علي (عليه السلام) أنه قال: «لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون بالقدر»[٧].
2- محمد بن علي (باقر العلوم) (عليه السلام) قال لحسن بصري: «إياك أن تقول بالتفويض، فإن الله عز وجل لم يفوض الأمر إلى خلقه وهناً منه وضعفاً، ولا أجبرهم على معاصيهم ظلماً»[٨].
3- من الإمام صادق (عليه السلام) رُوي أنه قال: «إن القدريّة مجوس هذه الأمة وهم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه»[٩].
نقاط يجب مراعاتها
1- في مذهب أهل البيت (عليهم السلام) كل من عقيدة الجبر والتفويض باطلة، والعقيدة الصحيحة هي الاختيار الذي تم تفسيره من خلال الأمر بين الأمرين.
2- من وجهة نظر أهل البيت (عليهم السلام) فإن عمومية قدرة وخالق الله لا تعني نسبة قباحات أفعال البشر إلى الله، لأنه يجب التفريق هنا بين القدر والمشيئة التكوينية، والقدر والمشيئة التشريعية.
3- في مذهب أهل البيت (عليهم السلام) تم تشبيه عقيدة النافين للقدر بعقيدة المجوس، وكذلك عقيدة المؤمنين بالجبر، النافين من جهة أنهم يعتبرون الإنسان فاعلاً مستقلاً في أفعاله واللازم لذلك الاعتقاد بوجود خالقين مثل (الله والإنسان)، بينما المجوس يؤمنون بمبدئين (يزدان وأهريمن). والجبرية من جهة أنهم، مثل المجوس، يعتبرون الزواج من الأمهات والبنات جائزاً، وينسبون ذلك إلى الله، وينسبون أفعال البشر السيئة إلى الله.
4- لم تستمر القدريّة طويلاً، لأنهم كانوا يتبعون نهجًا غير متوافق مع بني أمية، لكن نظريتهم حول القدر تم قبولها واستمرارها من قبل المعتزلة.
الهوامش
- ↑ عبدالقادر بن طاهر بغدادي، الفرق بین الفرق، ص 18- 19.
- ↑ محمد بن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، ج 1، ص 30.
- ↑ ابو منصور احمد بن علی، الاحتجاج، ص 326.
- ↑ سید مرتضی، الامالی، ج 1، ص 106.
- ↑ ابن قتیبة دینوری، الامامة و السیاسة، ج 1، ص 158، 161.
- ↑ قاضي عبدالجبار معتزلي، المغنى، قاضي عبدالجبار، ج 8، ص 4.
- ↑ شیخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، قم، انتشارات دارالرضی، سال 1406 ق، ص 214.
- ↑ احمد بن علی طبرسی، الاحتجاج، مشهد، انتشارات مرتضی، سال 1403 ق، ج 2، ص 327.
- ↑ شیخ صدوق، التوحید، قم، انتشارات جامعه مدرسین، سال 1398 ق، چ اول، ص 382.