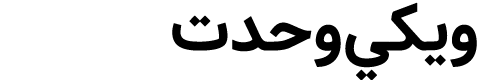حسن مكّي

| الاسم | حسن مكّي |
|---|---|
| الاسم الکامل | حسن مكّي |
| تاريخ الولادة | 1378ه/1959م |
| محل الولادة | الحصاحيصا/ السودان |
| تاريخ الوفاة | |
| المهنة | مفكّر إسلامي سوداني، وداعية تقريب. |
| الأساتید | |
| الآثار | وقد صدر له حتی الآن:
الارومو - دراسة تحليلية؛ تطور اوضاع المسلمين الإرتريين؛ السياسات الثقافية للصومال الكبير 1886-1986م؛ اوضاع الثقافة الإسلامية في جنوب السودان؛ أحمد بن ادريس الفاسي - فكره السياسي ومنهجه في الدعوة؛ الثقافة السنارية ( المغزي والمضمون)؛ اوضاع غير المسلمين في المجتمع الإسلامي؛ ابعاد التبشير المسيحي في العاصمة القومية 1990؛ التبشير المسيحي في العاصمة المثلثة 1983م؛ المشروع التنصيري في السودان: التصميم المسيحي؛ حركة البعث الإسلامي في إيران؛ حركة الاخوان المسلمين في السودان 1944-1969م؛ الحركة الإسلامية في السودان 1969 1985 تاريخها وخطابها السياسي؛ الحركة الطلابية السودانية بين الامس واليوم؛ مفاهيم في فقه الحركة؛ قصتي مع الحركة الإسلامية؛ بالإضافة للكثير من البحوث العلمية منشورة في الدوريات العلمية داخل وخارج السودان. |
| المذهب | سنی |
حسن مكّي: مفكّر إسلامي سوداني، وداعية تقريب.
ولد سنة 1959 م بالحصاحيصا في السودان.
يقول وليد الطيّب: «لو كان حسن الترابي هو زعيم الإسلاميّين السودانيّين وقائدهم التاريخي، فإنّ البروفيسور حسن مكّي هو الوشيجة بين السودانيّين الآخرين والمشروع الإسلامي السياسي السوداني كما جسّدته حكومة الإنقاذ، فمكّي هو أحد العقول الضخمة التي قدّمت قراءات مبكّرة لهذا المشروع، وكيفية تطويره، ودفعه خارج عنق الزجاجة بأفكاره حول توسيع التجربة باستيعاب الآخر، وبالتواصل مع أهل الأديان الإبراهيمية، بجانب اهتماماته بالإسلام وفكره وقضاياه وتمثّلاته في أفريقيا... من الصحافة المصرية كانت البداية، ومع قصص الهلال وكتب طه حسين والعقّاد كانت النشأة الثقافية، ثمّ كان التحوّل الفكري ب «معالم» الشهيد سيّد قطب. الغريب أنّ مكّي كما يؤكّد خرج من «بين فرث ودم»، «خليط» كما سمّاه، تمثّل في بيئة جمعت بين مئذنة وحلبة قمار، بين بار ومقهى، بحسبان المقهى وقتها مقصداً للمثقّفين... وتفاصيل هذا الخروج يمثّل حقيقة جوهر الرجل الذي اعتاد الصدق والتواضع، فكان يجيب عن أسئلة مدارك بلا تزويق أو تزييف، سواء ما يتّصل بشخصه أو أُسرته أو مسيرته الطويلة في حياته العامّة وتجربته ومعاناته الفكرية التي تمتدّ لأكثر من 45 عاماً».
يقول حسن مكّي عن نفسه: «لم نكن نعش وسط عائلتنا، كنّا كنخلة استنبتت في غير أرضها، فقد هاجر والدنا ووالدتنا من شمال السودان إلى «الحصاحيصا»، ولهذا لم نكن نعرف حتّى أقاربنا، وبيتنا كان بيتاً ذكورياً، فقد تفتّحت أعيننا ونحن بلا أخوات، فأُختي الكبيرة تزوّجت مبكّراً جدّاً، ولكن بادراتنا الفكرية الأُولى أخذناها من السوق؛ لأنّ والدنا كان تاجراً، وأيضاً من الشارع السوداني.
الحصاحيصا مدينة مختلطة وعمّالية، وبها مكتبات ومهرجانات، ولعلّ ما بقي في ذاكرتي من تلك المرحلة هو مكتبة الشعلة وتوجيهات الوالد، والشكل الثقافي والاجتماعي للمدينة، فالحصاحيصا كانت مدينة متأثّرة بالاستعمار، بها أحياء للمومسات وبها مسجد واحد، وبها قهاوى، وكانت تحتفل بالمولد، وهو مناسبة للهو أكثر منه للتديّن!
والتجمّعات الدينية كانت متصالحة مع اللاتديّن الموجود، وكان هناك تآخٍ بين المئذنة وحلبة القمار، وبين البار والمقهى!
كان هناك تخليط كبير في الأوضاع والمفاهيم في الحصاحيصا... أطللت على الدنيا من خلال هذا التخليط، وخرجت من بين فرث ودم، لكن ليس لبناً خالصاً، وفي هذا التخليط كنت حريصاً على قراءة المجلّات المصرية، والجرائد السودانية، وكنت ألتهمهما التهاماً، وكنت أقرأ- وأنا طالب في المرحلة الأوّلية والمتوسّطة- ثلاث أو أربع جرائد يومياً، وأقرأ الألغاز البوليسية مثل أرسين لوبين، وشارلوك هولمز، والروايات العالمية، وروايات الهلال، وطه حسين، والعقّاد إذا استطعنا، وجاء التحوّل الكبير حينما قرأت كتاب «معالم في الطريق» للشهيد سيّد قطب!
أخي الأكبر توفّي في العام 1950 م، ولم أره، فقد ولدت بعد وفاته ب 9 سنين، ولكن يبدو أنّه كان ذا ثقافة دينية؛ لأنّه كان يدرس في المعهد العلمي، كتبه كانت موجودة في البيت، ولكن لم نكن نقرأ منها إلّامقامات الحريري، أمّا بقية ميراثه من الكتب الصفراء فكانت الأُسرة تحتفظ بها في «شنطة» كبيرة. وكنّا نذهب إلى السينما والموالد، ونقف في المولد في حلقة القمار، ونشهد حلقة الذكر الصوفي، دون أن نتأثّر بهذا أو ذاك، وأذكر أنّنا كنّا نتأثّر جدّاً بخطابات جمال عبد الناصر ونتعاطف معه.
في المدرسة الوسطى بدأنا نعرف الإخوان المسلمين، وبعد ثورة أُكتوبر انفتح الباب أمام التيّارات الفكرية الجديدة التي غابت أيّام الحكم العسكري. وفي أُكتوبر شاركت في المظاهرات، وبعد أُكتوبر شاركت في أوّل ندوة بالحصاحيصا، وكنت وقتها في الصفّ الثالث بالمرحلة الوسطى، سمعنا حسن الترابي، وعبد اللَّه حسن أحمد، وزين العابدين الركابي، وتأثّرت بهذه الندوة وشعرت أنّني أنتمي لهؤلاء الناس!
بعدها قرأت «معالم في الطريق»، وبعد أقلّ من عام التحقت بمدرسة حنتوب الثانوية، ووجدت الإخوان هناك، وكان أنتمائي لهم تحصيل حاصل.
أعجبني أوّلًا الجو الحداثي، فالترابي كان يلبس بزّة فخمة ويستشهد بالقرآن الكريم، وأنا الذي لا يملك آنذاك بزّة ولا أحفظ القرآن! ما زلت أذكر الآيات التي استشهد بها في تلك الندوة، ومنها آيات سورة الأنعام التي تحكي قصّة إبراهيم مع أجرام السماء، وقد أسقط الترابي ذلك على الواقع السوداني، وقال: «إنّ الشعب السوداني مثل إبراهيم، إذا رأى الشمس بازغة قال: هذا ربّي، وكذلك هو كلّما رأى حكومة عسكرية قال: هذا ربّي... حتّى إذا أفل كأُفول الشمس قال: لا أُحب الآفلين!».
طبعاً الفكرة التي قالها الترابي بسيطة، لكن مبدأ استخدام القرآن في التعاطي مع الواقع والسياسة كان مؤثّراً فينا، ونحن لا نحفظ إلّاآيتين أو ثلاثاً نصلّي بها.
وكذلك هالني إقبال الناس على سماع الترابي وإخوانه، حتّى إنّ الجمهور كان يصعد على الكراسي بقدميه ليرى الترابي، ونحن كنّا تجّاراً وندرك معنى تلك التصرّفات ودلالاتها.
وعلى الجهة المقابلة كانت هناك محاولات من الشيوعيّين لتجنيدنا، وقد سعوا معنا ودعونا لمحاضرات وندوات... لكن لم تستهونا مثل ندوات الإسلاميّين.
قد بدأ الالتزام عندي بمدرسة «حنتوب» الثانوية بعدما تعرّفت على الإخوان، وحنتوب مدرسة للمتفوّقين ودرس بها أغلب مشاهير السودان، وفيها أمسكت المصحف لأوّل مرّة، فحياتنا لم يكن فيها مصحف، ولا تتعدّى علاقتي به رؤيتي له في رفوف المسجد، ودخلت خلوة قرآنية لأيّام لا تتعدّى 20 يوماً، ولكن الذي فتح أمامي نافذة الالتزام بالإسلام التجديدي الحي هو سيّد قطب.
شدّني في كتاب «معالم في الطريق» احتقاره للحياة التي أعيشها (حياة الحصاحيصا)، ووصفه لها أنّها جاهلية، فأنا كنت أقرأ الكتاب، وأتذكّر حياة الحصاحيصا بصفوف الرجال أمام بيوت الداعرات، وبارات الخمر التي أعبرها كلّ يوم، بل وأحياناً أُرسَلُ إليها لجلب الخمر. أيضاً وصف قطب لهذه الحياة بالجاهلية وكلامه عن (الاستعلاء الإيماني) خلقت فينا إرادة لأن نستعلي على حياة الحصاحيصا، بل والدنيا كلّها، خاصّة أنّ المدّ الشيوعي كان طاغياً، فجاءت كلمات سيّد قطب بمثابة قوّة نفسية موازية لكلّ القوى
المادّية الطاغية المستعلية في الكون، فقطب بقلمه وما رسمه قام بعمل معادلة في الذهن جعلتنا نعيش فوق الحياة.
وبالمناسبة لم أكُ طالباً مميّزاً أكاديمياً، ولم أك يوما ضمن العشرة الأوائل في الفصل، ولكن في البناء الفكري كنت متجاوزاً لرفاقي، فكنت أعرف المفكّرين وقيمة الكتاب، وأتكلّم في الجمعيات الأدبية والمناظرات الفكرية، ولكن نتائجي الدراسية لم تكن تخلو من الإخفاق.
أنا عدوّ للسوق من طفولتي وإلى الآن، فالسوق كان بالنسبة لي العواصف الترابية وإرهاق النظافة من واقع تجربتي الشخصية، وكنت أكره ذلك جدّاً؛ لأنّني كنت أعتبر ذلك مشروع الوالد لا مشروعي أنا، وكلّ إخواني كانوا كذلك... لم أستطع أن أعمل في مشروع لا يداعب أحلامي، وكان والدي يعتقد أنّ الدكّان- برغم كونه كبيراً- سينتهي بوفاته، وقد كان. وحتّى الآن لا أشتري من السوق شيئاً سوى البرتقال، وهو نفسه لا أشتريه من عمق السوق ولا أنزل من سيارتي لشرائه، وهذا ليس تكبّراً، ولكنّها الكراهية القديمة. وقد زرت أغلب دول العالم، ولكنّني لا أزور الأسواق إلّاإذا كنت أتريّض، والحقّ أنّني أتعجّب كثيراً عندما أرى إقبال الناس على البضائع، بينما أبحث عن الحدائق والمكتبات، ولا أُضيّع وقتاً طويلًا في المكتبات، فأنا أصل للكتاب الذي أرغب فيه بسرعة.
نشرت لي جريدة «الصحافة» مقالًا- وأنا في المرحلة الثانوية- عن «سيكولوجية الصراع في الفضاء بين الولايات المتّحدة والاتّحاد السوفييتي»، وهو تلخيص لمقال طويل لراشد البراوي في مجلّة «الهلال»، وقد أضفت إليه بعض الأفكار والتعليقات عن الحرب الكورية.
في فترة حنتوب الثانوية كانت عندنا اهتمامات أُخرى غير أكاديمية، فكنّا نجتمع بصورة دورية لمتابعة ما يحدث من صراع بين طائفة الأنصار وحكومة النميري الشيوعي آنذاك، وفي أثناء امتحانات الشهادة الثانوية المؤهّلة للجامعة زارنا جار النبي والأخ حسن عبد اللَّه لتنظيمنا للالتحاق بصفوف المقاتلين بعد نهاية الامتحانات.
وبذات الطريقة وفّقت في دخول كلّية الآداب بجامعة الخرطوم، وحاولت دراسة اللغة الفرنسية والفلسفة حتّى أهرب من التاريخ الذي كنت أعتقد أنّني متميّز فيه، وأنّه لن يضيف إليّ جديداً؛ لأنّ قراءاتي لنيتشه والعقّاد وسيّد قطب وماركس وطه حسين جعلتني أعرف فيه أكثر من أساتذتي.
وحين انتظمت في الدراسة وجدتني أشعر بالشعور نفسه تجاه الفلسفة، ولم يبق لي إلّا اللغة الفرنسية التي كانت متعبة للغاية، حيث كنّا نأخذ 12 محاضرة في الأُسبوع، ورسبت في امتحان نهاية العام، وعقد معي أُستاذ اللغة الفرنسية- وكان فرنسياً- اتّفاقاً أن ينجّحني في امتحان هذا العام على أن أترك اللغة في السنة الثانية، وكان هذا فراقاً بيني وبينها.
وفي السنة الثالثة عيّن الدكتور إبراهيم الشوش عميداً للكلّية، فأدخل اللغة العبرية، وتظاهرنا في تلك الفترة ضدّ الحكومة، ففصلنا من الجامعة، وبعد إرجاعنا إليها عادت ربّما لعادتها القديمة، ودرست التاريخ من جديد».