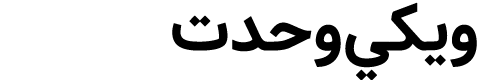الفاطميون
الفاطميون هم من الشيعة الإسماعيلية، عائلة حكمت بين عامي 297 و567 هجري على مناطق واسعة من أراضي الغرب العالم الإسلامي، وكانت تُعرف أيضًا باسم العبيديين. اعتبر الفاطميون أنفسهم خلفاء شرعيين في منافسة مع الخلفاء العباسيين. تأسست حكومة الفاطميين أولاً في المغرب الحالي، وبعد فترة سيطروا على شمال أفريقيا، مصر، الشام واليمن، ووسّعوا نفوذهم حتى الحجاز، وحكموا أجزاءً من البحر الأبيض المتوسط واستولوا على صقلية.
أدى حكم الفاطميين الطويل إلى تعزيز المذهب الشيعي في شمال أفريقيا، وخاصة في مصر. في هذه الفترة، أُسست مراكز كبيرة مثل جامعة الأزهر لتعليم العلوم الإسلامية مع توجّه إسماعيلي، وكتبت أعمال مهمة عن هذا المذهب. خلال فترة حكمهم، استخدم الفاطميون مؤسسة الدعوة وإرسال الدعاة (مبشرين بالمذهب الإسماعيلي) إلى أراضٍ مختلفة لنشر الشيعة الإسماعيلية في مناطق عدة من العالم الإسلامي، مثل اليمن، الهند ومناطق شرقية من إيران.
الفاطميون
الفاطميون هم الإسماعيليون الذين اعتقدوا أن محمد بن إسماعيل، حفيد الإمام الصادق (عليه السلام)، قد انتقل من هذه الدنيا، وأن الإمامة استمرت في ذريته. أسس حكومة الفاطميين شخص يُدعى أبو محمد عبيد الله المهدي (توفي عام 322 ق). بدأت هذه الحكومة في عام 292 هجري في المغرب، وفي عام 362 استولت على مصر والشام، مما جعلها تسيطر على جزء كبير من العالم الإسلامي، واستمرت حتى عام 567، حيث أُزيلت على يد الأيوبيين (صلاح الدين الأيوبي)[١].
سبب التسمية بالفاطميين
مصطلح الفاطميين يشير إلى أنهم ينتمون إلى فاطمة الزهراء (سلام الله عليها). ومع ذلك، تم التعبير عن وجهات نظر مختلفة حول سبب هذه التسمية:
- بعضهم نفى بشدة نسبتهم إلى فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)، ومن بينهم دخويه، الذي قدم في كتابه "يادي من قرامطة البحرين والفاطميين" العديد من الأدلة على هذا الرأي؛ ومن بين هذه الأدلة أن الخلفاء العباسيين بغداد والأمويين في قرطبة نفوا نسب هذه السلالة إلى الفاطميين مرتين، مرة في عام 402 وأخرى في عام 404، ومن جهة أخرى، ذُكر في الكتب المقدسة الدروز بوضوح أن "عبد الله بن ميمون" هو جد الخلفاء الفاطميين[٢].
- بينما اعتبر آخرون نسبتهم إلى السيدة فاطمة (سلام الله عليها) صحيحة، كما قال جرجي زيدان:
"كان الفاطميون في البداية يحكمون في إفريقية، وكان مركز حكمهم مهدية. هؤلاء الحكام الشيعة اعتبروا أنفسهم من ذرية الحسين (عليه السلام)، ابن فاطمة (سلام الله عليها)، لكن المؤرخين الذين كانوا مؤيدين بني العباس كانوا ينكرون صحة نسبهم، لكننا نرجح بقوة أن نسبهم صحيح، وأن شكوك وتكذيب عدد من المؤرخين كانت نتيجة لتأييد العباسيين[٣]".
- هناك من يرون أنه لا يمكن إصدار حكم قاطع في هذا الشأن، كما يقول س. م. استرن:
"من المعروف أنه وفقًا لوثيقة رسمية فاطمية، يعود نسب خلفاء الفاطميين إلى محمد بن إسماعيل عبر سلسلة من الأئمة المستورة، ولكن وجود عدة تقارير متضاربة في هذا المجال جعل الأمر مشوشًا. لم يعتبر معارضو خلفاء الفاطميين نسلهم من محمد بن إسماعيل، بل نسبوا تأسيس المذهب الإسماعيلي إلى عبد الله بن ميمون قداح، واعتبروا الأئمة المستورة والفاطميين نسلًا زائفًا لـعلي (عليه السلام)، ويمكن اعتبار هذه النظرية تزييفًا عدائيًا. بالطبع، مع هذا التصور، فإنه بجانب الفرق المختلفة للنهضة الإسماعيلية، لا ينبغي إغفال مذهب الأجداد القداحيين؛ لذلك، من خلال تقييم هذه الأدلة المتنوعة، لا يمكن الوصول إلى حقيقة واحدة، لأن الوثائق والأدلة المقنعة غير متاحة[٤].
مجموعة أخرى فصلت بين الإمام المستودع والإمام المستقر، وذكرت أن مؤسس الدولة الفاطمية، أي عبيد الله المهدي، ليس له نسب فاطمي، لكن نسب خلفاء الفاطميين بعده هو فاطمي حقًا، وأن عبيد الله هو سعيد بن حسين بن عبد الله بن القداح، وأن ميمون القداح وأبناؤه كانوا أئمة مستودعين، وأن عبيد الله المهدي كذلك كان إمامًا مستودعًا، وقد نقل ودائع الإمامة إلى ابن أخيه القائم (ثاني خليفة فاطمي)، وذلك لأن الأئمة الحقيقيين للإسماعيليين كانوا محصورين في سلمية الشام، وكانوا مختبئين من خوف "المعتضد العباسي" (279-289)؛ لذلك، سلم حسين الذي كان إمامًا مستودعًا ودائع الإمامة إلى ابنه وحجته سعيد، لكي ينقل هذه الأمانة إلى صاحبها الحقيقي، وهو القائم بأمر الله الفاطمي[٥].
ضعف الخلافة وسقوط الفاطميين
في النصف الثاني من خلافة الفاطميين، أدت قوة ونفوذ الوزراء إلى إضعاف الخلافة الفاطمية. في هذه الفترة، تولى الوزراء إدارة الخلافة، بالإضافة إلى إصدار الأوامر والنواهي للخليفة، مما زاد من قوتهم بتركيب خليفة ضعيف. في هذه الظروف، عندما كان الوزارة تحت يد شخص قوي، كانت الأمور تستقر مؤقتًا، لكن مع زواله، كانت الصراعات على منصب وزارة الفاطميين تتسبب في صراعات طويلة على السلطة. بدر الجمالي هو أحد أشهر وزراء الفاطميين، الذي تولى الوزارة في زمن المستنصر، وبعد فترة من الفوضى التي شهدت تعيين 40 وزيرًا خلال 9 سنوات، تولى الوزارة بقوة لفترة طويلة، وأعاد تنظيم أوضاع مصر.
بعده، تولى ابنه الأفضل الوزارة لمدة 27 عامًا حتى قُتل بأمر آمر. بعد موت الأفضل، عادت التغييرات المتكررة للوزراء ومؤامرات البلاط والعسكريين للسيطرة على منصب الوزارة.
منذ خلافة "الحافظ"، واجه الفاطميون ضعفًا وصراعات داخلية شديدة. في هذا الوقت، كان الوزراء والحكام في المناطق المختلفة يثورون وكان لهم دور في تعيين وإقالة الخلفاء. في عام 548، أرسل نور الدين زنكي، الحاكم المحلي للشام، شيركوه وصلاح الدين الأيوبي إلى مصر. عند دخول شيركوه إلى القاهرة، عينه "عاضد"، الخليفة الفاطمي آنذاك، وزيرًا له، وبعد وفاة شيركوه، أصبح صلاح الدين وزيرًا. قام صلاح الدين الأيوبي بإضعاف مؤسسات الخلافة الفاطمية والتشيع، وأعاد السلطة لعلماء السنة، وفي النهاية، في محرم عام 567 هجري، بينما كان لا يزال بضع أيام تفصل عن وفاة آخر خليفة فاطمي (عاضد)، أمر صلاح الدين بأن تُلقى خطبة في القاهرة باسم الخليفة العباسي[٦].
الفاطميون والحروب الصليبية الأولى
بعد أن عبر الصليبيون من أراضي البيزنطيين، قضوا فترة في الترحال على حدود دولة السلاجقة. خلال هذه الفترة، تكبدوا خسائر كبيرة، حتى تمكنوا من عبور السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، أي من السواحل الحالية لدول تركيا، سوريا ولبنان.
تقدم الصليبيون نحو الجنوب وفلسطين بعد استيلائهم على المناطق الساحلية. في هذا الوقت، كانت دولتان كبيرتان في العالم الإسلامي، وهما السلاجقة والفاطميون، قد ضعفتا. كان هذان الدولتان تتقاتلان منذ زمن بعيد للسيطرة على الشام وفلسطين. استولى السلاجقة على القدس في عام 463 هـ. حدث ذلك بعد سنوات من الصراع. وبعد ذلك، استمرت جهود الفاطميين في الصراع، وفي النهاية، في عام 490 هـ، استعادوا المدينة. [٧] كان النزاع في القدس والمناطق المجاورة قد أضعف القدرة الاقتصادية والعسكرية للمسلمين. لم يمضِ ثلاث سنوات على استعادة القدس من قبل الفاطميين حتى وصل الصليبيون وأحاطوا بالمدينة. لم تتمكن الدولة الفاطمية من إرسال تعزيزات، وبعد فترة من المقاومة، استسلم المدافعون عن المدينة. بدأ الصليبيون بمجرد دخولهم القدس بالقتل والنهب والتخريب. لجأ عدد كبير من السكان إلى المسجد الكبير في المدينة، لكن هناك أيضًا أصبح مكانًا للذبح، حتى أن الكتاب الأوروبيين أعربوا عن اشمئزازهم مما حدث. بعد استيلائهم على القدس، قمع الصليبيون المسلمين، وعلى عكس المسلمين الذين منحوا حرية العمل لجميع الأديان السماوية خلال فترة حكمهم، تصرفوا بتعصب ضد المسلمين. كما لم ينجُ اليهود من تعصب الصليبيين وتجاوزاتهم.
انتهت الحرب الصليبية الأولى باستيلاء الصليبيين على القدس. الصليبيون الذين حققوا النصر في هذه الحرب أنشأوا دولًا مستقلة في كل من المدن التي استولوا عليها على سواحل سوريا ولبنان وكذلك في فلسطين. كانت هذه الدول تشمل دولة القدس، دولة إدسا، دولة طرابلس وغيرها. سرعان ما انخرطوا في صراعات سياسية وأرضية واقتصادية. حتى في مدينة القدس، انقسم الصليبيون إلى عدة مجموعات وتنافسوا فيما بينهم.
كانت الحرب الصليبية الأولى بداية لسلسلة طويلة من الحروب الأخرى، لأنه من جهة، قوبل خبر انتصار الصليبيين في أوروبا بحماس، وخرجت مجموعات جديدة من الصليبيين إلى الشام وفلسطين، ومن جهة أخرى، أثار استيلاء الأراضي الإسلامية، وخاصة القدس، قلقًا كبيرًا لدى المسلمين، ولهذا، سعت الدول الإسلامية لتعويض ذلك. من بين هذه الدول، كانت الفاطميون الذين لا يزال لديهم أجزاء من مصر والشام، يستمرون في الحرب ضد الصليبيين. في منطقة الشام، شكل القادة المسلمون المؤيدون للفاطميين دولة تُعرف بـ آل زنكي، وقام أحد قادتهم، يُدعى إيلغازي، بشن هجمات قوية على الصليبيين. بعد فترة، تمكن آل زنكي من هزيمة دولة الصليبيين "إدسا" واستعادة المدينة. على الرغم من أن متطوعين جدد من أوروبا قد انضموا إلى الصليبيين، إلا أن بسبب الخلافات الداخلية بينهم، وكذلك بسبب يقظة المسلمين، لم يحققوا شيئًا. كان الصليبيون في الأصل يفكرون في ممتلكاتهم وأراضيهم المحتلة، حتى أنهم لم يكونوا راضين عن دخول المتطوعين الأوروبيين، لأن وجود شريك ومنافس كان أسوأ من العدو المباشر[٨].
السياسة الدينية للفاطميين
تغيرت السياسة الدينية للفاطميين، رغم أنها شهدت تغييرات كبيرة خلال فترات حكمهم الطويلة، وفقًا لأفكار كل من الخلفاء، ولكن بشكل عام، كانت مصحوبة بالتسامح. من الطبيعي أن يسعى الفاطميون الإسماعيليون إلى نشر التشيع في نطاق حكمهم، ولتحقيق ذلك، استخدموا إنشاء المؤسسات الدينية والدعوية، وتعزيز الطقوس الشيعية ودعم علماء الشيعة، وأحيانًا فرضوا قيودًا على أهل السنة؛ ولكن في معظم فترات حكم الفاطميين، كان أهل السنة يعيشون بحرية ويقومون بأنشطتهم الدينية والاجتماعية. كان لكل مذهب قاضيه، وكان قضاة القضاة في العديد من المدن والمناطق ذات المذهب السني[٩]، وكانوا يعملون وفقًا لأحكام مذهبهم. كانت مجالس درس أهل السنة تستمر في نشاطها أيضًا. [١٠] بالإضافة إلى ذلك، وصل بعض السنة إلى مناصب حكومية رفيعة، كما حدث مع رضوان بن ولخشي الذي تولى الوزارة في زمن خلافة الحافظ.
فترة المغرب
سعى الفاطميون عند تشكيل الحكومة إلى نشر التشيع الإسماعيلي في المناطق التي كانت تحت سلطتهم. في المدن التي استولوا عليها، كانت تُلقى خطب باسم الأئمة الشيعة، وكانت جملة "حي على خير العمل" تُضاف إلى الأذان، وأحيانًا كانت تُقام جلسات للمناظرة بين المذهبين.
تختلف السياسة الدينية للخلفاء الفاطميين الأوائل في نشر المذهب الإسماعيلي. في فترة الخليفتين الأولين، عبيد الله المهدي وخليفته القائم، تم اتباع سياسة تغيير سريعة للمذهب مع تشديد على أهل السنة وفرض قيود عليهم، مما أدى إلى معارضة شديدة من أهل السنة. في هذه الفترة، بالإضافة إلى الجلسات التي كانت تُعقد لنشر المذهب الإسماعيلي، وُضعت قيود على نشاط علماء المالكية، الذين كانوا المذهب السائد في شمال أفريقيا، وشملت هذه القيود منع التدريس والتأليف وإصدار الفتاوى بناءً على هذا المذهب، وانتشرت الإساءات إلى الخلفاء والصحابة، وتم منع أداء شعائر خاصة أهل السنة مثل صلاة التراويح[١١]. وفقًا لبعض الروايات، قُتل عدد من علماء المالكية في هذه الفترة. أدت مثل هذه التصرفات إلى احتجاج المعارضين وتعاونهم مع الخوارج في الثورات ضد الفاطميين، بما في ذلك ثورة أبو يزيد.
منذ خلافة المنصور، الخليفة الثالث الفاطمي، تغيرت السياسة الدينية للفاطميين، وتم اتباع سياسة لكسب ثقة أهل السنة ونشر المذهب الإسماعيلي بطريقة سلمية في المنطقة. استمرت هذه السياسة أيضًا في فترة المعز، الخليفة القوي للفاطميين. في هذه الفترة، تم تعيين قضاة مالكية في المناطق التي كان أهل السنة فيها أغلبية. عندما تم فتح مصر في عام 358، تم الإبقاء على القاضي أبو طاهر، الذي كان سنيًا، في منصبه.
فترة مصر
عند دخولهم مصر، استمرت السياسة الدينية للفاطميين في السماح لغير الإسماعيليين بأداء شعائرهم، وكذلك في نشر تدريجي للطقوس الإسماعيلية[١٢]. ومع ذلك، كانت مظاهر الفكر والعمل الإسماعيلي تُنفذ في المناطق التي تم فتحها. مثل إلقاء الخطب باسم الأئمة وتغيير الأذان أو تنفيذ شعائر مثل مراسم الدفن وفقًا لعقيدة الشيعة.
أعتذر عن ذلك! إليك النص مع المصادر المضافة بشكل صحيح:
إقامة الطقوس الشيعية
في هذه الفترة، استخدم الفاطميون المناسبات الشيعية لنشر مذهب التشيع الإسماعيلي، حيث كانت إقامة مراسم يوم عاشوراء، عيد الغدير، وعيد ولادة الأئمة والسيدة فاطمة (سلام الله عليها) من بين هذه المناسبات. أُقيمت أول مرة مراسم العزاء في يوم عاشوراء في عام 363 في زمن خلافة المعز الدين الله، واستمرت في زمن الخلفاء الآخرين. في يوم عاشوراء، كانت الأسواق تُغلق، وكان الناس، برفقة المسؤولين مثل الوزير والداعي والنبلاء والقاضي، يذهبون بعد العزاء إلى جامعة الأزهر نحو مشهد رأس الحسين، حيث كانوا يقومون بالعزاء وقراءة الشعر والنواح. في هذا اليوم، كان الناس أيضًا يزورون أضرحة الأئمة مثل كلثوم والسيدة نفيسة ويقيمون العزاء. كما كانت تقام مراسم العزاء أيضًا في قصر الخلفاء بحضور الخليفة[١٣].
تدوين وتعليم الفقه الإسماعيلي
بالإضافة إلى إقامة الطقوس الشيعية، تم اتخاذ المزيد من الإجراءات الثقافية لتثبيت المذهب الإسماعيلي. من بين هذه الإجراءات تأليف كتب فقهية وتعزيز الجانب الفقهي للمذهب الإسماعيلي، وتشكيل جلسات تعليمية تحت اسم مجالس الحكمة للناشئين الإسماعيليين.
في نفس الفترة، قام القاضي نعمان، الذي أصبح إسماعيليًا سنيًا، بدعم من المعز، بتدوين نظام الفقه الإسماعيلي وألف كتبًا مهمة في هذا المجال. كان يُعلم الفقه الإسماعيلي للجمهور في الجلسات العامة وصلاة الجماعة. من خلال هذا النهج، رد الفاطميون على الاتهامات التي كانت تظهر التوجهات الباطنية للإسماعيلية كأنها تهرب من الشريعة، وأكدوا على الالتزام بالجانب الظاهري للدين. ولهذا الهدف، قام الفاطميون بتأسيس وتوسيع مراكز تعليم المذهب الإسماعيلي، بما في ذلك جامعة الأزهر. كانت الوصول إلى التعليم الديني في الأزهر متاحة للجميع، وكانت العلوم الباطنية أقل اهتمامًا[١٤].
خلافة الحاكم بالله وظهور الدروز
تميزت فترة خلافة الحاكم بالله بسبب سياساته المتعصبة في نشر المذهب الإسماعيلي في تاريخ الفاطميين. وضع الحاكم قوانين صارمة لتقييد أهل الذمة، اليهود والمسيحيين. كما فرض سياسات صارمة على أهل السنة، وعمم سب ولعن الصحابة والخلفاء، وأساء إلى المعارضين الدينيين. أدت هذه السياسات الصارمة إلى زيادة المعارضة، مما أدى إلى ثورة أهل السنة بقيادة أبو ركوة وليد في عام 369. كان الحاكم معروفًا في تاريخ الفاطميين بأنه خليفة غير مستقر بتصرفات متناقضة، وبعد فترة، قيد سياساته الصارمة ومنحهم مزيدًا من الحرية. لم تستمر السياسات الدينية الصارمة للحاكم بالله لدى خلفائه.
اختفى الحاكم بالله في عام 411 وظل مصيره غامضًا. لم يكن الحاكم قد اختفى بعد حتى ظهرت نظرية جديدة بين مجموعة من مؤيديه، والتي عبر عنها حسن بن حيدرة الاخرم، أحد الدعاة الإسماعيليين، وهي حلول الروح الإلهية في الحاكم. قُتل الاخرم بسرعة على يد المعارضين، وبعده تبنى حمزة بن علي بن أحمد ثم محمد بن إسماعيل الدروز هذه الفكرة وتحدثوا عن ألوهية الحاكم. تعرض الدروز للملاحقة وهرب إلى الشام، وأسس فرقة من الإسماعيلية عُرفت بالدروز[١٥].
جهاز الدعوة
«وقصر السلطان في وسط مدينة القاهرة، وكل ما حوله مفتوح، فلا يوجد أي بناء متصل به. وقد قام المهندسون بقياسه ليكون بمساواة مدينة ميافارقين. وقد تم فتحه من كل جانب، وفي كل ليلة يكون هناك ألف رجل لحراسة هذا القصر: خمسمائة فارس وخمسمائة مشاة، يقرعون الطبول ويضربون الطبول من صلاة العشاء ويجوبون حوله حتى الصباح. وعندما ينظرون من خارج المدينة، يبدو قصر السلطان كالجبل، بسبب كثرة مبانيه وارتفاعه، ولكن لا يمكن رؤية شيء من المدينة، لأنه مرتفع جدًا. ويقال إن في هذا القصر اثني عشر ألف خادم، ونساء وإماء، ولكن قيل إن هناك ثلاثين ألف شخص في هذا القصر، وهو يحتوي على اثني عشر قصرًا. وهذا الحرم له عشرة أبواب على الأرض... وفي الأسفل يوجد باب يخرج منه السلطان على ظهره. وقد بُني خارج المدينة قصر يمر من خلاله المارة إلى ذلك القصر، وقد تم تثبيت جميع أسقف هذا الممر بإحكام، من الحرم إلى القصر. وقد تم بناء جدران القصر من الحجر المنحوت، وكأنها نُحتت من قطعة واحدة، وتم رفع المناظر والبوائك العالية، وتم إغلاق دكاكين المدخل.»
جهاز الدعوة الذي كان مسؤولًا عن تعليم المذهب الإسماعيلي ونشره في مناطق مختلفة، حصل على هيكل منظم خلال فترة خلافة الفاطميين، وحقق أنشطة فعالة؛ بحيث تمكن المبشرون بالمذهب الإسماعيلي في تلك الفترة من إنشاء مجموعات من الناشئين الإسماعيليين حتى في الأراضي البعيدة. كان رئيس منظمة الدعوة عمومًا هو أعلى مرجع ديني للفاطميين، وهو القاضي القضائي، الذي كان يُعرف بلقب باب أو باب الأبواب، وكذلك داعي الدعاة. كان يُنتخب هذا الشخص من قبل الإمام، وكان هو المسؤول عن اختيار باقي الدعاة[١٦].
قسم الفاطميون العالم غير الإسماعيلي إلى اثني عشر قسمًا تُعرف باسم الجزر، وكان يتم اختيار داعي كبير لكل جزيرة يُعرف بالحجة. كانت جزر الأرض تشمل أراضي العرب، الروم، الصقالبة، النوب، الخزر، الهند، السند، الزنج، الحبشة، الصين، الديلم (إيران) والبربر. بعد الحجة في كل جزيرة، كان هناك دعاة يتم تقسيمهم حسب الأهمية وحدود صلاحياتهم وواجباتهم إلى داعي بلاغ، داعي مطلق وداعي محدود. كان للدعاة أيضًا مساعدون، يتم تقسيمهم أيضًا إلى داعي مطلق وداعي محدود أو محصور. كانت هذه المنظمة تُعرف بمراتب الدعوة، وكانت نموذجًا مثاليًا لم يتم تنفيذه بالكامل، حيث كانت بعض مراتبها دائمًا فارغة[١٧].
كان الدعاة الإسماعيليون، بمساعدة مساعديهم، يبحثون في مناطق مختلفة وبين فئات مختلفة من المجتمع عن أفراد مستعدين وفضوليين، ويعرفونهم بالمذهب الإسماعيلي، وإذا وجدوا الفرد راغبًا، كانوا يأخذونه خلال مراحل إلى اعتناق المذهب الإسماعيلي. كان يُطلق على الناشئين الذين يُقبلون في المذهب اسم المستجيبين، وكان عليهم أن يقسموا عهدًا بعدم كشف أسرار الدعوة[١٨].
أهم إجراءات الفاطميين
في عصر الفاطميين، تجلى التشيع بشكل جيد في مصر. كانت مظاهر ظهور التشيع تتضمن:
- رفع نداء «حي على خير العمل» في الأذان؛
- ظهور الأحاديث والروايات التي تدل على فضيلة الإمام علي وأهل البيت (عليهم السلام).
- إضافة مناسبات، مثل عاشوراء، احتفالات نصف شعبان، غدير، ميلاد الإمام علي وسائر الأئمة (عليهم السلام) إلى المناسبات المصرية؛
- تشكيل مجالس لتعلم علوم أهل البيت (عليهم السلام).
شهد المصريون في فترة الخليفة العزيز، الخليفة الخامس الفاطمي، لأول مرة سوادًا على الإمام حسين (عليه السلام) في يوم عاشوراء. وقد أبلغ المقريزي عن سواد المصريين للإمام حسين (عليه السلام) قائلًا: كانت الإدارات الحكومية والمحلات التجارية مغلقة ثلاثة أيام قبل عاشوراء، ولم يكن هناك سوى المخابز تعمل.
على أي حال، مع وجود الفاطميين في مصر، اعتنق الناس في هذه المنطقة مذهبهم، وأصبح مذهب التشيع في هذا البلد له مؤيدون واتباع رسميون كثيرون[١٩].
العلم والمعرفة في فترة الفاطميين
ازدهار العلم والمعرفة من خلال توسيع المؤسسات العلمية هو من الميزات الأخرى للحضارة في فترة الفاطميين. بالإضافة إلى جامعة الأزهر، أُسست في فترة الفاطميين مراكز علمية أخرى. من بينها، أسس الحاكم بأمر الله في عام 395 مركزًا باسم دار الحكمة، حيث كان العلماء في مختلف العلوم يتعلمون. كان قصر الخلفاء، الذي كان مزودًا بمكتبات كبيرة، أيضًا مكانًا للعلماء ولإقامة المجالس العلمية والأدبية.
في عصر الفاطميين، شهدت المكتبات أيضًا ازدهارًا كبيرًا. كانت مكتبة قصر الخلافة في القاهرة تُعرف باسم خزينة الكتب، وكانت واحدة من أهم المكتبات. وقد قدرت مصادر متنوعة عدد الكتب في هذه المكتبة بين مئة ألف إلى مليون مجلد، وقد قيل إن هناك 1220 نسخة فقط من كتاب تاريخ الطبري في هذه المكتبة[٢٠]. كانت هناك أيضًا مكتبة كبيرة أخرى في مصر تُعرف بمكتبة دار الحكمة.
خلال فترة الفاطميين، أُسست أيضًا مراصد، من بينها مرصد الحاكم الذي أُسس في زمن الحاكم بأمر الله.
على الرغم من أن المراكز العلمية للفاطميين كانت في الأصل تهدف إلى تعليم المذهب الإسماعيلي، إلا أنها اكتسبت شهرة كبيرة في العالم الإسلامي بسبب التسامح الديني، حيث قام علماء أهل السنة أيضًا بالتعليم فيها[٢١].
التجارة
كانت التجارة واحدة من أهم ركائز اقتصاد عصر الفاطميين، وقد شهدت ازدهارًا كبيرًا. كانت مصر في فترة الفاطميين تتاجر مع مناطق مختلفة من العالم. كانت المنتجات الزراعية والسلع الصناعية تصل بكثرة من الهند والصين عبر البحر الأحمر إلى مصر. كما كانت التجارة مع أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط وجزر جنوب إيطاليا مزدهرة جدًا. كان الأوروبيون وحكومة البيزنطيين من المشترين للمنسوجات المصرية[٢٢].
ساهم الفاطميون في ازدهار التجارة الخارجية من خلال إنشاء أماكن للتجارة واستراحة المسافرين والتجار الأجانب. من بين هذه المراكز كانت الفُندق، التي كانت مخصصة لإقامة التجار الأجانب، وكانت تتكون من غرف متعددة ولها مخازن وفناء، وكانت منتشرة في جميع أنحاء مصر[٢٣].
فنون عصر الفاطميين، صناعة الزجاج
ناصر خسرو، الذي زار القاهرة في زمن الفاطميين، وصف المدينة كعينة مشرقة من التخطيط العمراني وأشار إلى ازدهار هذه المدينة، حيث كانت هناك العديد من الخانات والحمامات، وكانت الشوارع مزينة بالحدائق والأشجار. كما قدم وصفًا دقيقًا للقصر الرائع الخليفة، الذي يعكس عظمة العمارة، حيث قال إنه كان بحجم مدينة، وبسبب ارتفاع مبانيه، كان يبدو كجبل من مسافة بعيدة وخارج القاهرة، حتى أنهم زرعوا الأشجار في أسطح المباني وأنشأوا أماكن للتنزه[٢٤].
الفنون والصناعات
بعيدًا عن العمارة، تشير الآثار المتبقية من الفنون الأخرى الشائعة مثل الرسم، صناعة الزجاج، الفخار، صناعة البلاط، النقش، صناعة الأرز، وصناعة الورق، إلى ازدهار الفن والصناعة في فترة الفاطميين. شهدت بعض هذه الفنون في هذه الفترة تغييرات وابتكارات أدت إلى إنشاء أنماط جديدة. من بين هذه الابتكارات، يمكن الإشارة إلى ابتكار طرق جديدة في فن صناعة الزجاج والكريستال والفخار[٢٥].
من بين الصناعات التي ازدهرت كثيرًا في زمن الفاطميين في مصر كانت صناعة النسيج. كانت بعض المدن المصرية مثل القاهرة، تونة، تينيس ودمياط من أهم مراكز صناعة النسيج في زمنها، حيث كانت جودة منسوجاتها مشهورة. كان استخدام الأقمشة الفاخرة الزخرفية شائعًا بين الخلفاء ورجال الدولة الفاطميين، وكانت هذه الأقمشة تُنسج في ورش خاصة، مما أدى إلى ازدهار إنتاج الأقمشة الزخرفية في مصر. كان هناك في القاهرة خزينة تُعرف بخزينة الكسوة، التي كانت مستودعًا للملابس المتنوعة الخاصة بالعاملين في البلاط، والتي كانت تُوزع في المناسبات المختلفة وبما يتناسب مع فصول السنة[٢٦].
من بين منتجات النسيج المصرية، يمكن الإشارة إلى الأقمشة القطنية التي كانت خاصة بمصر، والأقمشة العتابية والشوشترية التي كانت من الحرير، وكذلك القماش القلموني الذي كان قماشًا لامعًا وملونًا يتلألأ تحت أشعة الشمس ويكتسب ألوانًا متنوعة. كانت الديباج، السقلاتون، الشرب، والدبقي من الأقمشة الأخرى الشائعة في مصر. كان الفاطميون يعدون كل عام كسوة الكعبة في مصر ويرسلونها إلى مكة، والوصف الذي ورد عن هذه الكسوة في المصادر يدل على تقدم هذه الصناعة في مصر. وقد ذكر ناصر خسرو عند مروره بمدينة تينيس أقمشة تُنتج فقط في هذه المدينة ومخصصة للسلاطين ولا تُباع لأحد. ووفقًا لـ ناصر خسرو، كانت صناعة النسيج في هذه المدينة قد تقدمت لدرجة أن ملك الروم طلب من سلطان مصر أن يمنحه تينيس مقابل تسليم مئة مدينة من مملكته[٢٧].
صفحات خارجية
الهوامش
- ↑ رباني گلپایگانی، علي، فرق ومذاهب كلامية، درس دوازدهم؛ برنجکار، رضا، آشنایی با فرق ومذاهب اسلامی، ص 97
- ↑ فرق ومذاهب كلامية، درس دوازدهم، نقلاً عن تاريخ الشيعة، ص 213
- ↑ جرجي زيدان، تاريخ الحضارة الإسلامية، ص 846
- ↑ نهضة القرامطة، ص 28 و29، مقال "القرامطة والإسماعيليون" من استرن
- ↑ إبراهيم حسن، حسن وطه أحمد شرف، عبيد الله المهدي إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية في بلاد المغرب، ص 77-169
- ↑ دفتري، فرهاد، تاريخ وعقائد الإسماعيلية، ترجمة: بدرهای، فريدون، ص 312
- ↑ من بين أول المهاجمين الصليبيين كان بطرس الراهب. توفي في صحاري آسيا الصغرى
- ↑ تأسيس دولة الفاطميين https://hawzah.net › Article › View
- ↑ دفتري، تاريخ وعقائد الإسماعيلية، 1386ش، ص312
- ↑ بحث في أحد الإمبراطوريات الإسلامية، 1383ش، ص56
- ↑ «مقارنة وتحليل السياسات الدينية للفاطميين في المغرب ومصر حتى نهاية الظاهر»، ص21؛ فضلي، «إعادة قراءة سياسة الفاطميين الدينية في المغرب»، ص35-36
- ↑ مقارنة وتحليل السياسات الدينية للفاطميين في المغرب ومصر حتى نهاية الظاهر، ص25
- ↑ بادكوبه هزاوه، «سیاستهای مذهبی فاطمیان در مصر در دوره اقتدار»، ص۲۹-۳۲
- ↑ مقایسه و تحلیل سیاستهای مذهبی فاطمیان در مغرب و مصر، ص۲۶
- ↑ النجوم الزاهره، ج۴، ص۱۷۹
- ↑ فاطمیان و سنتهای تعلیمی و علمی آنان، ص۷۳
- ↑ فاطمیان و سنتهای تعلیمی و علمی آنان، ص۷۵؛ بجنوردی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج ۸، ص۶۹۲-۶۹۳
- ↑ فاطمیان و سنتهای تعلیمی وعلمی آنان، ص۸۵؛ جان احمدی، ساخت، کارکرد و تحول نهاد دعوت فاطمیان مصر، ص۸۵
- ↑ وضعیت شیعیان مصر در عصر صلاح الدین ایوبی / داوود کاظمپور ... http://tarikh.nashriyat.ir › node
- ↑ النجوم الزاهره، ج۴، ص۱۰۱؛ ایوب، تاریخ الفاطمی الاجتماعی، ص۱۶۹؛ الامین، دایره المعارف الاسلامیه الشیعیه، ج۱۶، ص۳۳۴
- ↑ ناصری طاهری، فاطمیان در مصر، ۱۳۹۰ش، ص۱۲۶-۱۲۷
- ↑ مضان، تاریخ مصر الاسلامیه، ۱۹۹۳م، ص۳۲۴-۳۲۵
- ↑ ماجد، تاریخ الخلافه الفاطمیه، ۲۰۱۱م، ص۱۹۶
- ↑ ناصر خسرو، سفرنامه، ص۷۷، ۷۹
- ↑ امین، دایره المعارف الاسلامیه الشیعیه، ج۱۶، ص۳۲۱-۳۲۲، ۳۴۵-۳۴۷
- ↑ مقریزی، المواعظ و الاعتبار بذکر خطط و الآثار، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۹۲
- ↑ ناصر خسرو، سفرنامه، ص۶۵