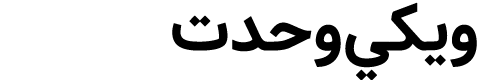عبد الرشيد إبراهيم
| الاسم | عبد الرشيد إبراهيم |
|---|---|
| الاسم الکامل | عبد الرشيد إبراهيم |
| تاريخ الولادة | 1273 ه / 1857 م |
| محل الولادة | سيبريا |
| تاريخ الوفاة | 1363 هـ / 1944 م |
| المهنة | صحفي، وكاتب |
| الأساتید | |
| الآثار | |
| المذهب |
عبد الرشيد إبراهيم: داعية إسلامي، ومصلح مجاهد.
كان عبد الرشيد في جميع أدوار حياته مثال الدأب المتواصل والكفاح النشيط، يجاهد روسيا القيصرية بسلاح الإيمان والعزيمة، ويرحل إلى الحجاز ليتعمّق في دروس الشريعة واللغة، ويصل إلى تركيا ليوجّه جهود الخلفاء إلى نصرة المستضعفين من أبناء الإسلام،
ويسافر إلى الهند والصين واليابان ليعلن كلمة اللَّه في ربوع نائية لا تكاد تعرف عن الإسلام غير النزر الضئيل، ثمّ يستطيع بعد ذلك أن يقنع الآلاف باعتناق الدين الإسلامي، لينهض بعد ذلك داعيةً غيوراً يشرح شعائر الوضوء والصلاة والزكاة،
ويبني المساجد باذلًا الجهد في جمع التبرّعات من شتّى ربوع الإسلام، ليعلن كلمة اللَّه في بيوت أذِنَ اللَّه أن تُرفَع ويُذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوّ والآصال، ثمّ يزور مصر ليؤكّد صلاته بأقطاب الفكرة الإسلامية، ويشرح أحوال المسلمين في أقاصي آسيا من بلاد الصين واليابان ومنشوريا وكوريا، وكلّها قد كانت ميداناً لجولات الشيخ الدعوية ورحلاته الدينية!
فإذا ذهب مُصلٍّ إلى مسجد الإسلام بطوكيو عجب حين يرى الرجل الأُسطورة في الخامسة والتسعين من عمره ينهض قبل شروق الفجر فيقيم صلاة التهجّد، ثمّ يؤمّ الناس في صلاة الصبح، ولا يكاد يفرغ من تسبيحه حتّى يتحلّق عليه جماعة من حواريّيه ليشرح لهم سور القرآن وأحاديث الرسول، فإذا أشرقت الشمس انتقل إلى حجرة الدراسة الملحقة بالمسجد ليجد نفراً من صبيان المسلمين يستقبلونه، فيقوم لهم بدور المعلّم، يكتب لهذا لوحه، ويسمع من ذلك سورته! ثمّ لا يستنكف أن يكون في هذه السنّ المتقدّمة وبعد هذا
الجهاد المتواصل معلّم صبيان تقرأ على يديه مبادئ اللغة العربية، ويُحفّظ الناشئة قصار السور من جزء عمّ، وبعض المأثور من حديث الرسول صلى الله عليه و آله، وهو من كبار زعماء الإسلام في ثلاثة أجيال ناهزت القرن!
وقد التقى عبد الرشيد مع جمال الدين الأفغاني في جهة وافترقا في أُخرى، فقد التقيا في ناحية الشعور الحادّ بوجوب نهضة الإسلام ويقظة بلاده ثمّ التنقّل في شتّى الأصقاع الإسلامية لإيقاظ الغافلين وتنبيه النائمين، وافترقا في مسلك الدعوة ومنحاها، فقد كان جمال الدين ثائراً مضطرماً يريد أن يغيّر معالم الدنيا في لحظة عين، فهو لا يهدأ له قرار؛ إذ يرى أمثلة مؤلمة من الخضوع والاستكانة والاحتلال، فيُشعِل الثورات مختاراً جنودها من تلاميذ بررة أمدّهم بروحه ونفث فيهم من حميّته. أمّا عبد الرشيد فقد آثر أن يكون جندياً يدعو إلى اللَّه بالحكمة والموعظة الحسنة، يؤلّف في صمت، ويعظ في هدوء، ويرحل في مثابرة، ويترك للأيّام أن تُنضج بذوره الطيّبة دون تعجّل، وقد أحسن اللَّه عاقبته، فعُمِّر في الإسلام حتّى شاهد نوره يمتدّ على يديه إلى مطارح نائية كانت تعمه في الظلمات، وما مات حتّى استطاع في سنة 1939 م أن يجبر البرلمان الياباني على الاعتراف بالإسلام واحداً من أديان الدولة الرسمية! وبهذا الاعتراف بنى الشيخ مسجدين لا مسجداً.
يقول الدكتور محمّد رجب البيّومي: «ولقد كنّا نصلّي الجمعة ذات يوم في مسجد الأُستاذ الدكتور عبد الوهاب عزّام رحمه الله، فحدّث المصلّين عن دعاة الإسلام في العصر الحديث، وتطرّق إلى الشيخ عبد الرشيد، فكان ممّا قاله آنذاك: «إنّ من العجب العاجب أن يصدر الشيخ عبد الرشيد مؤلّفه: «عالم إسلام» فلا يذيع وينتشر ويترجم ويعمّ كلّ مكتبة إسلامية، مع أنّه يجمع مشاهداته للشخصية البصيرة في شتّى ربوع الإسلام: في آسيا وأوروبّا وأفريقيا! ويصف من أدواء المسلمين وعللهم ما لم يتيسّر الإلمام به لأحد إلّاأن يكون الأمير شكيب أرسلان! ونحن نرى الآن طبعات متكرّرة لرحلة ابن بطّوطة وأمثاله، فأيّ شيء تكون رحلة ابن بطّوطة إذا قيست برحلة أكبر داعية في العصر الحديث؟! لقد كان ابن بطّوطة يرحل ليتزوّج ويرى ويتمتّع دون أن يكون له هدف غير تسطير الخرافات
والكرامات وتدوين ما يسمع من الأعاجيب، أمّا عبد الرشيد فقد ركب البرّ والبحر والجوّ ليدعو إلى اللَّه، وكم احتمل عنت ذوي الجهالة وسفاهة أُولي الضلالة، ثمّ أصدر الكتب النافعة ودوّن رحلاته الماتعة، فلم تجد من الذيوع ما وجدت رحلات الغرائب والخرافات!».
هذا بعض ما يحضرني من حديث الدكتور عزّام رحمه الله، وقد كانت صلته وثيقة بالشيخ الكبير؛ إذ سارع إلى التعرّف عليه حين قدم إلى مصر، فأسعده بزيارة بيته بحلوان عدّة مرّات، ثمّ رثاه بكلمة متواضعة، نشرها بإمضاء مستعار بمجلّة «الثقافة» العدد (312)، جاء فيها بقلم عزّام: «وكان مجلسه يجمع المختلفين في المآرب والمذاهب على الإعجاب به والعجب منه، من مُصغٍ إلى شيخ رحّالة مسلم يتحدّث عن جماعات المسلمين ويصف أدواءهم وأدويتهم، ومن مُنصتٍ إلى عجائب الأسفار وغرائب الأوطان، ومن مُكبرٍ لهذا الشيخ الوقور لا تقعد به السنّ عن الأسفار البعيدة، بل رأيت الصبيان يتطلّعون إلى مجلسه ليروا الرحّالة التركي الهرم الذي جاب مشارق الأرض ومغاربها، ورأيتهم يسرعون إليه متعجّبين حين طلب ماءً ليشرب؛ إذ علموا أنّه لا يشرب الماء مجتزئاً عنه بالشاي، وكانت إحدى أمانيه أن يرى مسجداً في طوكيو، فاستجاب اللَّه له، فأراه في اليابان مسجدين».
وإذا كان الدكتور عزّام أحد كتّاب العرب المعجبين بعبد الرشيد، فقد كان محمّد عاكف شاعر الإسلام في تركيا- وهو أيضاً صديق عزّام- يقاسمه الإعجاب بالرحّالة الداعية حتّى جعله بطلًا مثالياً لإحدى قصصه الأدبية الهادفة؛ إذ تخيّله واعظاً وقوراً يقوم بين المسلمين في مسجد سليمان القانوني، فيشرح للناس بالمسجد الجامع أدواء المسلمين وعللهم، ويدعوهم إلى الرشاد بعد الغي واليقظة بعد النوم، ثمّ قال عنه فيما نقله الدكتور عزّام من ترجمة منظومة عاكف: «وأسرعت الجماعة نحو الكرسي، فيا عجباً! من علا الكرسي؟
شيخ إلهي السيما، كأنّما ينبض قلبه في جبينه، تحيط لحيته الطاهرة الناصعة وعمامته البيضاء الشاهقة بجبهته الواسعة ووجهه الذي يرفّ عليه ضوء الصباح، كما تحيط الهالة بالبدر! ربّ، ما هذه الصباحة؟ وما هذه المهابة؟ وما هاتان العينان، بل الشهابان السماويان
اللذان يحرقان الإدراك بشعاع واحد منهما؟ واهاً لهذه الحزمة النورانية الجائشة من عينيك، ولهذه الأرواح المسكينة التي تهفو إليك! لا تحسبوا أنّي ارتقيت هذا الكرسي لأعظ، لست عالماً، فلا يخدعكم هذا الزيّ، حسبكم علماؤكم يفقّهونكم في دينكم، ويفتونكم فيما يُشكِل من أُموركم، ولكن سلوني عن العالم الإسلامي، فما تركت به بقعة إلّازرتها وطوّفت في أرجائها، جبت ما بين أقصى الشرق والمغرب الأقصى، ولم أدع موطناً للمسلمين في آسيا وأوروبّا وأفريقيا إلّايمّمته وتعرّفت ماضيه وحاضره! وقد حطّمتني الأسفار المتمادية، وقتلتني الرحلات المتوالية، ولم أصبر على المضي في طريقي، لولا نداء لا ينقطع، ينبجس من أعماق نفسي: ألّا تقف، تقدّم، امضِ في سبيلك، نداء غيرتي على ديني، والغيرة التي تضطرم كالبركان بين جوانحي، فلا أُطيق وقوفاً، ولا أثبت في مكان، لا يقيّدني حبّ النفس والوطن والأهل والولد، لا لا، إنّها لا تُثنيني عن عزمي، ولا تعدل بي عن مقصدي، ولا أبغي غير هذا، ذلكم كلّ أملي لا أبغي سواه».
ذلك إيجاز بليغ لحياة الداعية الكبير!
لقد أردت أن أكتب عنه فتأخّرت؛ إذ تقدّم إلى ذلك عاكف العظيم، ثمّ جاء عزّام الغيور، فأصاب في ترجمته وأبدع! وهما بعد أولى بالحديث عنه، فقد جالساه وشافهاه، وليس لي غير أن أستعيد!».
وها هي بطاقته الشخصية: وُلد الشيخ عبد الرشيد بمدينة تارا بسيبريا سنة 1846 م، في أُسرة تعتزّ بإسلامها، ولا يزيدها النكال العنصري من قبل سلطة روسيا القيصرية إلّا تمسّكاً بدينها القويم، فأُتيح له أن يتلقّى دراسة بصيرة على أيدي أُناس يفهمون رسالة الإسلام حقّ الفهم، ثمّ أُريد له أن يتزوّد من معين الثقافة الإسلامية بالحجاز، فارتحل في الثانية عشرة إلى مكّة، وأخذ في مدى عشرين عاماً يغذّي نفسه بمصادر العربية الصحيحة، ويُجالس حملة هذا الدين في مهده الأوّل، مستعيداً تاريخه الأزهر في مرابعه الوضيئة، وكانت كلّ خطاه ما بين مكّة والمدينة تذكّره بتاريخ السلف، فتوقد في صدره حمية مشتعلة وغيرة متيقّظة، وكأنّه قد عزّ عليه في مغتربه النائي أن يترك أبناء وطنه في مجاهل سيبريا
يتعرّضون إلى من يزعزع عقائدهم بشبهات باطلة وأراجيف مختلفة، دون أن يجدوا من يميّز لهم الخبيث من الطيّب في منطق واضح وإيمان سديد، فكرّ راجعاً إلى بلده مزوّداً بحصيلة وافية من المعارف الدينية الصحيحة.
ولم تمضِ غير سنوات حتّى عبق أريجه وفاح عرفه، فانتخب قاضياً بالمحكمة الشرعية، ثمّ وكيلًا للإفتاء الديني. ولم يكن ممّن تخدّرهم عليا المناصب فيؤثرون الراحة على الجهاد، بل جعل منصبه أداة توجيه وإصلاح، فجاهر القيصرية بوجوب العمل على مساعدة المسلمين ومساواتهم بغيرهم؛ إذ هم سواء في الحقوق والواجبات، ولكن كلمة الحقّ تصمّ الآذان، وتثير الحفائظ لدى المغرضين، فدبّروا أمرهم للوقيعة به، ولكنّه لمح خيوط المكيدة تُحاك بليل، ففرّ إلى إستانبول مقرّ الخلافة العثمانية، وجهر بمآسي قومه في بلاد القيصرية، ونشر رسالات مدعمة بالوقائع والأسانيد.
حتّى إذا هدأت الحال بعض الشيء لم يرضَ المنصب في دولة الخلافة، وارتحل ثانية إلى مضمار الجهاد في وطنه، وكافح وجالد حتّى استطاع أن يستخرج رخصة بإصدار رسائل مؤقّتة تقوم مقام الصحافة، وأخذ يوالي رسائله باللغة التركية القازانية تحت عناوين: «المرآة، والصيحة، وأُلفت»، وضمّ إليه الطبقة المستنيرة من أبناء دينه، فكانوا يجمعون المسلمين من كلّ بلاد الروس ليقرؤوا عليهم نشرات عبد الرشيد، وهي دعوات جريئة إلى الإصلاح الديني، والتمسّك بمبادئ الإسلام، واليقظة المتنبّهة إلى ما يدبّره الصليبيّون من مكايد سافرة لا تلتثم بقناع.
ثمّ شاء أن يجعل للّغة العربية نصيباً من دعوته، لتصل رسالته إلى أبناء الإسلام في الشرق العربي، فأصدر بعض رسائله المتتابعة بالعربية تحت عنوان: «التلميذ»، وأسمع بها مأساة قومه في كلّ صقع عربي!
ثمّ شاءت الأقدار أن تندحر جيوش روسيا أمام اليابان، فاشتغلت القيصرية بنفسها عن التعصّب قليلًا، ونهض المسلمون بقيادة عبد الرشيد إلى كتابة المقالات الموقظة ونشر الدعوات التحرّرية.
ثمّ رأى الشيخ أن يقوم بجهاده التبشيري، فتعدّدت رحلاته منذ سنة 1905 م إلى:
تركستان، ومنشوريا، وبلاد المغول، واليابان، وكوريا، والصين، وسنغافورة، وجزائر ما وراء الهند؛ ليعلّم الناس أنّ الإسلام دين المستقبل، وأنّه أوّل دين يهتف بالحرّية والإخاء والمساواة، فلاقى من الصعوبات الخطيرة ما يؤود العصبة أُولي القوّة، فكيف بفرد واحد يسافر بعيداً إلى مطارح مجهولة دون عضد من مال أو رفيق؟! ولكنّه حصر رسالته في التبشير الإسلامي، لا يبالي على أيّ جنب كان في اللَّه مصرعه.
وإذا كان اللَّه لا يضيع أجر العاملين فقد لمس المجاهد الكبير من بشائر التوفيق ما زاده إيماناً وحماسةً، حتّى ذعرت منه دوائر التبشير المسيحي بآسيا وعدّته- وهو الوحيد الفقير الأعزل- خطراً على جمعياتها التبشيرية ومؤسّساتها المالية ذات المورد الضخم والرعاية الكبرى، من أُمم غالبة تتحكّم بالمال والقوّة والبطش، في عصرٍ كانت أوروبّا فيه صاحبة الأمر وباعثة الحضار والمدنية والعلم، كما يحلو لأذنابها أن يذيعوا ذلك عنها في كلّ مكان!
ولعلّ جهاد عبد الرشيد وحده ممّا يعطي للعالم أجمع أكبر دليل لا يقبل الشكّ على أنّ الإسلام ينتشر بمبادئه وحدها، وأنّ عوامل بقائه كامنة في تعاليمه، وإلّا فبأيّ سلاح ضمّ هذا الداعية الغيور إلى الإسلام آلافاً من الناس غير سلاح المنطق والإقناع والدعوة إلى اللَّه بالموعظة ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن؟!
لقد كان بعض القساوسة من مبشِّري المسيحية في الصين يرى انتصارات عبد الرشيد الرائعة، فيكتب إلى وزارة الخارجية في بلاده ليسرّ إليها بأنّ المسيحية تعاني كثيراً من جهود عدوّ يزحف عليها بقوّته! وقد فهمت وزارة الخارجية الأمر على غير وجهه، فبعثت تتساءل عن قوّة هذا العدوّ ومدى نفوذه الحربي، فإذا الإجابة المخزية تعلن أنّ الشيخ واحد ذو منطق وإيمان!
ولم يضنّ الشيخ على أحد بتجريباته في الدعوة ومعلوماته الحيّة مستمدّة ممّا رأى وشاهد، فنشر رحلاته في مجلّدين كبيرين تحت عنوان «عالم إسلام».
اشتغل بالتحرير في أُمّهات الصحف الإسلامية بتركيا، وفي طليعتها مجلّتا:
«معلومات، والصراط المستقيم».
ولك أن تدهش حين تجد الرجل يترك مجال المنبر والقلم ليشترك في ساحة الحرب حين تدفعه الرغبة المُلحّة في نصر الإسلام، فقد أسهم في حرب طرابلس ضدّ العدوان الطلياني سنة 1912 م، وحين قامت الحرب العالمية الأُولى أخذ مكانه في الجبهة الإسلامية، فنشط إلى القوقاز مع الجيش العثماني، ثمّ دلف إلى ألمانيا للاتّصال بأسرى المسلمين هناك، ومازال يجوب الأقطار من شرق لغرب حتّى انتهت الحرب على غير ما يودّ، فلم ييأس في شيء، بل ترك ميدان الحرب ليعود مُبَشّراً في اليابان!
ومازالت جهوده تتوالى حتّى أسلم على يديه المئات والآلاف، وحتّى أصبح الإسلام معترفاً به في بلاد الشمس المشرقة. وقد ارتفعت في طوكيو مئذنتان عاليتان في مسجدين كبيرين، تردّد كلتاهما في اليوم الواحد خمس مرّات هتاف الإسلام الخالد: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلّااللَّه!
التحق عبد الرشيد إبراهيم بالرفيق الأعلى بتاريخ 31/ أغسطس/ 1944 م.
المراجع
(انظر ترجمته في: النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين 1: 41- 49).