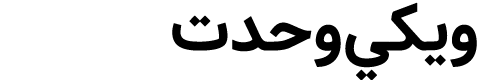محمد تقي القمّي

| الاسم | محمّد تقي القمّي |
|---|---|
| الاسم الکامل | محمّد تقي القمّي |
| تاريخ الولادة | 1920م/1338ق |
| محل الولادة | قم (ایران) |
| تاريخ الوفاة | 1990م/1410ق |
| المهنة | عالم دینی،موسس دارالتقریب قاهره |
| الأساتید | |
| الآثار | مقالات در نشریه رسالةالاسلام |
| المذهب | شیعه |
القمّي: عالم كبير، ومؤسّس دار التقريب بالقاهرة، ورائد من روّاد الوحدة والتقريب.
ولادته
ولد الشيخ محمّد تقي بن أحمد القمّي في مدينة قم سنة 1910 م وسط عائلة متديّنة وعلمية، وتلقّى دروسه الابتدائية في طهران، وحفظ القرآن الكريم، وتعلّم اللغة العربية وآدابها، وكانت آثار النبوغ بادية عليه في مراحل طفولته. وعندما أنهى المرحلة الثانوية التحق بالمدرسة العليا للآداب، وتعلّم خلالها اللغة الفرنسية. وفي نفس الوقت واصل دراسته الدينية من فقه وأُصول وكلام وغير ذلك على يد أساتذة متخصّصين.
سافر إلى لبنان، ثمّ توجّه إلى مصر عام 1938 م مريداً طرح فكرة التقريب بين المذاهب الإسلامية في أوساط الأزهر، فاتّصل بطائفة كبيرة من العلماء والأُدباء والمثقّفين المصريّين والذين أُعجبوا به أيّما إعجاب.
تأسيس دار التقريب
وفي سنة 1947 م ثمّ تأسيس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلها الشيخ القمّي، وعيّن سكرتيراً عامّاً للدار.
أخلاقه
وكان من ضمن سجايا الشيخ وأخلاقه: الانفتاح وسعة الأُفق، والصلابة والحزم في المواقف، وبساطة العيش والتعفّف، والاتّزان الفكري، والاستقلالية في العمل.
وفاته
ولقد لبّى الشيخ نداء ربّه عام 1990 م في باريس نتيجة دهسه بسيّارة حمل كبيرة وفي ظروف مريبة، ممّا حدا بعضهم إلى اعتبار الحادثة حادثة عمدية مدبّرة من قبل جهات أجنبية. وقد نقل جثمانه الطاهر إلى طهران، ودفن هناك بمقبرة عائلته وبجنب أبيه.
آرائه التقريبية
والحديث عن تقريبيات العلّامة القمّي يطول كثيراً، غير أنّنا نقتصر هنا على إيراد بعض كلماته في هذا المجال، حيث يقول في مقالة له منشورة بمجلّة «رسالة الإسلام» القاهرية ما نصّه:
«جرى الحديث بيني وبين العلّامة الشهير المغفور له الإمام الشيخ المراغي شيخ الجامع الأزهر، وكأنّي أرى الحديث أمامي كما لو كان بالأمس القريب، والحال أنّه قد مرّ عليه زمان لا يقلّ عن عشرة أعوام. كان موضوع الحديث هو المشكل الخطير الذي على
المسلمين أن يعالجوه إذا أرادوا نهضة موحّدة تشمل جميع شعوبهم وبلادهم، وهو توحيد المسلمين ثقافياً. كان الكلام بيننا في أنّ المسلمين لا يعرف بعضهم البعض، وأنّ الصلة منقطعة بينهم، ولا بدّ من تقرّبهم ثقافياً؛ ليعرف كلّ ما عند الآخر، وبذلك يحصل التوحيد المنشود، وترتفع المنازعات والخلافات في كلّ المسائل أو في أكثرها، أو تقف على الأقلّ عند حدودها الحقيقية.... لسنا في هذا المقام بصدد بيان ما دار في هذه الجلسة أو في جلستنا الممتعة التي كنت اجتمع فيها بفضيلة الإمام المراغي، ولسنا أيضاً بصدد بيان ما وصلنا إليه في نفس تلك الجلسة من إقرار تدريس بعض اللغات الإسلامية كوسيلة للتفاهم بين البلاد الإسلامية المختلفة، كما أنّنا لسنا بصدد أن نقول: هل واصلنا السير إلى الأمام منذ ذلك الوقت أو رجعنا القهقرى؟ ومهما يكن من شيء فإنّ أمامنا في اللجنة الثقافية لجماعة التقريب مشروعاً يرمي إلى توحيد المسلمين ثقافياً، أو إن شئت فقل: توحيد الثقافة الإسلامية بين المسلمين، فكرة ضخمة ومشروع جليل، ينظر إلى المسلمين كأُمّة واحدة، لغاتها محترمة عند الجميع، آدابها للجميع، رجالها للمسلمين عامّة. ليس أحد ينكر على المسلمين أن يعرف الأدب الغربي، لكن عليه في الوقت نفسه أن يعرف شيئاً عن أدب رجال نشأوا في الإسلام، ونبغوا في البلاد الإسلامية، لا مانع يمنع المسلمين أن يعرف اللغة الغربية، ولكن ممّا ينكر عليه ألّايعطي قسطاً من اهتمامه للّغات الإسلامية، ولعلّ منها ما يتكلّم به أكثر من مائة مليون من المسلمين، فتكون لغة التخاطب بين كثير من المسلمين بعضهم وبعض إحدى اللغات الغربية؛ لأنّ كلا الطرفين المسلمين لا يعرف من لغة الآخر شيئاً، ليس بمنكر على المسلم، بل المستحسن أن يعرف كثيراً عن القارّة الأُوروبّية أو الأمريكية أو غيرهما، غير أنّه بوصفه مسلماً عليه أن يعرف أكثر ممّا يعرفه الآن عن البلاد الإسلامية وأقطارها. إنّ توحيد المسلمين ثقافياً لا ينافي أن تعمل كلّ طائفة من الطوائف الإسلامية بما ثبت عندها واعتقدته ما دام هذا لا يمسّ العقائد الأساسية التي يجب الإيمان بها، ولكن من الواجب أن تعرف كلّ طائفة من المسلمين حقيقة عقائد الآخرين، لعلّها تجد فيها ما تستفيد منه أو على الأقلّ إذا أراد أحد باحثيها أن يكتب عنهم شيئاً أو ينقل بعض فتاواهم فلا يكتب: (وأمّا ما سمعنا عنهم أنّهم يقولون كذا وكذا أو أنّه يقول عنهم كذا وكذا).
ولعمري إنّ هذا لسبّة في جبين العلم أن لا يتعب رجاله أنفسهم بالبحث عن كتاب يجدون فيه كلّ ما يبحثون عنه، من غير أن يسندوا أقوالهم إلى السماع، وكثيراً ما يجيء هذا القول المسموع من ذوي الأغراض الخبيثة، وممّا هو واضح أنّه ليس معنى توحيد الثقافة توحيد اللغة، وليس هذا أمراً ممكناً، ولعلّه لا يفكّر في هذا ولا يفوه به إلّامن يرد أن يبعث التعصّب للّغات أيضاً، أو يريد أن يستعمر الآخرين. ولكن المهمّ هنا أن يفهم بعضنا بعضاً، وهذا ممكن جدّاً إذا وجد في البلاد العربية مثلًا رجال يعرفون لغات الآخرين، وعند الآخرين من يعرف اللغة العربية ويتحدّث بها، وهذا ما كان في العصر الذهبي للإسلام، شعوب لم يصطبغوا بالصبغة العربية، واحتفظوا بلغتهم القومية، إلّاأنّ رجالًا منهم- وهم علماؤهم عامّة- كتبوا ودوّنوا العلوم العربية، وخدموا اللغة العربية نفسها أيّة خدمة، من دون أيّ تعصّب أو أقلّ تحيّز. ألا وإنّ الترجمة ممّا لا بدّ أن يهتمّ بها، وكثيراً ما تترجم آثار من الغربيّين بأنواعها فنجد فيها ما يفيد ولا ننكره، ونجد فيها ما يفسد الأخلاق وينشر الخلاعة حيناً، والإلحاد والمادّية حيناً آخر، ولا يشكّ مسلم من خطر هذا النوع على الدين والآداب الإسلامية فنتجنّبه. ومادام عندنا هذا الاستعداد للترجمة، وليس لدينا مانع من أن نعطي لفكرة نشأت في بيئة مغايرة لبيئتنا وصبغت في جوّ تقاليدنا الدينية والقومية صورة مناسبة أو أقلّ بعداً، نقول: مادام عندنا هذا الاستعداد أليس من الخير أن نوجّه إلى الصحيح من الأدب الغربي وأفكار أهله، وإلى الآثار الإسلامية بما في ذلك ترجمة الكتب والدواوين والحكم والقصص وأخبار التاريخ السائرة بين الشعوب الإسلامية، وإنّ منها لكتباً لو كان أحدها هو الكتاب الوحيد في لغته ولم يكن سبيل لترجمته إلّابتعلّم اللغة لكان على الإنسان أن يتعلّم تلك اللغة ليعرف هذا أو ذاك الكتاب ويلتذّ بما فيه. إنّ في البلاد الإسلامية معادن وكنوزاً، وإنّ للمسلمين رجالًا نابغين وعلماء أكفّاء عاملين، وآباء قديرين، فهل يعرفهم العالم الإسلامي؟ وهل يعرف عنهم عشر ما يعرف عن بعض علماء المادّة وكتّاب السوء؟! وهل سمع عن آثارهم؟ وهل عرف أنّ منهم مؤلّفين خلّفوا مجلّدات من الكتب، يعدّ كل واحد منها
مرجعاً من المراجع قائماً بذاته لفكرة ناضجة عند المسلمين؟ إنّ للمسلمين جامعات علمية كبرى في مختلف البلدان، وإنّ فيها لما يجتمع به أكثر من ألفين من طلّاب العلوم الدينية، وإنّ النظام الدراسي فيها نظام حرّ، فهل عرفت الأغلبية بين المسلمين عنهم شيئاً؟! لو أنّ التعارف بين المسلمين تمّ على أساس توحيد الثقافة، بما في ذلك التبادل الثقافي، وتأليف كتب عن كلّ طائفة لإعطاء صورة صحيحة عنها، وتعليم اللغات الإسلامية في جامعاتهم، وترجمة آثارهم ورجالهم، لعرف المسلمون أنفسهم وعلموا قوّتهم، وأنّهم مسلمون قبل كلّ شيء، مسلمون في كتابتهم وتآليفهم، مسلمون في قصصهم وأشعارهم، وأنّهم أُمناء فيما يكتبون».
هذا، وإذا كانت المذاهب الإسلامية نشأت في ظلّ الاجتهاد وتأسّست في ضوء القرآن والسنّة فلا دعوة لدمجها؛ إذ في التعدّد المذهبي ثراء معرفي وتراثي للحضارة الإسلامية... لذلك ينعى الشيخ القمّي على الذين يفهمون غير ذلك: «.... ممّن لا يعرف مهمّة التقريب على حقيقتها، ولم يدرس برامجها، بل غاب عنه مدلول الاسم فحسب، إنّ التقريب توحيد.... ليست جماعة التقريب تريد القضاء على كلّ خلاف، ولا تفكّر في ذلك، ولا تبتغي أن يتشيّع السنّي، أو يتسنّن الشيعي.... إنّ التقريب لأسمى من هذا وأجلّ شأناً، إنّه- على العكس ممّا يتخيّلون أو يريدون أن يخيّلوا للناس- ينادي بوجوب أن تبقى المذاهب وأن يحتفظ المسلمون بها، فهي ثروة علمية وفكرية وفقهية لا مصلحة في إهمالها ولا في إدماجها».
ولا شكّ أنّ التقريب بين المسلمين لا يتأسّس أو يتماسك إلّاعلى أساس العلم، فإصلاح العلاقات بين المذاهب الإسلامية لا يتحقّق إلّابإصلاح المعرفة بين هذه المذاهب، والمعرفة لا تعني بالضرورة الاتّفاق معها، وإنّما الاتّفاق والاختلاف الشرط فيهما أن يكون على أساس العلم أوّلًا، فالمعرفة العلمية بين المذاهب الإسلامية بإمكانها أن تساهم في التقريب حتّى على قاعدة الاختلاف، كما يقوله القمّي، وقد تنبّه الشيخ القمّي إلى هذا الأمر «المعرفة العلمية بين المسلمين»، بل اعتبر هذه القضية هي ما جاء التقريب من أجله، يقول: «لقد جاء التقريب على أساس فكرة التعارف العلمي، وأوجد مركزاً لمن يريد أن يعرف كثيراً أو قليلًا عن المذاهب الإسلامية.... إنّ من غايات التقريب أن يعرف المسلمون بعضهم بعضاً. وإنّ أوّل من يجب عليهم التعارف هم العلماء وأهل الفكر في كلّ طائفة، والعلم لا يصادر ولا يكتم، فلا بأس على الشيعة أن يعلّموا علم السنّة، وهم يدرسونه فعلًا، وكثير من مجتهديهم يتوسّع في درسه ويتعمّق في بحثه، ولا بأس على أهل الأزهر أن يعلّموا علم الشيعة، بل ذلك واجبهم الذي يدعوا إليه الإخلاص العلمي، ولا يكون النظر تامّاً إلّا به....».
وعلى الرغم ممّا قد يتصوّره البعض من «نخبوية فكرة التقريب» واقتصارها على العلماء فقط، فإنّ الشيخ القمي ينفي ذلك، بل يرى «أنّ فكرة التقريب ليسب فكرة جماعة بذاتها مركزها دار التقريب، وإنّما هي فكرة كلّ مناصر لها في أيّ بلد من البلاد، وإنّ أيّة دار تلقى فيها محاضرة أو يجتمع فيها مؤتمر أو غير ذلك لتعريف المسلمين بعضهم إلى البعض لهي دار التقريب».
ويضع القرآن الكريم قضية التعارف بين البشر في مكانها الإنساني الهامّ: «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ» (سورة الحجرات: 13). فالمعرفة بين البشر تساهم في كلّ الكثير من المشكلات التي تنشأ بسبب الجهل... يقول القمّي: «فكثيراً من الخلافات تحلّ في ظل التعارف: إمّا لأنّها نشأت- أي: الخلافات- عن اعتقاد الطائفتين خطأً أنّ الأُخرى تعتقد أُموراً يتّضح بعد التعارف خطأ نسبتها إليها، أو لأنّها جاءت نتيجة دليل معقول أو أصل مقبول فتقبلها الأُولى، أو لأنّها تستند إلى أساس وأدلّة أن لم يكن مقبولة عند الأُولى فقد ثبت عندها اعتبارها، وعندئذٍ تلتمس عذراً لمن يعمل بها....».
إنّ هذا «المنحى العلمي» الذي تنبّه إليه الشيخ القمّي من شأنه أن يضع كلّ قضايا الخلاف موضع الطرح والبحث العلمي، كما يوفّر للمسلمين التفكير الحرّ الذي يعتمد على طرح العصبيات والأوهام التي وضعت على العقل المسلم فترات طويلة. وهو لا يدعو إلى
مناقشة القضايا الخلافية بصورة علمية أكثر ممّا يدعو العقل المسلم إلى التحرّر من أغلال التقليد والجهل اللذين تلازمانه منذ عهود ليست ببعيدة، ويتمنّى له أعداؤه أن يظلّ فيها لعهود أكثر وأكثر.
كما يساهم هذا المنحى العلمي أيضاً إلى توظيف حالة من الحوار الإسلامي- الإسلامي الذي يعتبر من القواعد الأساسية لأيّفكرة أو مشروع نهضوي.
وبعد أن يسرد الشيخ القمّي كيفية بناء قصر الثقافة الإسلامية والذي اشترك في تشييده السنّة والشيعة بل وطوائف المسلمين جميعهم، يشير إلى ذلك «الجهل» الذي أدّى إلى انشطار التراث انشطاراً عنصرياً، ويكشف القمّي عن الدور الجديد الذي يمكن أن تلعبه ثقافتنا في التقريب، يقول: «فلو أنّنا فتحنا صدورنا من جديد، واعتبرنا الثقافة الإسلامية مجموعة يكمل بعضها بعضاً، وتفاهمنا فيما بيننا على هذا الأساس، وأدركنا أنّ هذه الثقافة إسلامية بُنيت على أن تكون للإسلام قبل كلّ شي، وليست ملكاً لفرد ولا لمذهب أو طائفة، كما أنّها ما أُوجدت لتكون عنصرية، لجدّدنا بناء هذا القصر المنيف، ولمحونا عن كلّ طائفة باطل الاتّهامات الموجّهة إليها، ولأخرجنا من بيننا من ليسوا بمسلمين، كأُولئك الأدعياء الذين انتسبوا كذباً إلى الإسلام وهم معاول هدم في البناء الإسلامي... إنّ ثقافة إسلامية موحّدة- إذا التفّ حولها المسلمون- كفيلة بتوحيد صفوفهم، ومادامت هذه الثقافة موجودة فإنّه من الميسور بلوغ هذا الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه».
ويوضّح العلّامة القمّي بعض الجوانب التي ترتبط ب «مشروعه الثقافي التقريبي»:
فمنها: أنّ توحيد الثقافة ليس معناه توحيد اللغة، يقول: «ليس هذا أمراً ممكناً... ولكنّ المهمّ أن يفهم بعضنا بعضاً، وهذا ممكن جدّاً إذا وجد في البلاد العربية مثلًا رجال يعرفون لغات الآخرين وعند الآخرين من يعرف العربية ويتحدّث بها».
ومنها: الترجمة، يقول: «ففي البلدان الإسلامية معادن وكنوز وإنّ للمسلمين رجالًا نابغين، وعلماء أكفّاء عاملين، وأُدباء قديرين، فهل يعرفهم العالم الإسلامي؟ وهل يعرف عنهم عشر ما يعرف عن بعض علماء المادّة وكتّاب السوء؟ وهل سمع عن آثارهم؟ وهل
عرف أنّ منهم مؤلّفين خلّفوا مجلّدات من الكتب، يعدّ كلّ واحد منها مرجعاً من المراجع ودليلًا قائماً بذاته لفكرة ناضجة عند المسلمين؟!».
إنّ تأكيد القمّي على المشروع الثقافي وإعطاءه الأولوية كمحور رئيسي للتقريب يؤكّد لنا استشفاف حركة المستقبل الإسلامي واحتياجاته عنده، ويتجلّى ذلك في موقفين:
أوّلًا: عدم توجيه الجهود إلى مجال التقريب بين المذاهب الفقهية، يقول: «لأنّه جهاد في غير الميدان الحقيقي الأولى بالجهاد، أو على أحسن الفروض هو جهاد في الميدان الأسهل الذي لا يمثّل المشكلة الحقيقية في الخلافات بين المذاهب الإسلامية وبين السنّة والشيعة على وجه التحديد». أمّا الميدان الصعب الذي أعطاه الشيخ أولوياته فهو «الميدان الثقافي».
ثانياً: ظهور الحاجة لتعلّم لغات الأُمم الإسلامية وبدء عودة نشاط حركة الترجمة.
وقد بدأ إشباع هذه الحاجة بإنشاء أقسام لدراسة لغات الأُمم الإسلامية بالجامعات الكبرى المصرية وبعض الجامعات الإقليمية، وتغطّي هذه الأقسام مراحل الليسانس والدراسات العليا والماجستير والدكتوراه، وفي ظلّ نشاط هذه الأقسام بدأت العودة لحركة الترجمة وإن كان مقتصراً على الجوانب الأدبية فقط، كما ازدهرت المؤتمرات والندوات التي تناقش أبحاثها قضايا الدراسات اللغوية والأدبية بين الأُمم الإسلامية. وعلى الرغم من وجود تقدّم في قنوات الاتّصال بين العالم الإسلامي، إلّاأنّه يوصف بأنّه بطيء، فالعالم الإسلامي لا يزال يعاني [من] «تغييب قنوات الاتّصال بين العالم العربي الإسلامي والعالم الإسلامي الفارسي والهندي والتركي والآسيوي بوجه عامّ»، كما يقول القمّي. ولم يكن اهتمام القمّي ب «المشروع الثقافي الإسلامي» من أجل التقريب فقط، بل كان أيضاً لمواجهة «المشروع الثقافي الغربي» الذي ظهر في حركتين رئيسيتين: الاستشراق، والتغريب... وعلى الرغم من اختلاف طريقة عمل هاتين الحركتين، إلّاأنّهما اتّفقتا في اختراق الثقافة الإسلامية وإضعاف المسلمين عقائدياً.
المراجع
(انظر ترجمته في: رجالات التقريب: 197- 217، المعجم الوسيط فيما يخصّ الوحدة والتقريب 2: 94- 97 و 194).