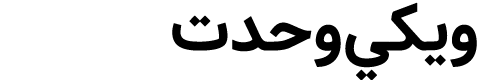المحلى بالآثار (كتاب)
موارد ومجالات إصلاح الفكر الإسلامي لينسجم وتوجيهات القرآن لتحقيق الوحدة المنشودة، ومن ذلك:
أوّلاً:
ربط الإنسان بخالقه، وتذكيره بنعمة الإسلام، ومساءلة الإنسان غداً عن كلّ أقواله وأفعاله، فلا ينطق إلّاخيراً أو ليصمت. وهذا كفيل بلجام لسانه عن التفوّه بما يغضب اللّه ويرضي الشيطان، وفي مقدّمة ذلك الكفّ عن كلمات التفريق وأسبابه.
ثانياً:
التركيز على يوم الجزاء، وأحياء معاني المصير في نفس كلّ مسلم؛ حرصاً على مداومة الرقابة الذاتية، فلا ينزلق به لسان أو تصرّف أو مقال، فيكرّس به الفرقة أو يغرز بها سكّيناً في وحدة الصفّ، فيشرخها أو يقوّض دعائمها.
ثالثاً:
عدم تقديس الآباء، حيث إنّ مأتى كثير من المسلمين في تكريس الفرقة القائمة ترديد المبدأ المنقوض بصريح القرآن: (إِنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ) (سورة الزخرف: 22).
فما كان من خطاً في التاريخ الإسلامي لا يجوز أن يكون مرجعاً للمسلمين، بل إنّ لكلّ امرئ عمله، وكلّ بشر - إلّامن شذّ - يصيب ويخطئ، والحكم المرجع هو دستور المسلمين الخالد المحفوظ، وقد تبيّن لنا ما قرّره في أمر الوحدة والتوحيد بما ليس عليه مزيد.
رابعاً:
عدم تحميل الأبناء تبعات السابقين، ممّا يزيد الطين بلّة في مقام معالجة أسقام الأُمّة المكينة، وفي صدارتها داء الفرقة والتشتّت.
خامساً:
اعتماد قاعدة «تلك أُمّة قد خلت»، وهي قاعدة قرآنية قطعية، تنبني على مبدأ المسؤولية الفردية للجماعات والأجيال، تماماً مثل مبدأ المسؤولية الفردية للأشخاص.
وهذا ما يقتضيه العدل الإلهي، ويقرّه منطق العقل والفطرة السليمة، فكما أنّه لا يسأل أحد عن أحد، وكذلك لا يسأل قوم عن قوم، ولا جيل عن آخر.
سادساً:
الاحتكام إلى العقل والمنطق، فلا شيء ينغّص على الإنسان حياته ويضيّع
عليه فرص النجاح والتقدّم كالاحتكام إلى منطق العاطفة بعيداً عن منطق العقل.
وقد منح اللّه الإنسان هذا الميزان ليضبط به مسار حياته، ويوازن بين الأشياء، فيتّضح له النافع فيقصده، ويتبيّن له الضارّ فيتّقيه.
وخطاب القرآن للبشرية كان مبنيّاً على أساس الحوار العقلي وحجج العقل، وفي أحيان عديدة يمزج ذلك بالإثارة العاطفية حتّى تتحرّك دافعية الإنسان إلى الاستجابة والتأثّر، فيترجم قناعة العقل إلى سلوك عملي.
ووحدة الصفّ لن تعود إلى عافيتها دون تحكيم العقل في نتائج الوحدة على كلّ الأصعدة وفي كلّ المراحل وتجلية وخيم العواقب على الأُمّة حين تغييب الوحدة وتستبدل بها النفرة والشقاق والتدابر.
سابعاً:
رفض الانسياق وراء تيّارات الفرقة والتأثّر بها؛ فوحدة المسلمين غاية عزيزة المنال، وممّا أغلا مهر تحصيلها تجّار الفرقة وسماسرتها، وفي صدارتهم دعاة الشعوبية الحديثة الذين ينعقون بالعصبية القومية والأفكار المنافية للوحدة، ممّا يفرخ في عقول البشر التائهين عن هدى الإسلام. فتارة نسمع بالوطنية، وأُخرى بالقومية، وطوراً بالعرقية، وآخر بالمذهبية، وطوراً بالديمقراطية، وآخر بالعلمانية، وحيناً بالعولمة، والقائمة مفتوحة للتكاثر.
وبعض أبناء المسلمين لجهلهم أو سذاجتهم يصدّقون بهذه الشعارات، فينساقون وراءها، ويضحّون بوحدة أُمّتهم في سبيلها، ويزيدون فرقتها بما يضيفون من جديد علل إلى أدوائها، فيطيلون ليل بلائها، ويعسر على دعاة الوحدة رأب الصدع وعلاج الداء إلّا بمضاعفة الجهد وطول الزمن، وكلّ ذلك تفويت لفرص ثمينة، وتضييع لطاقات ومقدّرات وجهود كان أولى بها أن تصرف في تشييد مجد أُمّتنا الإسلامية المنتظر.
ثامناً:
تفعيل منطق الاحتمال (وَ إِنّا أَوْ إِيّاكُمْ)، فمن المبادئ التي قرّرها القرآن الكريم واتّخذها منهجاً لنشر دعوته بين الناس وتقرير الصواب في المعتقد وبيان خطأ التصوّرات والديانات المخالفة للتوحيد الصحيح مبدأ الحوار والإقناع، وفتح جسور
الجدل الهادف دون إقصاء، أو حكم مسبق، أو إغلاق الوجه أمام الرأي المخالف مهما اشتطّ في الضلال، واستبدّ صاحبه برأيه معتقداً صوابه إلى أبعد حدود الاعتقاد.
وقد كان لهذا المسلك أثره الواضح في استلال سخائم العداوة وأسباب رفض هذا الدين من قلوب كثير من الناس، وإحلال الإنصاف والاعتراف في نفوسهم، ففتح اللّه قلوبهم لنور القرآن، وانظمّوا إلى قافلة المؤمنين، فاعتزّ بهم الدين، واستُنقذوا من براثن الجاهلية، وأصبحوا هداة مرشدين.
إنّ كثيراً من القضايا الخلافية استغلّت استغلالاً سيّئاً، لا لتبيان وجه الحقّ، بل لتمزيق الصفّ، وترسيخ الفرقة، وتأريث نار العداوة والشقاق بين أبناء الأُمّة الواحدة، وما أكثر هذه النماذج في تاريخنا الإسلامي القديم والحديث على حدّ سواء!
ولا ضير أن يقع الحوار الهادئ المتّزن بين المسلمين فيما وقع فيه الاختلافات، شريطة أن يلتزموا أدب الحوار وقواعد الاختلاف، ولا يتّخذوا من الظنّيات أُصولاً وكلّيات يفرّعون عليها أحكاماً تناقض القطعيات، من استباحة عرض المسلم أو دمه أو ماله ورميه بأشنع التهم وأقسى الأحكام دون سند من الشرع الحنيف.
وجدير بكلّ من أُوتي مسوولية الكلمة أن يتنبّه إلى هذه الحقيقة الناصعة، ويتّخذها منهجاً لإعادة وحدة الصفّ إلى وضعها السليم.
تاسعاً:
رفض الإصرار على الفكرة دون حجّة قاطعة، فتماشياً مع قواعد ترسيخ الوحدة ونبذ أسباب الفرقة يجدر أن تترجم الرغبة في الوحدة إلى خطوات عملية حقيقية، ومن أهمّها لزوم الإذعان لصوت الحقّ إذا دعا المتناظرين، والترفّع عن المراء والإصرار على الرأي إذا عري عن الدليل، أو لم يكن له وجه حقّ من عقل ولا دين.
وقد كان للإصرار على الآراء النشاز دور في تعثّر جهود طيّبة بذلت لتقريب الشقّة وتوحيد الصفّ، فكان لا بدّ من تصحيح هذا الخلل بالاحتكام إلى منطق القرآن الذي أنصف العقل حين استعرض حجج منكري التوحيد ومنكري الإسلام ومنكري البعث وغيرهم ممّن ألحد في اللّه أو انحرف في السلوك، فبسط اللّه حجج الجميع، وبيّن خطأها، ثمّ أقام
حقائق الدين الحقّ، وأثبتها بالبرهان، وألزم العقلاء أن ينصفوا من أنفسهم ويصيغوا لقولته الصادقة وحجّته القاطعة.