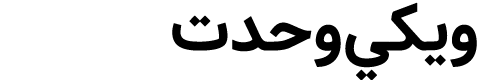الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حسين مجيب»
لا ملخص تعديل |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٢٩: | سطر ٢٩: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
حسين مجيب حسني المصري: عميد الأدب الإسلامي المقارن، وداعية إصلاح. | '''حسين مجيب حسني المصري''': عميد الأدب الإسلامي المقارن، وداعية إصلاح. | ||
=الولادة= | |||
ولد ب[[القاهرة]] عام 1334 ه/ 1916 م بقصر جدّه لأُمّه [[محمّد ثاقب باشا]] الذي كان وزيراً للري في عهد [[الخديوي إسماعيل]] عام 1347 ه/ 1929 م. وحينما كان طالباً في المدرسة الابتدائية عكف على قراءة كتب الرافعي و[[جبران خليل جبران]]، وقد ظهرت ملكاته الأدبية<br>عندما التحق بمدرسة السعيدية الثانوية بمحافظة [[الجيزة]] عام 1351 ه/ 1932 م، فكان يحصل على الدرجات النهائية في الإنشاء. ونشر أوّل قصيدة له بعنوان «الوردة الذابلة» وهي مرثية في ابنة عمّ له توفّيت، وهذه القصيدة من عيون شعره. كما كان متأثّراً بالخيال العالي في شعر الرافعي وشوقي والزهير وغيرهم من الشعراء الذين قرأهم. وفي هذه الفترة كان ينظم الشعر بالفرنسية ويقدّمه إلى مدرّسه ليصحّحه له، وكان المدرّس يبدي إعجابه بخياله ورقّة عاطفته. وكان يترجم من الشعر الإنجليزي إلى الشعر العربي. وفي الجامعة التحق بقسم اللغة العربية، وفيها تكاملت حصيلته اللغوية، وكانت من مواد الدراسة اللغة الفارسية والتركية، فأُولع بهما كثيراً، وتعمّق في دراستهما، وكان يعلّم نفسه بنفسه ولا يعتمد فقط على الدراسة. كما درس الألمانية، وترجم كتابا ألمانياً عنوانه «تاريخ الأدب الفارسي» وعلّق عليه. تعلّم الإنجليزية والفرنسية في المدرسة الثانوية، وفي الجامعة تعلّم الفارسية والتركية والألمانية. وبعد التخرّج التحق بمعهد اللغات الشرقية ثلاث سنوات بما يعادل الماجستير، وفيه أتقن الأوردية والإيطالية والروسية. وكان يترجم من هذه اللغات إلى العربية. درس المصري هذه اللغات بهدف التعرّف على المصادر الخاصّة بالتاريخ الإسلامي في هذه الآداب. وكان يترجم وهو طالب لزملائه وأساتذته من هذه اللغات، وقد ساعدته على الاطّلاع على التراث الإسلامي للشعوب الشرقية. وقد كان يرى أنّ هذا التراث لا يقتصر على الشعوب العربية فقط، ولكن يجب الاطّلاع على التراث الإسلامي لهذه الشعوب؛ لأنّه جزء من الحضارة الإسلامية وتاريخها. كما ساعدته هذه اللغات على عقد المقارنات بين آداب الشعوب الإسلامية. وحين حصل على دبلوم معهد الدراسات الشرقية الذي يعادل درجة الماجستير حالت [[الحرب العالمية الثانية]] دون سفره لإعداد رسالة الدكتوراه، فاشتغل بتدريس الأدب التركي والفارسي والأدب الإسلامي المقارن في جامعة القاهرة ومعهد الدراسات العربية. وعمل بالصحافة في بعض الصحف المصرية حتّى عام 1371 ه/ 1952 م، ثمّ سافر إلى [[تركيا]] للحصول على الدكتوراه عن [[فضولي البغدادي]] «أمير الشعر التركي»، وأثناء إعداده لرسالة الدكتوراه أُصيب بانفصال شبكي، طالت فيه<br>رحلة العلاج التي انتهت بفقد بصره. ورغم ذلك زاد إصراره وحصل على الدكتوراه، وكان أوّل عربي يحمل الدكتوراه في الأدب التركي، وأوّل من عرّف القارئ العربي بتراث الترك الأدبي، وأخرج العديد من الكتب في ذلك، وترجم الشعر التركي إلى شعر عربي على نفس الوزن والقافية، وكذلك الحال لآداب الشعوب الشرقية. وكان يساعده أثناء رحلته، سواء في القراءة أو الكتابة، ابنه وبعض أصدقائه. كانت سعة اطّلاعه وإلمامه باللغات الشرقية من العوامل التي ساعدته منذ البداية على عقد المقارنات بين الآداب الشرقية والإسلامية. | |||
<br>وكان أوّل من اشتغل بالأدب الشرقي، وكذلك أوّل من اشتغل ب[[الأدب الإسلامي المقارن]]، وكان يقول: «عقد المقارنات له أهمّية خاصّة لا يستطيعها إلّامن ملك ناصية كلّ هذه اللغات، وهي أفضل ما يكون في إبراز حقائق الآداب التي تعقد بينها المقارنات. فنحن إذا عقدنا المقارنة بين فنون الشعر التركي والغربي فإنّما نعقد المقارنة بين شعبين. ومن هنا كان لابدّ من استغلال إلمامي بثماني لغات لعقد المقارنات بين آداب هذه الشعوب، وتبيّن لي من خلالها أنّ تراثنا الإسلامي ليس في العربية وحدها، بل في لغات الشعوب الإسلامية الأُخرى التي تعتبر كنوزاً متخفّية آن لها أن ترى النور، بل يمكن أن أقول: إنّ من يعتمد على دراسة التراث الإسلامي عند العرب وحدهم فإنّها تكون دراسة مبتورة، ولا بدّ من استكمالها بالنظر في آداب الشعوب الإسلامية الأُخرى». | <br>وكان أوّل من اشتغل بالأدب الشرقي، وكذلك أوّل من اشتغل ب[[الأدب الإسلامي المقارن]]، وكان يقول: «عقد المقارنات له أهمّية خاصّة لا يستطيعها إلّامن ملك ناصية كلّ هذه اللغات، وهي أفضل ما يكون في إبراز حقائق الآداب التي تعقد بينها المقارنات. فنحن إذا عقدنا المقارنة بين فنون الشعر التركي والغربي فإنّما نعقد المقارنة بين شعبين. ومن هنا كان لابدّ من استغلال إلمامي بثماني لغات لعقد المقارنات بين آداب هذه الشعوب، وتبيّن لي من خلالها أنّ تراثنا الإسلامي ليس في العربية وحدها، بل في لغات الشعوب الإسلامية الأُخرى التي تعتبر كنوزاً متخفّية آن لها أن ترى النور، بل يمكن أن أقول: إنّ من يعتمد على دراسة التراث الإسلامي عند العرب وحدهم فإنّها تكون دراسة مبتورة، ولا بدّ من استكمالها بالنظر في آداب الشعوب الإسلامية الأُخرى». | ||
<br>ساعده الالتحاق بجامعة فؤاد الأوّل (جامعة القاهرة) بكلّية الآداب قسم اللغة العربية واللغات الشرقية على تعلّم اللغات الشرقية، وتخرّج فيها عام 1358 ه/ 1939 م. كما تعلّم اللغة الألمانية، وترجم منها العديد من البحوث والنصوص. وهو يرى أنّ دراسة اللغات الأوروبّية لازمة لمن يدرس الآداب الشرقية من عربية وفارسية وتركية، وذلك لضرورة الاطّلاع على دراسات المستشرقين في تلك اللغات، وخاصّة لمن يدرس الأدب الإسلامي المقارن. | <br>ساعده الالتحاق بجامعة فؤاد الأوّل (جامعة القاهرة) بكلّية الآداب قسم اللغة العربية واللغات الشرقية على تعلّم اللغات الشرقية، وتخرّج فيها عام 1358 ه/ 1939 م. كما تعلّم اللغة الألمانية، وترجم منها العديد من البحوث والنصوص. وهو يرى أنّ دراسة اللغات الأوروبّية لازمة لمن يدرس الآداب الشرقية من عربية وفارسية وتركية، وذلك لضرورة الاطّلاع على دراسات المستشرقين في تلك اللغات، وخاصّة لمن يدرس الأدب الإسلامي المقارن. | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٥:٠٦، ٨ ديسمبر ٢٠٢٠

| الاسم | حسين مجيب |
|---|---|
| الاسم الکامل | حسين مجيب حسنی المصری |
| تاريخ الولادة | 1916م/ 1334ق |
| محل الولادة | قاهره(مصر) |
| تاريخ الوفاة | 2004م/1425ق |
| المهنة | ادیب، شاعر، استاد الجامعة |
| الأساتید | |
| الآثار | لقد أنتج الرجل عشرات الكتب التي زادت عن السبعين كتاباً، منها: صلات بين العرب والفرس والترك، رمضان في الشعر العربي والتركي والفارسي، إقبال والقرآن، إقبال بين المصلحين الإسلاميّين، المولد النبوي في الأدب التركي، القدس بين شعراء الشعوب الإسلامية... فضلًا عن الكتب التي حقّقها وراجعها، ومئات الرسائل الجامعية (ماجستير ودكتوراه) التي أشرف على أصحابها. وله أيضاً ستّة دواوين شعرية، هي: شمعة وفراشة، وردة وبلبل، همسة ونسمة، موجة وصخرة، شوق وذكرى، حسن وعشق. |
| المذهب | سنی |
حسين مجيب حسني المصري: عميد الأدب الإسلامي المقارن، وداعية إصلاح.
الولادة
ولد بالقاهرة عام 1334 ه/ 1916 م بقصر جدّه لأُمّه محمّد ثاقب باشا الذي كان وزيراً للري في عهد الخديوي إسماعيل عام 1347 ه/ 1929 م. وحينما كان طالباً في المدرسة الابتدائية عكف على قراءة كتب الرافعي وجبران خليل جبران، وقد ظهرت ملكاته الأدبية
عندما التحق بمدرسة السعيدية الثانوية بمحافظة الجيزة عام 1351 ه/ 1932 م، فكان يحصل على الدرجات النهائية في الإنشاء. ونشر أوّل قصيدة له بعنوان «الوردة الذابلة» وهي مرثية في ابنة عمّ له توفّيت، وهذه القصيدة من عيون شعره. كما كان متأثّراً بالخيال العالي في شعر الرافعي وشوقي والزهير وغيرهم من الشعراء الذين قرأهم. وفي هذه الفترة كان ينظم الشعر بالفرنسية ويقدّمه إلى مدرّسه ليصحّحه له، وكان المدرّس يبدي إعجابه بخياله ورقّة عاطفته. وكان يترجم من الشعر الإنجليزي إلى الشعر العربي. وفي الجامعة التحق بقسم اللغة العربية، وفيها تكاملت حصيلته اللغوية، وكانت من مواد الدراسة اللغة الفارسية والتركية، فأُولع بهما كثيراً، وتعمّق في دراستهما، وكان يعلّم نفسه بنفسه ولا يعتمد فقط على الدراسة. كما درس الألمانية، وترجم كتابا ألمانياً عنوانه «تاريخ الأدب الفارسي» وعلّق عليه. تعلّم الإنجليزية والفرنسية في المدرسة الثانوية، وفي الجامعة تعلّم الفارسية والتركية والألمانية. وبعد التخرّج التحق بمعهد اللغات الشرقية ثلاث سنوات بما يعادل الماجستير، وفيه أتقن الأوردية والإيطالية والروسية. وكان يترجم من هذه اللغات إلى العربية. درس المصري هذه اللغات بهدف التعرّف على المصادر الخاصّة بالتاريخ الإسلامي في هذه الآداب. وكان يترجم وهو طالب لزملائه وأساتذته من هذه اللغات، وقد ساعدته على الاطّلاع على التراث الإسلامي للشعوب الشرقية. وقد كان يرى أنّ هذا التراث لا يقتصر على الشعوب العربية فقط، ولكن يجب الاطّلاع على التراث الإسلامي لهذه الشعوب؛ لأنّه جزء من الحضارة الإسلامية وتاريخها. كما ساعدته هذه اللغات على عقد المقارنات بين آداب الشعوب الإسلامية. وحين حصل على دبلوم معهد الدراسات الشرقية الذي يعادل درجة الماجستير حالت الحرب العالمية الثانية دون سفره لإعداد رسالة الدكتوراه، فاشتغل بتدريس الأدب التركي والفارسي والأدب الإسلامي المقارن في جامعة القاهرة ومعهد الدراسات العربية. وعمل بالصحافة في بعض الصحف المصرية حتّى عام 1371 ه/ 1952 م، ثمّ سافر إلى تركيا للحصول على الدكتوراه عن فضولي البغدادي «أمير الشعر التركي»، وأثناء إعداده لرسالة الدكتوراه أُصيب بانفصال شبكي، طالت فيه
رحلة العلاج التي انتهت بفقد بصره. ورغم ذلك زاد إصراره وحصل على الدكتوراه، وكان أوّل عربي يحمل الدكتوراه في الأدب التركي، وأوّل من عرّف القارئ العربي بتراث الترك الأدبي، وأخرج العديد من الكتب في ذلك، وترجم الشعر التركي إلى شعر عربي على نفس الوزن والقافية، وكذلك الحال لآداب الشعوب الشرقية. وكان يساعده أثناء رحلته، سواء في القراءة أو الكتابة، ابنه وبعض أصدقائه. كانت سعة اطّلاعه وإلمامه باللغات الشرقية من العوامل التي ساعدته منذ البداية على عقد المقارنات بين الآداب الشرقية والإسلامية.
وكان أوّل من اشتغل بالأدب الشرقي، وكذلك أوّل من اشتغل بالأدب الإسلامي المقارن، وكان يقول: «عقد المقارنات له أهمّية خاصّة لا يستطيعها إلّامن ملك ناصية كلّ هذه اللغات، وهي أفضل ما يكون في إبراز حقائق الآداب التي تعقد بينها المقارنات. فنحن إذا عقدنا المقارنة بين فنون الشعر التركي والغربي فإنّما نعقد المقارنة بين شعبين. ومن هنا كان لابدّ من استغلال إلمامي بثماني لغات لعقد المقارنات بين آداب هذه الشعوب، وتبيّن لي من خلالها أنّ تراثنا الإسلامي ليس في العربية وحدها، بل في لغات الشعوب الإسلامية الأُخرى التي تعتبر كنوزاً متخفّية آن لها أن ترى النور، بل يمكن أن أقول: إنّ من يعتمد على دراسة التراث الإسلامي عند العرب وحدهم فإنّها تكون دراسة مبتورة، ولا بدّ من استكمالها بالنظر في آداب الشعوب الإسلامية الأُخرى».
ساعده الالتحاق بجامعة فؤاد الأوّل (جامعة القاهرة) بكلّية الآداب قسم اللغة العربية واللغات الشرقية على تعلّم اللغات الشرقية، وتخرّج فيها عام 1358 ه/ 1939 م. كما تعلّم اللغة الألمانية، وترجم منها العديد من البحوث والنصوص. وهو يرى أنّ دراسة اللغات الأوروبّية لازمة لمن يدرس الآداب الشرقية من عربية وفارسية وتركية، وذلك لضرورة الاطّلاع على دراسات المستشرقين في تلك اللغات، وخاصّة لمن يدرس الأدب الإسلامي المقارن.
وفي عام 1356 ه/ 1938 م تعرّف حسين على صحفي إيراني مقيم في مصر يصدر مجلّة إيرانية، فكان يحرص على قراءتها، ما أكسبه لغة الصحافة في الفارسية.
وعندما افتتحت جامعة القاهرة معهد الدراسات الشرقية التحق بقسم «لغات الشعوب الإسلامية» الذي يختصّ بدراسة الأدب الفارسي والتركي والأوردي. وكان من المقرّر أن يدرس الألمانية، فرأى أن يتزوّد باللغة الإيطالية بدلًا منها، فأثار ذلك زوبعة بين أساتذة المعهد الذين كانوا يحسدونه على غزارة علمه، وتقرّر أن يدرس الإيطالية على أن يمتحن الألمانية في نهاية العام، ونال دبلوم الدراسات الشرقية عام 1361 ه/ 1942 م، كما درس الروسية في مدرسة اللغات. وبهذا اكتملت له العديد من اللغات، فتيسّر له الاطّلاع على ثقافاتها.
انتخب منتدباً لتدريس الفارسية وآدابها والتركية في المعهد العالي الذي تخرّج فيه، وبعد عام انتدب لتدريس الفارسية في معهد الآثار الإسلامية. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها شحذ همّته للسفر إلى تركيا عام 1370 ه/ 1951 م؛ ليبحث عن صديقه الشاعر المفقود «فضولي البغدادي» موضوع رسالة الدكتوراه؛ ليجمع مادّة رسالته التي يئس من تحصيلها في مصر.
وهناك سخّر اللَّه له مَن يساعده من علماء الأتراك، وأرشدوه إلى ما ينفعه في دراسته، وكثير منهم تعجبّوا من قدرته على فهم أشعار هذا الشاعر التي لا يفهمونها لصعوبة لغتها القديمة، واطّلع مجيب على مخطوطات نادرة تميّزت بخطّها الذي يصعب قراءته، ما أرهق عينيه وأضعفها، حتّى إذا فرغ من جمع ما يطلب من مادّة بحثه أُصيب فجأة بالانفصال الشبكي في عينيه. وعندما عاد إلى مصر امتنع الأطبّاء عن إجراء عملية له لصعوبتها، وأرشدوه إلى طبيب في سويسرا، فسافر وأُجريت له العملية. ومع أنّه اعتلّ بعدها فإنّه عاد ليداوم عمله منتدباً في المعهدين العاليين، وواصل كتابة رسالته التي نال بها درجة الدكتوراه عام 1374 ه/ 1955 م، وهي الأُولى التي قدّمت إلى جامعة القاهرة في الأدب التركي، وقد ترجمت رسالته إلى اللغة الروسية، وترجم جزء منها إلى التركية والآذرية، وبعد نيل الدكتوراه عيّن عضواً في هيئة التدريس بالجامعة.
وانتدب للتدريس في كلّية البنات بجامعة عين شمس لمدّة ثماني سنوات، ثمّ كلّية
اللغات والترجمة بجامعة الأزهر سبعة وعشرين عاماً، وفي كلّية البنات جامعة الأزهر أربع سنوات أُخرى، وفي كلّية الفنون جامعة حلوان عاماً واحداً، ثمّ وقع عليه الاختيار عضواً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وعمل لفترة أُستاذاً زائراً بجامعة بغداد، وعيّن في وظيفة أُستاذ كرسي غير متفرّغ بكلّية الآداب جامعة عين شمس.
لم يتوقّف عطاء الدكتور حسين المصري عند أسوار الجامعة، بل شغل نفسه بالصحافة قبل الدكتوراه وبعدها بنشر المقالات والقصائد في كثير من الصحف والمجلّات المصرية والعربية، مثل «اللواء الجديد» و «منبر الشرق» و «قافلة الزيت» السعودية و «الأديب» اللبنانية و «الورود» السورية، إضافة إلى خمسة وعشرين جريدة ومجلّة أُخرى. وكان شغله الشاغل هو الدراسات الفارسية والتركية وعقد المقارنات بينها، وقد أتاحت له الصحف نشر هذا الاتّجاه على نطاق أوسع على القارئ العربي غير المتخصّص، وكان ذلك بمثابة تمهيد لإيقاظ الوعي بوجود تراث إسلامي لم يكن للناس إلف به من قبل، فأصبح لمجيب المصري في ذلك الريادة؛ إذ صحّح المفاهيم السائدة لدى المثقّفين؛ فكثير منهم كان يهوّن من قيمة الأدب التركي وينكره في بعض الأحيان، فأوضح أنّ هذا وهم، وأنّ الأدب التركي القديم هو الأدب الإسلامي الحقّ؛ لأنّه تأثّر في أعماقه بالأدب الفارسي الذي تأثّر من قبل بالأدب العربي والتراث الإسلامي في أُصوله وفروعه، كما أنّ الأدب التركي الحديث يقف على قدم المساواة مع الأدب الأُوروبّي في روائعه؛ لأنّه متأثّر به مستمدّ منه، وهذا ما يقال عن أدب اللغة الأوردية، وهي لغة شبه القارّة الهندية عموماً وباكستان خصوصاً.
رشّح الدكتور حسين مجيب المصري للتدريس في جامعة بغداد، وكرّمه الأساتذة الأتراك بدعوته إلى إسطنبول، وأصرّ البروفيسور جتين رئيس قسم اللغات الشرقية بجامعة إسطنبول على تقبيل يده، ودرّس أيضاً في جامعة أنقرة وقونية، ودعي إلى باكستان ثلاث مرّات: الأُولى عام 1395 ه/ 1975 م، وبعد ذلك بعامين دُعي للاشتراك في مؤتمر عقد عن الشاعر الباكستاني محمّد إقبال في مدينة لاهور، وألقى بحثاً عن إقبال والقرآن، ثمّ دعي
في سنة 1408 ه/ 1988 م مع زوجته، وكرّمه وزير الإعلام. كما أقام له نجل إقبال (جاويد)- والذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة العليا حينئذٍ- وليمة في داره. أمّا الرئيس الباكستاني ضياء الحقّ فقلّده وساماً، وعانقه أمام عدسات التلفزيون حتّى ترقرق الدمع في عينيه تأثّراً بالموقف. لقد قلّد الرئيس غيره في هذا الحفل أوسمة واكتفى بمصافحتهم واختصّ الدكتور حسين بالعناق.
كما دُعي مجيب إلى مدينة قرطبة بإسبانيا للاشتراك في مؤتمر أُقيم عن إقبال، وكان الأوحد الذي ألقى بحثه عن «إقبال والتصوّف» بالإنجليزية مرتجلًا دون قراءة في الورق.
يضاف إلى ما سبق من تكريمه في الخارج أن منحته جامعة مرمرة الدكتوراه الفخرية عام 1416 ه/ 1996 م، ودعته لتقدّمها إليه في الجامعة، لكنّه اعتذر عن عدم السفر؛ لأنّه كان قد فقد نعمة البصر، فسلّمت إليه في السفارة التركية بمصر في حفل ألقى فيه قصيدة نظّمها بالتركية مع ترجمتها بالعربية.
يقول عنه الدكتور القاعود: «عرفت الرجل قبل ثلاثين عاماً أو يزيد، ولعلّ الذي عرّفني به صديقي الأديب الكبير الأُستاذ وديع فلسطين، وفي شارع الملك الأفضل بالزمالك التقيت بالرجل، وكان لما يزل فيه بعض حيوية، ولكنّه شكا إليّ ضعفاً في بصره الذي فقده فيما بعد، ممّا اضطرّه إلى استئجار مَن يقرأ له ويكتب.
كان رحمه الله يتحرّك في غرفته نشطاً، يطلعني على بعض الكتب، ويحدّثني في بعض القضايا. ومع أنّي لم أمكث طويلًا فقد خرجت ببعض كتبه القيّمة ودواوينه الشعرية، وانطباع بتواضع الرجل وإخلاصه للعلم والبحث والأدب دون أن يهتمّ بعرض الدنيا ومتاعها الزائل. فقد كان يقدّم إنتاجه العلمي والأدبي لبعض الناشرين ولا يتقاضى مقابلًا، اللهمّ إلّا بعض نسخ الهدايا التي يدفعها إلى الصحفيّين والكتّاب، لعلّ بعضهم يتفضّل بكتابة خبر في سطرين أو ثلاثة عن إصداره الجديد. كان يهمّه أن ينشر الكتاب بدلًا من البقاء حبيس أدراج مكتبه، في الوقت الذي تقوم المؤسّسات الرسمية بنشر كتب سطحية إنشائية مليئة بأخطاء النحو والصرف والتركيب، وقد تكون معادية لدين الأُمّة وأخلاق المجتمع، وتكافئ
أصحابها بمكافآت سخية!
لم يكن الرجل يتقن فنّ العلاقات العامّة الذي صار يتقنه أشباه الأُدباء والكتّاب، فتناساه من بيدهم الشهرة والتلميع. وهو في حقيقة الأمر لم يكن باحثاً عن هذا أو تلك ... فقد كان يريد أن يصل إلى الناس بكتاباته وبحوثه وأشعاره، مثلما يفعل أيّ شخص من المنتسبين إلى المؤسّسة الرسمية للثقافة أو الذين ترضى عنهم هذه المؤسّسة. لذا لم يرشّح لأيّة جائزة ثقافية في بلده لا تشجيعية ولا تقديرية، مع أنّه بمنطق العلم والأدب يستحقّ أن ينال أعلى جائزة يمنحها الوطن. ومن المفارقات فإنّ دولًا إسلامية عديدة منحته جوائزها الكبرى ودرجة الدكتوراه الفخرية كما فعلت جامعة مرمرة في تركيا، والحكومة الباكستانية، ودولة قازاخستان وغيرها... إنّ الاحتفاء بالرجل خارج بلاده وإهماله في وطنه أمر شديد المرارة بالنسبة لرجل أخلص للعلم والأدب، ولم يبحث عن مكاسب مادّية أو منافع شخصية، بل كان ينفق من دخله المحدود على متطلّبات العلم والبحث والنشر والترجمة.
وفي الوقت الذي نرى فيه أُدباءً وكتّاباً محدودي القيمة الأدبية والثقافية على خريطة الأبحاث في الدراسات العليا بالكلّيات المختلفة، فإنّ حسين مجيب المصري لم يُطرح موضوعاً لرسالة ماجستير أو دكتوراه، والأمر نفسه فيما يتعلّق بالحياة الثقافية، فلم يتناوله أحد من الكتّاب أو النقّاد، باستثناء بعض المقابلات القليلة القصيرة والمقالات، وكتاب وحيد أصدره صلاح حسن رشيد بعنوان: «حسين مجيب المصري... تجربة فريدة في الشعر العربي الحديث»، أصدرته مكتبة الآداب بالقاهرة عام 2004 م.
لقد تعرّض لظلم كبير في عمله بالجامعة أيضاً. ويبدو أنّ هذا قدر الذين يعكفون على العلم والبحث، فيظلمهم أهل «الفهلوة» والباحثون عن الدنيا والوجاهة والمناصب، ولا ريب أنّ ذلك كلّه قد أصابه بالإحباط، وخلّف في نفسه كثيراً من الأسى نراه عبر مقطوعات شعرية تقطر ألماً، ومنها:
أنا من خبت في سعيي
أنا من حرت في أمري
غثاء ضاع في سيل
وطير ضلّ عن وكر
هباء بين أرواح
ودمع سال في البحر
كلا من رجع أوتار
ولكن أين من يدري
وشعري نفح أزهار
ولكن من يرى شعري؟!».
لقد أنتج الرجل عشرات الكتب التي زادت عن السبعين كتاباً، منها: صلات بين العرب والفرس والترك، رمضان في الشعر العربي والتركي والفارسي، إقبال والقرآن، إقبال بين المصلحين الإسلاميّين، المولد النبوي في الأدب التركي، القدس بين شعراء الشعوب الإسلامية... فضلًا عن الكتب التي حقّقها وراجعها، ومئات الرسائل الجامعية (ماجستير ودكتوراه) التي أشرف على أصحابها. وله أيضاً ستّة دواوين شعرية، هي: شمعة وفراشة، وردة وبلبل، همسة ونسمة، موجة وصخرة، شوق وذكرى، حسن وعشق.
لقد ظلّ حتّى آخر أيّام حياته يعمل بجدّ ودأب، وكان آخر كتاب ينوي نشره هو «بدائع إقبال في الأوردي»، وآخر كتاب كان ينوي أو يعمل في تأليفه كان حول المقارنة بين المدائح النبوية في الآداب الثلاثة: العربية والتركية والفارسية.
وكان يقول: «لا أستطيع أن أتخلّى عن القراءة والكتابة؛ فهما بالنسبة لي كالماء والهواء».
توفّي حسين مجيب يوم السبت الثامن والعشرين من شوّال 1425 ه الموافق للحادي عشر من ديسمبر 2004 م.
المراجع
(انظر ترجمته في: وجوه عربية وإسلامية: 36- 41).