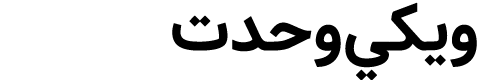الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محمود فيّاض»
(محمود_فيّاض ایجاد شد) |
(لا فرق)
|
مراجعة ٠٠:٣٣، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠
| الاسم | محمود فيّاض |
|---|---|
| الاسم الکامل | الدکتور محمود فيّاض |
| تاريخ الولادة | |
| محل الولادة | |
| تاريخ الوفاة | |
| المهنة | أُستاذ مصري، وداعية تقريب |
| الأساتید | ثبت نشده |
| الآثار | ثبت نشده |
| المذهب |
الدكتور محمود فيّاض: أُستاذ مصري، وداعية تقريب.
كان يعمل خلال سنة 1949 م أُستاذاً لمادّة التاريخ الإسلامي بكلّية أُصول الدين بالأزهر الشريف. وقد كتب عدّة مقالات في مجلّة «رسالة الإسلام» القاهرية الصادرة عن دار التقريب بين المذاهب الإسلامية.
يقول ضمن مقالة له بعنوان «التقريب واجب إسلامي» ما نصّه: «تحدّثت إلى القارئ الكريم في الأعداد الماضية عن عناصر وجود الأُمّة الإسلامية، وقد كان هذا البحث صدى لقول اللَّه جلّ شأنه: «إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ» (سورة الأنبياء:
92).
ولعلّ القارئ الكريم قد لمس الحقائق الرائعة التي عبّر عنها القرآن العظيم بدعوته إلى
الوحدة، ووحدة المعبود، ووحدة الأصل، ووحدة الأُمّة، ووحدة الأهداف... وقد رأى القارئ كيف ينطق القرآن صريحاً بتكليف الأُمّة الإسلامية بمختلف التكاليف، ويقرّر مسؤوليتها عمّا كلّفت به، مسؤولية حقيقية تشمل الفرد بوصفه فرداً، وبوصفه عضواً في الأُمّة، وأنّ أفراد الأُمّة متضامنون في تحمّل هذه المسؤولية واحتمال تبعاتها... ورأى القارئ أنّ أولياء الأمر في هذه الأُمّة هم علماؤها وقادة الفكر فيها، وأنّهم أوّل من تقع عليه المسؤولية، وأنّهم محاسبون أمام اللَّه وأمام ضمائرهم وأمام الأُمّة عن سعادة المجموعة التي من شأنهم أن يوجّهوها إلى الخير بوصفهم عنوان الأُمّة، وأهل القدرة على الاستتباع، والقدوة الحسنة للمؤمنين بعد الرسول صلى الله عليه و آله، وأهل القيادة الرشيدة الذين يتوخّون صلاح الأُمّة ويعملون على توجيهها إلى ما فيه صلاح الجميع، فهم هداة يجلسون على أرفع مكان فوق القمّة، يقولون الحقّ لا يسألون الناس عليه أجراً، ويأمرون بالعرف، وينهون عن المنكر، ليس عليهم سلطان إلّالربّ العالمين في الأمر والنهي، فإن قصّر هؤلاء القادة أو اهملوا واجبهم فهم آثمون أو غاوون: «وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ» (سورة الأعراف: 175).
على أنّ تقصير القادة- إن أعذر بعض أفراد الأُمّة- لا ينجي الأُمّة نفسها من المسؤولية العامّة التضامنية التي تجمع أفرادها فيما يشبه سلسلة متساوية الحلقات لا يدري أين طرفاها؛ لأن الإسلام يسر لا غموض في مبادئه، وليس فيه أسرار يختصّ بها العلماء والقادة دون العامّة: «وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» (سورة القمر: 17).
ولقد أهمل قادة الفكر الإسلامي واجبهم، ولم يؤدّوا للأُمّة ولا للَّهما عليهم، في عصور مضت- معذورة أو غير معذورة- طبعت بطابع الجمود، وخيّم عليها الهوى، وتحكّمت فيها الشهوات السياسية، فاستخدم العلم فيها لتركيز الدول وتأييد مذاهب الحكّام في إسراف بعيد عن حقائق الدين وروح الإسلام، فتفرّقت الأُمّة شيعاً وأحزاباً «كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» (سورة المؤمنون: 53)، فاحتربت في سبيل سيادة بعض عناصرها لا في سبيل اللَّه، ونقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثاً، وقطعت الأرحام، وسادت فيها العصبيات الجنسية
وحلّت محلّ الأُخوّة الإسلامية، كما ساد التعصّب المذهبي وحلّ محلّ الحرّية الفكرية التي قرّرها القرآن العظيم، وأطلّت السياسة من ثغرات الأهواء على أهل العلم، فرسمت لهم مناهج البحث لتأييد ما يريدونه، بدل أن يوجّه العلماء بأبحاثهم أهل السياسة إلى وسائل الخير وسبل الإصلاح، فحجروا على العقول وقيّدوها بما يشبه العقيدة، وزعموا أنّ للاجتهاد باباً فأغلقوه؛ حتّى لا ينظر أحرار الفكر من خلاله في صوالح الأُمّة، فجعلوا الدين إرثاً وتقليداً، لا عقيدة يؤمن بها المسلم عن طريق الفكر والاقتناع، وبذلك يصدق قول القائل: «إنّ المسلمين غير مؤمنين»، وصحّ وصف الإمام الشيخ محمّد عبده للمتعلّمين ب «أنّهم يتعلّمون كتباً لا عملًا»، ووقف رجال المذاهب الإسلامية جامدين على مذاهبهم، حتّى خيّل جمودهم لبعض الغربيّين أنّ هذه المذاهب في الإسلام تشبه الأناجيل في المسيحية، أي: أنّه خلاف في جوهر الدين وحقائقه الأصلية، لا في الأعراض والفروع!
ولعلّ القارئ الكريم يشاركني في القول: بأنّ صلاح هذه الأُمّة الإسلامية اليوم منوط بصلاح علمائها وقادة الفكر فيها، فهم منها بمثابة القلب، إن صلح صلح الجسم كلّه، وإن فسد فسد الجسم كلّه، وإنّه لفرض على علماء الإسلام وقادة الفكر فيه أن يعملوا على جمع شتات أُمّتهم ولمّ شعثها في هذه الأيّام العصيبة التي تحيطهم فيها الأخطار من كلّ جانب؛ ليتعارف المتناكرون، ويتواصل المتقاطعون، وليعودوا يداً على من سواهم، يسعى بذمّتهم أدناهم، متعاونين على رفع لواء الإسلام وإعزاز مكانة بنيه بين الأُمم، وإنّ أيسر وسيلة لجمع الكلمة هو التقريب بين المذاهب الإسلامية.
وقد سأل سائل: وكيف يمكن هذا التقريب مع اختلاف المذاهب في الأُصول والفروع، لا في الفروع فقط؟
ولعلّه قد خيّل للبعض أنّ المراد بالتقريب هو مزج الآراء وإدماج المذاهب حتّى تكون مذهباً واحداً، وما كان لعالم أو جماعة من العلماء أن يحجروا على عقول دعاها اللَّه إلى النظر في ملكوته، أو يقصروا الناس على إحدى طرائق الفهم أو بعض وسائل النظر! وإذاً فما هو التقريب؟ إنّه: دعوة إلى التعاون على البرّ والتقوى وإصلاح أحوال المسلمين بتوجيه طاقتهم
العامّة وجهة واحدة تحقّق سعادة الجميع، أو تؤمّنه من أخطار خارجية. وجزى اللَّه عنّا خيراً الإمام الشيعي الجليل الشيخ آل كاشف الغطاء، فقد وضع في بيانه القيّم للمسلمين في العدد الماضي الأُمور في نصابها، وجلى معنى التقريب تجلية تدفع كلّ لبس في الفهم، فأغناني عن كلّ ما أعددته في معنى التقريب (شَكَر اللَّه للعلّامة الكبير غيرته المحمودة على الملّة والأُمّة)، فما أروع كلمات الحقّ التي أرسلها لتبسيط دواعي الخلف بين المسلمين! إذ يقرّر أنّ الخلاف بين المذاهب ليس خلافاً على جوهر الدين وأُصوله، وإذاً فهو خلاف في الفروع لا يستوجب القطيعة، ولا يحلّ معه التنابز، هو خلاف معتاد يقع دائماً بين الإخوة على الوسائل الموصلة للهدف الذي ينشدونه، وهو واقع بين المذاهب الشيعية المختلفة، كما هو واقع بين المذاهب السنية المختلفة».
كما يقول من مقالة له بعنوان «التاريخ والتقريب»: «حملت إلينا «رسالة الإسلام» كثيراً من الآمال التي ينشدها من زمن بعيد كلّ مسلم غيور على دينه وعزّته. وإنّا إذ نحييها نرجو أن تكون عامل حياة وقوّة للأُمّة الإسلامية ودعامة من دعائم وحدتها التي تعيد إليها عزّتها وتهديها إلى الرشد في شعاب الحياة وسبلها المختلفة.
وإنّي لأشهد أنّ الأقلام الرفيعة التي دبّجت صفحاتها قد أروت الظمأ، ورسمت منهج الوحدة مستقيماً غير ذي عوج... ولكن التاريخ! التاريخ صانع الشعوب، وباني الوحدات، التاريخ الذي لجأت إليه الشعوب المتحضّرة في عمليات البناء والتوجيه والبعث، فوصلت إلى ما وصلت إليه... هذا التاريخ الإسلامي لا يمكن الإغضاء عنه في التقريب، إلّاإذا كان هو المقصود الأوّل: «وحدة الثقافة». فتاريخنا المدوّن خضع لكثير من عوامل الترغيب والترهيب، فجاء مفرّقاً للجمع، لا جامعاً للشمل! ولا أحسبني مغالياً إذا حمّلت التاريخ الإسلامي المدوّن وكتّاب التاريخ الأقدمين والمحدّثين معظم التبعة في الجفوة التي ظلّت قائمة بين شعوب الإسلام، هذه الجفوة التي تدفع المصلحين اليوم من أئمّة المسلمين إلى محاولة التقريب بين المذاهب لتقترب الشعوب... كذلك لا أحسبني مغالياً إذا قلت: إنّ التاريخ الإسلامي ودراسته على أُسس جديدة بعيدة عن التعصّب والزيف كفيل بالتقريب
بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم.... فهل لنا أن نعيد كتابة تاريخنا بعد تخليصه من الشوائب وتنقيته من أكدار الوقيعة ولوثة العصبية، ونتحرّى في كتابته الدقّة وفق أصحّ أو أرجح ما يتّفق والحقيقة التي أعتقد أنّها ستجمعنا على كلمة سواء! وهل آن لنا أن ندرس علوم الشيعة ويدرس الشيعة علومنا على منهج علمي صحيح لا تحيّز فيه ولا محاباة؟! أرجو أن يهتمّ المسؤولون بذلك، فإنّهم لو فعلوا ما يوعظون به لكان قاضياً على أسباب الكراهية والنفرة والجفوة بين المسلمين، ولاستطعنا أن نوجد عند الأُخوة المتعلّمين روحاً من المحبّة والأُلفة، ونظر كلّ إلى الآخر نظرة الإسلامية لا طائفية «إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا» (سورة الكهف: 30)».
وأخيراً يقول أيضاً: «وبهذه الأُخوّة التي قررّها الإسلام بين بني الإنسان جميعاً في النصوص السالفة، وبالأُخوة الخاصّة التي أقامها بين المؤمنين الموحّدين والتي تظهر جلية في قول اللَّه تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (سورة الحجرات: 10)، وقول الرسول صلى الله عليه و آله:
«المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله»، «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشّد بعضه بعضاً»، بهذا كان الإسلام منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً أوّل مقرّر لفكرة «العالمية» التي تهدف إلى جمع البشر في نطاق الأُخوّة الإنسانية، و «الزمالة» العالمية لخدمة الإنسانية كلّها، ولصالح السلام العامّ، بصرف النظر عن الأجناس والألوان والأحساب والأنساب، وقضى بذلك على عوامل التعصّب وأسباب الحروب القومية، وضمن للبشرية- إذا اتّبعته- حياة أمن وحرّية ورخاء وسلام.
وقد طبّق رسول اللَّه محمّد صلى الله عليه و آله هذا المبدأ الجديد عملياً في المحيط العربي، فحوّل شتات العرب جمعاً ووحدة، والعداوة القبلية أُلفة ومحبّة، وربط بالإسلام بين قلوب الناس، ووحّد أهدافهم، كما حوّل «العصبية القبلية» الداعية إلى التفرّق والضعف إلى «قومية دينية» هي «القومية الإسلامية»، وأذكى هذا الروح القومي ليتعاون مع مبادئ الإسلام في بناء الوحدة الإنسانية على أُسس من العدل والإنصاف لا على الظلم والعدوان، ثمّ وجّه صلى الله عليه و آله طاقة هذه القومية لخدمة الإسلام ورعاياه بلا تمييز ولا تفريق، وحمّلها أمانة تبليغ الإسلام
إلى جميع شعوب الأرض، وأفهم العرب أنّ دين اللَّه عامّ خالد لجميع عباده، وأنّ خلق اللَّه أمام اللَّه سواء كأسنان المشط.... إنّي أعتقد أنّنا نستطيع العودة إلى رحاب القومية الإسلامية عن طريق وحدة الثقافة، والتقريب بين المذاهب الفقهية، والقضاء على الخلافات الطائفية، وحسن التوجيه السياسي... وعلى «رسالة الإسلام» أن تفهم المسلمين أنّ مذاهبهم الفقهية تشبه تماماً المذاهب الفلسفية في الدول الأُخرى التي لا تلتقي عند هدف ولا يجمع بينها إلّا الشيطان، ومع ذلك لم تفرّق جمعاً، ولم تقض على قومية؛ بينما تلتقي المذاهب الإسلامية كلّها تحت راية القرآن، عليها أن تفهمهم ذلك في شأن الفقه وأن تفهمهم في شأن العقائد أنّ اللَّه كلّفهم الإيمان بأُصول بيّنها لهم بياناً شافياً قاطعاً، ولم يدعها لاختلافاتهم واجتهاداتهم، ثمّ أطلق لهم عنان البحث والنظر فيما وراء ذلك، على ألّاينكروا نصّاً، ولا يخرجوا عن أصل قاطع، ولا يعارضوا حكماً علم من الدين بالضرورة، فإذا كان هذا شأنهم وكان الأمر فيه متفّقاً عليه بين ذوي العلم والبصيرة فيهم فإنّ أمر الخلاف لا يضرّ، وإنّ اعتناق كلّ طائفة ما تعتنق من رأي لا ينبغي أن يحول بينهم وبين التعارف والتآلف والتعاون على البرّ والقتوى، واتّخاذ «القومية الإسلامية» شعارهم الأوّل وغرضهم الأسمى، فإنّ الزمان لا ينظرهم، والأعداء لا يحكمون في خلافاتهم ليصلوا إلى حقّ ينصرونه أو باطل يقمعونه، ولكنّهم يحكمون عليهم جميعاً بعدم الصلاحية للتقدّم وتسنّم منازل الشرف، فيضربونهم جميعاً ويهلكونهم جميعاً!».
المراجع
(انظر ترجمته في: مجلّة «رسالة الإسلام»/ العدد: 3 من السنة الأُولى/ صفحة: 286/ والعدد: 1 و 4 من السنة الثانية/ صفحة 80 و 318، كشّاف مجلّة «رسالة الإسلام»: 119).