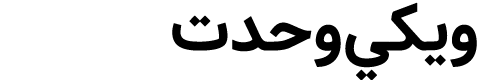الوحدة الحقيقية
الوحدة الحقيقية: هناك دواعٍ لما حصل بين المسلمين من خلاف، فما أجمل أن يقف الإنسان عليها بكل حياد وتعقل، مدركين مستشعرين أن المهم هو ظهور النهج الإسلامي الحنيف، وليس غلبة هذا الاتجاه أو ذاك، وأن الوحدة والإتفاق على الحق الصريح هو الذي سيضمن اجتماع المسلمين وائتلافهم. وأمّا تعصّب كلّ مسلمٍ إلى فرقته، والذي هو عادة ورثها عن آبائه ونشأ عليها وتشرّبت بها عروقه فلا يزيد المسلمين إلاّ باعداً عن بعضهم، وابتعاداً عن المحجة البيضاء، والشريعة المحمدية السمحة.
الوقوف أمام المفاهيم الدينية والحقائق التاريخية
يستطيع المسلمون أن يقفوا أمام حقائق الدين والتاريخ وقفة حياد تام كما يقفون أمام الظواهر الكونية والنظريات العلمية في الفيزياء والكيمياء والفلك وطبقات الأرض. لماذا يقف المسلم أمام العلوم التجريبية بحيادٍ تامّ، فيما لا يعرف شيئاً من ذلك الحياد تجاه المفاهيم الدينية والحقائق التاريخية؟
لم يكن السّر في ذلك هو اختلاف طبيعة الحقائق الدينية والتاريخية عن طبيعة الحقائق التجريبية، إنّما السر في أن الإنسان المسلم قد تبنّی مواقف مسبقة تجاة القضايا الدينية والتاريخية، وهذه المواقف المسبقة هي التي تتحكم في طريقة تلقيه للقضايا والحقائق، بينما لم يكن نفس الموقف تجاه القضايا التجريبية.
ومن مزايا هذه المواقف المسبقة أنه أضاف صفة القداسة على كثير من المفاهيم والأشخاص، وهذه القداسة تسبّب سدّاً منيعاً دون تقبّل أيّة حقيقةٍ تهدم تلك المواقف المسبقة وتنال من هذه القداسة! هذا مع أن المنهج الذي رسمه الإسلام للحوار والبحث العلمي قد ألغی أيَّ نوعٍ من القداسة للمفاهيم وللأشخاص، وفتح أبواب البحث العلمي حتّى حيال اقدس المبادئ والمفاهيم، إلاّ وهو مبدأ التوحيد. فحين رد القرآن الكريم على الّذين جحدوا مبدأ التوحيد لم يصدمهم أولاً بالقداسة، ولم يهول عليهم التشكيك حتّى أتى بالحجة والبرهان القاطع.
قال تعالی: ﴿...وما كان معه من إله إذاً لذهب كلّ إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض...﴾ [١] فبعد أن قدّم البرهان العلمي الثابت حقّ له أن يبدي ما لهذا الأمر من قداسة، فقال: ﴿... سبحان الله عما يصفون.عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون﴾[٢]
ومثل هذا الأسلوب جاء أيضاً في قوله تعالى: ﴿أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما إلهة إلاّ الله لفسدتا...﴾ وبعد هذا البرهان القاطع قال: ﴿فسبحان الله رب العرش عما يصفون﴾[٣]
أما النقاش في مبدأ المعاد واليوم الآخر فقد بسط القرآن الكريم فيه القول وفصل وأجاب على الشبهات بأنواع شتى من البراهين، وكذلك الحال مع مبدأ النبوة والكلام في صدق الأنبياء ورسالاتهم، ففي كلّ هذه المبادئ التي تمثل أصول الدين، ولا دين إلاّ بها، لم يصدم القرآن المعاندين بالتهويل والتكفير حتّى ساق الحجج ودافع عن هذه المبادئ والمفاهيم بالبراهين العقلية القاطعة ليوقفهم على حقيقة واضحة وضوح البديهيات التي لا يتنكر لها إلاّ معاند يعشق اللجاجة والجحود.
وكل شيء من العقائد الإسلاميّة هو دون هذه العقائد الثلاث بلا شك، وبلا أدنى خلاف.
إذن لنا كلّ الحق في مناقشة ما هو دون ذلك، ومعنا في حقنا هذا: القرآن و السنة.
نحن نعتقد بعصمة القرآن وعصمة السنة وبأن للتاريخ مساراً ما.
ولكننا نعود فنفرض آراءنا المذهبية على القرآن، فتظهر له معان شتى ووجوه مختلفة وأهداف متناقضة !. ونفرض آراءنا المذهبية على السنة، فتظهر وكأنها سنن شتى، لا سنة واحدة، ونفرض أهواءنا على التاريخ فنصدق منه ما وافقها، ونكذب بما خالفها!
إنّ هذا يعنى أننا في الحقيقة إنّما اعتقدنا بعصمة أهوائنا وآرائنا المذهبية، فجعلناها حاكمةً على كلّ شيء، لا على حقائق الأحداث فقط، بل على القرآن والسنة أيضاً !
وهذا هو السر في نمو النزاع واستفحاله وتفشيه.
هناك مصدر آخر اتخذنا منه أحياناً مصدراً من مصادر العقيدة، ومنحناه العصمة لا ليكون موازياً للقرآن والسنة، بل ليكون حاكماً عليهما.
لقد عمدنا إلى مرحلة من مراحل تاريخنا بعد الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ فأضفينا عليها القداسة التامة ومنحناها سمة العصمة، فعمدنا إلى كلّ ما لا ينسجم مع شيء من تفاصيلها من القرآن والسنة نأوله لنصرفه عن ظاهره لكي لا يصطدم مع هذا الأمر الواقع أو ذلك. نعم لو تحقق الإجماع فعلاً على مسألة ما، لكان حجة علينا، ولكن لا يصح أن ينظر إلى الأمر النافذ بالفعل على انه إجماع دائماً!
جذور النزاعات
لقد ابتدأ النزاع في هذه الأمة سياسياً، ثم كان من شأن السياسة أن تقود هذا النزاع إلى ميادين الفكر والاجتماع الأخرى، حتّى توالت على الأمة عهود تتابع فيها حاكمون يتبنون اتجاهاً واحداً يتعصبون له ويوفرون له الحماية وأسباب الانتشار ويواجهون بالعنف كلّ اتجاه آخر.
ثم وجدوا لهم في كلّ عصر رجالاً ممن عرفوا بالفقه فقاموا بالتقرب إليهم واجتهدوا في توطيد سلطانهم بها فتعاظم الشرخ بين فصائل الأمة، وترسخت الحواجز بعد أن أصبحت حواجز دينية بين فئة تعيش في ظل السلطان ثم تمنحه الشرعية في سياساته ومقاصده، وفئات أخرى يطارد رجالها ويؤذى كبراؤها وربما يقتلون ويحجر على أفكارهم وكتبهم.
يقول الإمام الغزالي: «إنه لما انقرض عهد الخلفاء الراشدين أفضت الخلافة إلى قوم تولوها بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام، فاضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم. وقد كان بقي من العلماء من هو مستمر على الطراز الأول وملازم صفو الدين، فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضوا، فرأى أهل تلك الإعصار عز العلماء وإقبال الأئمة عليهم مع إعراضهم، فاشربوا لطلب العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه، فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين، وبعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم، إلاّ من وفقه الله»[٤]
والحق أن هذا لم يكن وقفاً لجماعة واحدة دون سواها، فصحيح انه استغرق الحقب الأطول والأوسع والأشمل لصالح مذاهب الجمهور على أيدي الأمويين واغلب الخلفاء العباسيين ثم السلاجقة والأيوبيين، إلاّ أن الطوائف الأخرى كان لها دورها أيضاً، فكان لـ المعتزلة دور أيام المأمون والمعتصم، ولـ الشيعة دور أيام البويهيين، ولـ الإسماعيلية دور أيام الفاطميين، وأنه وإن اختلفت تلك الأدوار في المساحات الزمانية والمكانية ودرجة التطرف وحجم الأضرار، فإن الموضوع واحد في آثاره الاجتماعية الأدبية والدينية.
تلك الأجواء كانت السبب المباشر في ظهور الأخبار المكذوبة والأحاديث الموضوعة والعقائد والدخيلة، التي تسلحت كلّ فرقة بطائفة منها ورمت خصومها بطائفة أخرى.
فهل ذهبت تلك النزاعات ودرست مع الزمن واختفت آثارها؟
إنّ الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن أحد أن تراثنا الموجود بين أيدينا إنّما جمع وصنف في تلك الأحقاب، لا غير. كلّ تراثنا الّذين نقرأه في الحديث، في التفسير، في الفقه، في الأصول، في العقائد، في التاريخ، لكنه تراث تلك العهود عهود النزاع السياسي والمذهبي.
إذن لا مناص من أن يأتي تراثنا محملاً بتلك الآثار الخطيرة. وهذه هي الحقيقة التي طغت على تراثنا الإسلامي؛ هذه الحقيقة هي أول ما ينبغي أن نقف عندها، لا لأجل التقريب بين المذاهب فقط، بل على طريق المطالعة الحرة أيضاً، أو على طريق الدرس والتلقي، أو التحقيق أو التصحيح.
ثم ليس من حقنا أن ننتظر أية فائدة ترجى من وراء هذه الوقفة ما لم يصاحبها شرطان متلازمان على طول الطريق وحتى النهاية، وهما:
1 ـ الجد في التأمل والنظر والمتابعة.
2 ـ الحياد التام في التعامل مع المفاهيم والأحداث إيماناً منا بأن التقريب لا يتحقق إلاّ عن طريق التصحيح. فالتقريب ثمرة شجرتها التصحيح.
وسوف ننتخب لهذا البحث ثلاث موضوعات، نتناول المصادر الأساسية لكل منها، ونسلط الضوء على جذور النزاع فيها. وسوف نرى في النهاية أن أسباب الخلافات والتباعد بين المسلمين، ومادة تلك الخلافات هي تلك المجموعة من الأخبار المكذوبة والأحاديث الموضوعة والعقائد الدخيلة التي أفرزتها أيام الصراع السياسي ثم أخذت تنمو وتنتشر حتّى دخلت في صلب عقائد المسلمين.
وهذه الموضوعات الثلاثة التي انتخبناها هنا هي: التاريخ، والحديث، والتفسير.
وجهة النظر التي تبتني عليها الوحدة
قبل الدخول في التفصيل نوجز وجهة النظر التي نتبناها في هذا الموضوع، فنقول:
1 ـ إنّ التقريب ثمرة طبيعية للتصحيح، فكما لا يمكننا أن ننتظر ثمرة تنتج بلا شجرة، لا يمكننا كذلك أن ننتظر للتقريب وجوداً ومعنى دون أن نقطع أشواطاً مهمة على طريق التصحيح.
وكما أن جودة الثمرة ورونقها يتوقف على مقدار العناية بالشجرة وتوفير أسباب نموها وحفظها من الآفات، فكذلك هو المستوى المرجو من التقريب، فإنه يتوقف على المقدار المنجز من التصحيح ودرجة نقائه.
2 ـ إنّ التصحيح ثورة حقيقية، ولا يجرؤ على تقحم نيران الثورة إلاّ الثوريون فالثوريون هم الّذين امتلؤوا استعداداً لتقديم الغالي والنفيس على طريق الثورة ولا يشغلهم عن أهدافهم ما سيفقدونه من راحة ونعيم وأموال وبنين وأهل.
وكذلك من أدرك أن التصحيح ثورة، ومضى على طريقه، فلن يوقف مسيرته ما يراه من تساقط الكثير من المعلومات والمفاهيم التي كان قد ورثها وقرأها وترسخت في ذهنه وأصبحت جزءاً من عواطفه، وربما أصبحت جزءاً من وجوده الاجتماعي أيضاً، لا يهمه أن يرى ذلك كله يتساقط على طريق التحقيق العلمي الدقيق.
إنّ التصحيح بهذا المعنى سيمر من خلال ثورتين:
ثورة على التراث، تثير كوامنه وتكشف حقائقه.
تسبقها ثورة على أوامر عوجاء أو معكوسة شدتنا إلى هذا التراث شداً مغلوطاً حال حتّى دون الإذن بمناقشته.
وهذا لا يعني أننا نستنكر أي نوع من الارتباط العاطفي بالتراث، كلا، فإن الارتباط العاطفي الصحيح المشذب ضروري جداً في ثبات العقيدة.
بعد هذا الإيجاز ننتقل إلى شيء من التفصيل في الميادين الثلاثة التي انتخبناها من بين ميادين التراث الواسعة، بغية فتح أبواب الحوار على طريق التصحيح الذي سوف يكون التقريب ثمرة طبيعية من ثماره.
والآن كما قلنا ننتخب لهذا البحث ثلاث موضوعات، وهذه الموضوعات الثلاثة التي انتخبناها هي: التاريخ، والحديث، والتفسير.
1. التاريخ
حين يُعنى بتدوين تاريخ أمة وقد ظهرت فيها الاختلافات، وتوزعت أبناءها المذاهب، وتغلبت الأهواء التي تفرض هيمنتها في صياغة أفكار الناس ورؤيتهم للأحداث، عندئذ أين سيقف التاريخ؟
هل سيكون بعيداً عن معترك الميول والأهواء، منفصلاً عن قيود الزمان والمكان ليسجل الأخبار والأحداث كما هي تماماً، وبكامل أسبابها ومقدماتها وتفاصيلها وما خلفته من آثار، يسجلها كما هي قبل أن تنفعل معها الميول والأهواء؟
لا شك أن هذا هو الأمل المنشود، وهو الذي تقتضيه الأمانة للتاريخ وللحقيقة ولكن لا شك أيضاً أن التاريخ لم يكتب في الفضاء، ولا كان المؤرخ يستقل بساطاً سحرياً يقله فوق آفاق زمانه ومكانه.
إنه يكتب من على الأرض، وفي زمان ما ومكان ما.
وإنه يكتب ما يسمع وما يرى.
وإنّما يحدثه رجال لهم حيال الأحداث مواقف وميول، فهو لم يسمع في الحقيقة حدثاً مجرداً، وإنّما سمع الحدث ممزوجاً بانفعالات الناقلين، والمورخ نفسه هو واحد من أولئك البشر، يعيش في عصرهم... كما وان لكل عصر لونه ونغماته.
وحين يكون عصر من العصور قاسياً في مواجهة ما لا يتفق ونغماته، فإنما جاءت قسوته من أناسه؛ فالمورخ يكتب حين يكتب وهو يرى عيون الناس وكأنها ترصد أفكاره، وتحصي عليه حتّى مالم يرد بحسبانه !
ففي أحوال كهذه هل يبعد أن يكون المورخ منساقاً من حيث يدري أو لا يدري لواحدة أو أكثر من تلك المؤثرات الواقعية؟
عندئذ سوف يقتطع من الحقيقة التاريخية أجزاء مساوية لمقدار ذلك الانسياق.
ولعل هذا هو أضعف الأخطار الثلاثة التي قد تتعرض لها الحقيقة التاريخية...
أما الخطر الثاني: فيتمثل بالانسياق التام مع نغمات العصر وأهواء أهله.
وأما الخطر الثالث: فيتمثل في كون المؤرخ نفسه من أصحاب الأهواء الّذين لا يقبلون إلاّ ما وافق أهواء هم، ولا ينظرون إلى الأحداث إلاّ بمنظار الهوى.
بعد هذا، فإن التاريخ الذي سيكتبه هذا المؤرخ أو ذاك سوف يصبح مصدراً لثقافة الأجيال، تستقي منه رؤيتها للتاريخ التي ستساهم مساهمة فعالة في صياغة عقائدها.
فحين يجتمع الناس على واحد من هذه المصادر التي استجابت لبعض تلك
المؤثرات على حساب الحقيقة التاريخية ن فمن البديهي أن تحمل أذهانهم برؤى مغيرة للحقيقة.
ومن هنا تتسرب العقائد الدخيلة إلى الأذهان، فيعتقد الناس بأشياء ومفاهيم ليست هي من الإسلام ومفاهيمه الحقة، وهم يظنون أنها الحق.
وسوف لا يكون العوام وحدهم ضحية هذه الخطيئة، بل العلماء أيضاً حين يوقفون علومهم اعتماداً على هذه المصادر دون محاكمة وتمحيص.
كيف اجتازت عيون التاريخ الإسلامي تلك الأجواء والمؤثرات لتحفظ لنا حقائقه؟
لا شك أن الوقوف على المشاهد الحية لإثبات حقيقةٍ ما هو أهم بكثير من البحوث النظرية والبراهين الفلسفية. وهذا ما سنبينه هنا.
مشاهد حية
المشهد الأول
قال الزبير بن بكار: قدم سليمان بن عبد الملك إلى مكة حاجاً سنة 82هـ، فأمر أبان بن عثمان أن يكتب له سير النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ ومغازيه. فقال له أبان: هي عندي قد أخذتها مصححة ممن أثق به.
فأمر سليمان عشرة من الكتاب بنسخها، فكتبوها في رق، فملا صارت إليه نظر فإذا فيها ذكر الأنصار في العقبتين وفي بدر، فقال: ما كنت أرى لهؤلاء القوم هذا الفضل، فإما أن يكون أهل بيتي غمصوا عليهم حقهم،وإما أن يكونوا ليس كذلك!
فقال له أبان: أيها الأمير، لا يمنعنا ما صنعوا أن نقول بالحق، هم على ما وصفنا لك في كتابنا هذا.
فقال سليمان: ما حاجتي إلى أن أنسخ ذلك حتّى أذكره لأمير المؤمنين لعله يخالفه.
ثم أمر بالكتاب فخرق، ورجع فأخبر أباه عبدالملك بن مروان بذلك الكتاب، فقال عبد الملك: ما حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل، تُعرّف أهل الشام أموراً لا نريد أن يَعرِفوها؟!
قال سليمان: فلذلك أمرت بتخريق ما نسخته! [٥]
المشهد الثاني
حدث المدائني عن ابن شهاب الزهري أنّه قال: قال لي خالد القسري[٦] اكتب السيرة.
فقلت له: فإنه يمر بي الشيء من سير علي بن أبي طالب، فأذكره؟ قال: لا، إلاّ أن تراه في قعر الجحيم [٧]
وكتب الزهري مغازيه، وجلها رواها عبد الرزاق في مصنفه، فمن قرأها وجد علياً رجلاً غريباً على السيرة ليس له فيها خبر ولا أثر، مع أن الزهري لا يمر على اثر لأبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ إلاّ فصل فيه وزينه أما علي فلا ذكر له في مغازي الزهري لا في العهد المكي بطوله، ولا في الهجرة، ولا في المؤاخاة، ولا في بدر، ولا في أحد، ولا في الخندق، ولا في خيبر، ولا حنين، ولا فتح مكة، ولا في غزوة تبوك، ولا في حجة الوداع، ولا في غير ذلكَ !
ومع هذا فإن الزهري كان يتهم شيخه الأول بالانحراف عن علي وبني هاشم!
فقد كان اكثر اعتماد الزهري في مغازيه على رواية شيخه عروة بن الزبير، وكانت أكثر رواية عروة عن أم المؤمنين عائشة، فيما كان الزهري يقول فيهما معا: إني اتهمهما في بني هاشم.
قال معمر: كان عند الزهري حديثان عن عروة عن عائشة في علي، فسألته عنهما يوماً، فقال: ما تصنع بهما وبحيثهما؟ الله أعلم بهما ! اني لا تهمهما في بني هاشم [٨]
وروى الزهري أيضاً حديث عبد الله بن عبدالله بن عتبة عن السيدة عائشة في مرض رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ إذا قالت: وضع يداً له على الفضل بن العباس ويداً أخرى على رجل آخر، وهو يخط برجليه في الأرض.
قال عبيدالله: فحدثت فيه عبدالله بن عباس، فقال: أتدري من الرجل الّذي لم تسمه عائشة؟ هو علي بن أبي طالب، ولكن عائشة لا تطيب له نفساً بخير.[٩]
المشهد الثالث
إنّ عروة بن الزبير كان من أول من صنف في المغازي والسير.
فإذا كان ذلك هو نصيب علي في مغازي الزهري، فكيف هو في مغازي عروة؟
لقد تجاوزت مغازي عروة نصيب علي إلى نصيب غيره من بني هاشم ! فقد حدث يزيد بن رومان عن عروة وهو يروي قصة مهاجرة الحبشة وحديث النجاشي معهم، فقال فيه: إنّما كان يكلم النجاشي عثمان بن عفان!
هذا فيما تسالم أصحاب الحديث والسير أن ذلك كان جعفر بن أبي طالب!
وحديث عروة هذا بين جعفر وعثمان ـ رضي الله عنهما ـ هو من صنف ما سخر منه الزهري من صنيع اتباع بني أمية في التاريخ.
قال معمر: سألت الزهري عن كاتب الكتاب يوم الحديبية، فضحك، وقال: هو علي بن أبي طالب، ولو سألت هؤلاء ـ يريد بني أمية ـ لقالوا: عثمان! [١٠]
المشهد الرابع
في قصة أبي ذر (رضي الله عنه) مع بني أمية قال الطبري: في سنة 30 هـ كان ما ذكر من أمر أبي ذر و معاوية، وأشخاص معاوية إياه أمور كثيرة كرهت ذكر أكثرها، فأما العذرون معاوية فإنهم ذكروا في ذلك قصة كتب بها إلي السدي يذكر أن شعيباً حدثه سيف... ثم يسرد الطبري هذه القصة مردداً بين فقراتها: قال سيف، حتّى أتى على آخرها، ثم قال: وأما الآخرون فإنهم رووا في سبب ذلك أشياء كثيرة وأموراً شنيعة كرهت ذكرها! ئ ئئ ئئئئ ئ[١١]
إذن لا شيء عن هذا الحدث الكبير الذي يكشف عن كثير من أسرار التاريخ إلاّ ما يرويه العاذرون معاوية ولا أحد يستند إليه العاذرون معاوية إلاّ سيف بن عمر الذي أجمع أصحاب الجرح والتعديل على أنّه كذاب يضع الحديث وأنه كان يتزندق... ثم من بعد سيف راويته المجهول شعيب ! ولا شيء بعد ذلك.
أما العاذرون أبا ذر فلا شيء عنهم في هذه الموسوعة التاريخية الكبرى !
وكذلك كان مع أهم مراحل التاريخ الإسلامي وأكثرها حساسية، تلك المرحلة التي ابتدأت بوفاة الرسول الأكرم ـ صلى الله عليه وآله ـ، فإني لم أضف إلى ما نقله أبو جعفر شيئاً، وإنّما اعتمدت عليه من بين المؤرخين إذ هو الإمام المتقن حقاً، الجامع لأحكام القرآن علماً وصحة اعتقاد وصدقاً [١٢]
هذا مع أن هذه الأحداث قد اقتصد فيها الطبري على رواية سيف الذي عرف بالكذب والوضع والزندقة!
وقال ابن خلدون، بعد ذكر موقعة الجمل: هذا أمر الجمل ملخصاً من كتاب أبي جعفر الطبري، اعتمدناه للوثوق به، ولسلامته من الأهواء الموجودة في كتب ابن قتيبة وغيره [١٣]
هذا مع أن الطبري لم يوثق ما رواه بل ذكر اسم الراوي لتعرفه الناس فتصدق روايته إنّ كان صدوقاً، وتردها إنّ كان معروفاً بالكذب واتباع الهوى. وموقعة الجمل قد رواها الطبري عن سيف بن عمر!
وقال ابن خلدون أيضاً بعد أن فرغ من الكلام في أمر الخلافة وأخبارها: هذا آخر الكلام في الخلافة الإسلاميّة وما كان فيها من الردة والتفوحات والحروب ثم الاتفاق والجماعة، أوردتها ملخصة عن عيونها ومجامعها من كتاب محمّد بن جرير الطبري فإنه أوثق ما رأيناه في ذلك، وأبعد عن المطاعن والشبه في كبار الأمة من خيارها وعدولها من الصحابة والتابعين، فكيراً ما يوجد في كلام المؤرخين أخبار فيها مطاعن وشبه في حقهم أكثرها من أهل الأهواء، فلا ينبغي أن تسود بها الصحف.[١٤]
هناك إشارات يجب أن يلفت النظر إليها وهي:
1 ـ ما هو الميزان الذي يعرف به صدق الأخبار وكذبها؟
أيعرف ذلك من مساندتها للوضع السياسي في مرحلة من المراحل وموافقتها لأهواء العامة ورغباتها ؟ أم الصحيح أن يعرف صدقها أو كذبها من خلال معرفة أحوال الرواة أنفسهم، ومطابقتها لحقيقة أحوال الناس من صحابة وغيرهم؟
2 ـ أيهما أكثر شناعة: الخبر الذي يفيد بأن صحابياً ما كان مائلاً إلى الدنيا، ولم يتوخ العدل في حكمه، أم الخبر الذي يصف الصحابي بأنه كان من أتباع اليهود والنصارى؟
إنّ الأخبار التي أعرض عن ذكرها هؤلاء المؤرخون وعدوها من أخبار أهل الأهواء الّذين يأتون بالكلام الشنيع إنّما كانت تضع الحق مع أبي ذر الغفاري وتصف خصومه السياسيين بالميل إلى الدنيا وعدم توخي العدل في الحكم.
أما الأخبار التي رواها الطبري وعنه ابن الأثير وابن خلدون فقد دافعت حقاً عن خصوم أبي ذر ولكنها وصفت أبا ذر بكل صراحة، ومن بعده عمار بن ياسر، بأنهما كانا أول المخدوعين باليهودي الزنديق عبدالله بن سبأ والمتأثرين بأفكاره والمندفعين وراءها في الفتنة!
فأي الخبرين أكثر طعناً على كبار الصحابة لو كان هذا هو الميزان المتبع في قبول الأخبار وردها؟
بين التاريخ والسنة الشريفة
الأنصار رفعت السنة الشريفة منزلتهم، فقال فيهم رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ «الأنصار لايحبهم إلاّ مؤمن، ولا يبغضهم إلاّ منافق» [١٥]
وقال فيهم «آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار»[١٦]
وأخبرت السنة الشريفة أن بغض الأنصار سيظهر عند قوم عن قريب، وهؤلاء القوم غلبة، فسوف يستأثرون على الأنصار ويحبسون عنهم حقوقهم ويصرفونهم عن مكانتهم، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ للأنصار: «ستلقون بعدي إثرة، فأصبروا حتّى تلقوني على الحوض»[١٧]
فملا ظهر هؤلاء القوم وتغلبوا على الأمور وأبعدوا الأنصار واستأثروا عليهم، جاء التاريخ فاستأثر على الأنصار وحالف خصومهم، ناسياً أن حب الأنصار آية الإيمان، وبغضهم آية النفاق! وهكذا كان مع أبي ذر!
وقفت السنة الشريفة إلى جنبه، فقال ـ صلى الله عليه وآله ـ: «ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر» [١٨] لكن حين كذبه الحاكمون كذبه التاريخ، وحالف خصومه يصنع لهم الأعذار ولو على ألسن الكذابين.
وعمار حين أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه [١٩] ، وجعله النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ آية للفرقة المحقة إذا افترق الناس؛ جاء خصومه فاتهموه باتباع الشيطان وركوب الفتنة، فجاء التاريخ يصدق خصومه ويكذب فيه السنة الشريفة.
ولما كان علي هو العنوان المستهدف من قبل خصومه المتغلبين، كان هو وفئته عرضه لجور التاريخ على الدوام، فقد حالف التاريخ خصومه على الدوام يلم لهم الأعذار من هنا وهناك، ناسياً أن السنة الشريفة قد ثبتت أحكامها، بأن حب علي فرقان بين الإيمان والنفاق، ومعاداة علي معاداة لله ورسوله، وحرب علي حرب لله ورسوله!
فقد عهد النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ لعلي عهداً: «لا يحبك إلاّ مؤمن، ولا يبغضك إلاّ منافق»[٢٠]
وقال فيه: «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» [٢١]
وقال فيه وفي أهل بيته: «انا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم»[٢٢]
وهكذا رسمت السنة مساراً، وسلك التاريخ مساراً آخر!
فما لنا لا ننظر إلى السنة الثابتة في محاكمة التاريخ؟
وإذا كان التاريخ قد كتب في أجواء صعبة أرغمته على متابعة المتغلب دائماً، والإعراض عن أخبار الثقات من خصومه، بل حتّى عن السنة الثابتة التي قد تكون سياسة المتغلب أحياناً حرباً صريحةً عليها؛ إذا كانت تلك هي ظروف التدوين، فما لنا نحن الّذين أتينا من بعد لا نتنبه لذلك ؟
مالنا لا نتنبه لأسرار هذه السنة الشريفة التي امتدت إلى المستقبل لتكشف آفاقه؟
فلماذا كان الأنصار مخصوصين بهذه العناية؟
ولماذا كان أبو ذر وحده أصدق لهجة من كلّ من أقلت الغبراء وأظلت الخضراء ؟
ولماذا كان عمار وحده مجاراً من الشيطان، وآية لـ أهل الحق؟
ولماذا كان علي فرقناً بين الإيمان والنفاق، ومن حاربه فقد حارب الله ورسوله؟
ألا نفهم من ذلك أن السنة قد جاءت لتهدينا إلى الحق الذي يجب محالفته ونكون معه حين يفترق الناس وتظهر النزاعات؟
لقد قالت السنة بلسان صريح:
إذا رأيتم من يكذب أباذر فاعلموا أنّه هو الكاذب أياً كان، فليس على هذه الأرض أحد أصدق لهجةً من أبي ذر!
وإذا رأيتم من يستأثر على الأنصار ويبعدهم، فأعلموا أن تلك واحدة من علامات النفاق!
وإذا رأيتم من يتهم عماراً مبادراً إلى الفتنة وغواية الشيطان، فأعلموا أن أولئك هم حزب الشيطان، لأن عماراً قد أجاره الله من الشيطان وأنه على الحق أبداً لا يفارقه !
وإذا رأيتم من عادى علياً وحاربه فأعلموا أنّه إنّما يحارب الله ورسوله!
أليست تلك هي نداءات السنة؟!
إذن فالسنة قد أدانت التاريخ مرات ومرات.
ولقد أدرك الكثيرون حقيقة أن معظم المؤرخين الّذين صاغوا هذا التاريخ هم من الموالين للسلطات سياسياً في عهود تأجج فيها النزاع السياسي وازدادت حدته حتّى امتد إلى كلّ ميادين الحياة، فكان اقل ما يفعله المؤرخون هو تبرير أعمال الخلفاء والأمراء والكف عن ذكر ما يزعجهم وإن كان هو الحق.
كما أن معظم المؤرخين كانوا أيضاً موالين للسلطات مذهبياً في عهود كان فيها النزاع المذهبي على أشده فكان كلّ فريق لا يروي عن مخالفيه إلاّ ما يشينهم، وقد لا يروي عنهم إلاّ الكذب والبهتان.
مصادر تاريخية مضادة
ظهر في مقابل المصادر المتقدمة مصادر أخرى مالت عن الحق ولكن في الاتجاه المعاكس وكأنها ردة فعل ومثال هذا النوع من الكتب: كتاب أبي القاسم علي بن احمد الكوفي الذي عرفه النجاشي. باسم (كتاب البدع المحدثة) ورأيته مطبوعاً باسم (كتاب الاستغاثة).
وقد قال النجاشي في هذا المؤرخ وفي سائر كتبه ما نصه: «أبو القاسم الكوفي رجل من أهل الكوفة كان يقول إنه من آل أبي طالب، وغلا في آخر أمره وفسد مذهبه، وصنف كتباً كثيرةً أكثرها على الفساد».
ثم ذكر منها كتاب البدع المحدثة، وكتاب تناقض أحكام المذاهب الفاسدة، ووصفه النجاشي بأنه تخليط كله [٢٣]
وقال فيه ابن الغضائري: «أبو القاسم الكوفي المدعي العلوية كذاب غال صاحب بدعة ومقالة، رأيت له كتباً كثيرة خبيثة»[٢٤]
فكتاب كهذا لا يعد في تراث المسلمين أصلاً، وإنّما هو من تراث الغلاوة، وعده في تراث الشيعة خطأ كبير وجناية مضاعفة.
النتيجة من كلّ ما تقدم
نخلص إلى حقيقةٍ لا شك فيها، وهي: أن معلوماتنا عن التاريخ بحاجة إلى مراجعة جادة، ودراسة في ضوء رؤية شمولية للتاريخ الإسلامي؛ رؤية تحيط بجوهر رسالة الإسلام. رؤية تكون فيها الشريعة الإسلامية بمصدريها الأساسين (القرآن و السنة) هي المعيار الذي تقوم على أساسه الأطراف والمنازعات والفئات المختلفة.
وبدون ذلك لا نستطيع أن نتقدم خطوة واحدة نحو الفهم الصحيح لحقائق تاريخنا ومعرفة الصدق والكذب والحق والباطل فيه.
وبدون ذلك لا نستطيع أن نتقدم خطوة واحدة نحو التقريب، إلاّ أن يكون تقريباً وهمياً يتداعى أمام ادنى إثارة !! وإني لأخشى أن تكون إثارتي هذه وحدها كافية لتداعيه!
إنّ الدهشة لتأخذني حقاً حين ينشد التقريب من بين كتابين حشي أحدهما بأخبار النواصب، وامتلأ الآخر بأخبار الغلاة ! وأكثر من هذا ينتابني حين ألمس تردداً في قبول ضرورة تصحيح تراثنا الإسلامي العزيز وتنقيته مما تراكم فيه من الأخبار والآثار!
المصادر
- ↑ (المؤمنون(23): 91).
- ↑ (المؤمنون(23): 91، 92).
- ↑ (الأنبياء(21): 21، 22).
- ↑ (حجة الله البالغة: 1).
- ↑ (الموفقيات، للزبير بن بكار: 222).
- ↑ والي مكة للوليد بن عبد الملك ثم لسليمان بن عبد الملك، وولي العراق لهشام بن عبد الملك.
- ↑ (الأغاني 22: 21 أخبار خالد بن عبدالله القسري).
- ↑ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 64.
- ↑ المصنف 5: 429، 430.
- ↑ (المصدر نفسه : 343، 9722).
- ↑ (تاريخ الطبري 4: 283، 284).
- ↑ (الكامل في التاريخ 1: 3).
- ↑ (تاريخ ابن خلدون 2 ك 622).
- ↑ (المصدر نفسه: 650).
- ↑ (صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب 34: 3572).
- ↑ (المصدر نفسه، باب 34:3573).
- ↑ المصدر نفسه ، باب 38: 3581 – 3583.
- ↑ سنن الترمذي 5: 3801، 3802، سنن ابن ماجه 1: 156.
- ↑ صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب 20.
- ↑ صحيح مسلم 2: 131 كتاب الإيمان، سنن الترمذي 5: 3736، سنن ابن ماجه 1: 42/114
- ↑ مسند أحمد 1: 119، 152 و 4: 281، 370، 372، سنن ابن ماجه 1: 43 /116
- ↑ المصدر نفسه 2: 442، سنن الترمذي 5: 699 / 3870 سنن ابن ماجه 1: 52 /145
- ↑ رجال النجاشي: 260 ـ 266
- ↑ )الرجال، لابن داود: 259 ـ 260، وانظر أيضاً: معجم رجال الحديث 11: 246، 247/7876