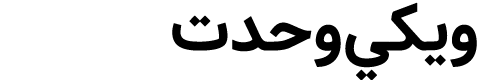الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دعاة الوحدة الإسلامية»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٧: | سطر ٧: | ||
أمّا تعريفها : فقد عرّفها مرشد [[الجمهورية الإسلامية الإيرانية]] السيّد [[علي الخامنئي]] بأنّها : مفهوم أساس في [[الإسلام]] ، ومبدأ يشكّل واحدة من القواعد التي تقوم عليها فلسفة الإسلام الاجتماعية ونظرته العامّة إلى الكون والحياة . | أمّا تعريفها : فقد عرّفها مرشد [[الجمهورية الإسلامية الإيرانية]] السيّد [[علي الخامنئي]] بأنّها : مفهوم أساس في [[الإسلام]] ، ومبدأ يشكّل واحدة من القواعد التي تقوم عليها فلسفة الإسلام الاجتماعية ونظرته العامّة إلى الكون والحياة . | ||
وعرّفها الشيخ [[محمّد علي التسخيري]] الأمين العامّ السابق | وعرّفها الشيخ [[محمّد علي التسخيري]] الأمين العامّ السابق للمركز العلمي المعروف "[[المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية]]" بأنّها : التعاون بين أتباع [[المذاهب الإسلامية]] على أساس المبادئ الإسلامية المشتركة الثابتة والأكيدة ، واتّخاذ موقف موحّد من أجل تحقيق الأهداف والمصالح العليا للأُمّة الإسلامية والموقف الموحّد تجاه أعدائها ، مع احترام التزامات كلّ مسلم تجاه مذهبه عقيدة وعملاً . | ||
وعرّفها الأمين العامّ السابق للمجمع الشيخ [[محمّد واعظ زاده الخراساني]] بأنّها : وحدة كلمة [[الأُمّة]] تجاه قضاياها الأساسية وأهدافها المشتركة ، ووقوفها صفّاً واحداً أمام الاعداء ، وهي الغاية القصوى والغرض الأقصى . | وعرّفها الأمين العامّ السابق للمجمع الشيخ [[محمّد واعظ زاده الخراساني]] بأنّها : وحدة كلمة [[الأُمّة]] تجاه قضاياها الأساسية وأهدافها المشتركة ، ووقوفها صفّاً واحداً أمام الاعداء ، وهي الغاية القصوى والغرض الأقصى . | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٧:١٣، ١٦ يونيو ٢٠٢١
دعاة الوحدة: من يتّخذ الوحدة هدفاً يسعى لتحقيقه بشتّى الوسائل المشروعة، ويؤمن به طريقاً مهيعاً للوصول إلى الاتّفاق المنشود، ممّا يحقّق الرفاه والسلم الاجتماعي والتطوّر نحو مستقبل زاهر جميل يتعاضد فيه أبناء الأمّة جميعاً للوقوف بصلابة وتماسك بوجه التحديات التي تواجه مسيرتهم في هذا العالم الذي تحكمه المنافع والمصالح الضيّقة والشهوات.
تعريف الوحدة
أمّا تعريفها : فقد عرّفها مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيّد علي الخامنئي بأنّها : مفهوم أساس في الإسلام ، ومبدأ يشكّل واحدة من القواعد التي تقوم عليها فلسفة الإسلام الاجتماعية ونظرته العامّة إلى الكون والحياة .
وعرّفها الشيخ محمّد علي التسخيري الأمين العامّ السابق للمركز العلمي المعروف "المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية" بأنّها : التعاون بين أتباع المذاهب الإسلامية على أساس المبادئ الإسلامية المشتركة الثابتة والأكيدة ، واتّخاذ موقف موحّد من أجل تحقيق الأهداف والمصالح العليا للأُمّة الإسلامية والموقف الموحّد تجاه أعدائها ، مع احترام التزامات كلّ مسلم تجاه مذهبه عقيدة وعملاً .
وعرّفها الأمين العامّ السابق للمجمع الشيخ محمّد واعظ زاده الخراساني بأنّها : وحدة كلمة الأُمّة تجاه قضاياها الأساسية وأهدافها المشتركة ، ووقوفها صفّاً واحداً أمام الاعداء ، وهي الغاية القصوى والغرض الأقصى .
وعرّفها الشيخ عبد الأمير قبلان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان بأنّها : ما بدأت من الاعتراف بالآخر وجوداً وفكراً ، وما سعت لفعل تواصلي حواري ، ينمّي المشترك ، ويحدّد نقاط التغاير ، ويسعى نحو ترسيخ مستوى الفهم والاعتراف وفق أُصوله الموضوعية والعلمية ، وأهمّ وسائل المفهوم الحضاري للوحدة احترام التنوّع وقيم التسامح وحقوق الإنسان في المحيط الاجتماعي السائد .
وعرّفها الدكتور أحمد عمر هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر ورئيس جامعة الأزهر سابقاً بأنّها : اتّحاد الدول أو البلاد والأفراد في أُمور حياتهم ومعاشهم ومسيرتهم وغايتهم ، وبموجبها يصبح الجميع وحدة واحدة أو أُمّة واحدة .
وقريب من هذا التعريف تعريف الدكتور عبد العزيز الخيّاط وزير الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية سابقاً .
وأخيراً عرّفها الشيخ تاج الدين الهلالي مفتي مسلمي أُستراليا سابقا بأنّها : تحقيق أمر الله تعالى بتوحيد الكلمة القائمة على كلمة التوحيد ، بأن يكون المسلمون جميعاً تحت راية خلافة أو حكومة ، تكون لهم قيادة إسلامية أو سيادة واحدة ، فلا تفصل بينهم حواجز ولا حدود مصطنعة.
هذا ، وللأُستاذ حيدر كامل حبّ الله اللبناني كلام لطيف في المقام أسماه بأزمة المفهوم ، ليس هنا محلّ ذكره .
كما أنّه توجد في بعض التعاريف السابقة بعض الإشكالات ، حيث إنّ بعضها يشير إلى أسباب المناداة بالوحدة الإسلامية والأهداف المرجوّة منها والوسائل المتاحة دونما أن يشير إلى تحديد مفهومها الاصطلاحي تحديداً دقيقاً ، وبقية الكلام في محلّه .
مقوّمات الوحدة عند دعاتها
أمّا مقوّمات الوحدة : فهي الركائز الأساسية والقواعد الراسخة والأُصول الثابتة التي ترتكز عليها الوحدة الإسلامية . ولهذه المقوّمات أبعاد مختلفة يمكن توضيحها فيما يلي :
أوّلاً : البعد الديني .
يمثّل البعد الديني أهمّ عناصر وحدة الأُمّة الإسلامية ، فالدين هو الركيزة الأساسية التي تبتني عليها بقية العناصر ، فوحدة الأُمّة الإسلامية تمثّل بناء متكاملاً له أساس ثابت راسخ الأركان يحمل البناء كلّه ، ألا وهو الدين ، أو هي كالشجرة لها جذور ضاربة في الأرض وبدونها لا يكون للشجرة كيان ولا حتّى وجود ، ومن هذه الجذور تمتدّ الساق والفروع والأغصان .
ويتمثّل البعد الديني في العقيدة الواحدة بإله واحد ونبي واحد وكتاب واحد وعبادة واحدة . فالجميع يتّجهون في صلاتهم في مواعيد محدّدة إلى الله نحو قبلة واحدة أينما كانوا في أيّ مكان من العالم ، ويجمع بينهم الصيام في شهر معيّن ، ويجمع الحجّ بينهم من كلّ الأجناس والأقطار طائفين حول كعبة واحدة في حرم الله الآمن تنجذب إليها أفئدتهم من كلّ فجّ عميق : ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّام مَعْلُومَات ) ( سورة الحجّ : 28 ) ، وهذا التجمّع الكبير في الحجّ يعدّ رمزاً حيّاً لوحدة الأُمّة الإسلامية كلّها ، فهؤلاء ممثّلوها من كلّ مكان يجمعهم هدف واحد ، ويربط بين قلوبهم رباط واحد ، يجعل منهم جميعاً أُخوة متحابين متآلفين بأمر الله .
ويعبّر القرآن الكريم عن هذا المعنى الإيماني بقوله تعالى : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا ) ( سورة آل عمران : 103 ) ، وهذه الوحدة الروحية من شأنها أن تقضي على كلّ ما يعكّر صفو الأُمّة أو يعمل على تقطيع أوصالها ، فمادام الربّ واحداً والدين واحداً فلا مجال للتناقض في أُمور الدين .
والاعتصام بحبل الله ليس مجرّد شعار يرفعه المسلمون ، وإنّما له متطلّبات لا يتحقّق بدونها ، ولا يقع عند الله موقع القبول إلاّ إذا تحقّقت وقام المعتصمون بتبعاتها على الوجه الذي رسمه الله في كتابه طريقاً لكمال الإنسانية ورقيها ، فهو يقضي بتنحية الشهوات والأهواء التي تثيرها العصبيات القبلية والعرقية والمذهبية ، ويقضي بالنظر السريع في تنقية العقائد والعبادات وسائر التعاليم الإلهية ممّا يشوبها ويكدّر صفوها من صور الشرك والابتداع الذي هيّأ لخصوم الإسلام أن يقولوا بتعدّدية الإسلام ويزعموا أنّ الإسلام ليس ديناً واحداً وإنّما هو أديان متعدّدة تختلف باختلاف الأقاليم والمذاهب : ( كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً )( سورة الكهف : 5 ) .
ثانياً : البعد الإنساني .
ويتّضح البعد الإنساني لوحدة الأُمّة الإسلامية جلياً في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهّرة ، فالله سبحانه وتعالى يلفت نظرنا إلى وحدة الأصل الإنساني . فالناس جميعاً قد خلقهم الله من نفس واحدة : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْس وَاحِدَة )( سورة النساء : 1 ) ، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يؤكّد هذا المعنى أيضاً في قوله : « يا أيّها الناس ، ألا إنّ ربّكم واحد وأباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لأعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أسود ، ولا لأسود على أحمر ، إلاّ بالتقوى » .
والإسلام لا يفصل هذا البعد الإنساني عن البعد الديني المشار إليه كما كانت تفعل ـ ولاتزال ـ بعض الآيديولوجيات والفلسفات في القديم والحديث التي تصل بالإنسان إلى حدّ التأليه وتجعله صاحب السلطان الأوحد في هذا الكون !
ويبيّن لنا القرآن الكريم أنّ الإنسان الذي ينكر أصله أو يجحد خالقه هو إنسان يعمل ضدّ طبيعته وفطرته التي فطره الله عليها . فالله سبحانه قد أخذ عليه ميثاقاً لا يجوز له أن يتجاهله أو يغفل عنه ; لأنّه مركوز في أصل فطرته . وفي ذلك يقول القرآن الكريم : ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذَا غَافِلِينَ )( سورة الأعراف : 172 ) . ومن بين القلائل من فلاسفة الغرب الذين أكّدوا هذا المعنى كان الفيلسوف الفرنسي « ديكارت » الذي قال : « والحقّ أنّه لا ينبغي أن نعجب من أنّ الله حين خلقني غرس فيّ هذه الفكرة ـ أي : فكرة وجود الله ـ لكي تكون علامة للصانع مطبوعة على صنعته » .
وهذا الارتباط الوثيق بين كلّ من البعد الديني والبعد الإنساني في وحدة الأُمّة الإسلامية له دلالة هامّة ; إذ يعني أنّ هذه الأُمّة التي أراد الله لها أن تكون خير أُمّة أُخرجت للناس من شأنها أن تكون عنصر أمان واستقرار في هذا العالم ، فهي أُمّة ترتبط بخالقها بعلاقة العبودية له سبحانه ، وترتبط بغيرها من بني البشر بعلاقة الإنسانية التي لا تنسى عبوديتها لخالق الكون كلّه .
وهذه الصلة الوثيقة بالله إذا استقامت فإنّها كفيلة بتصحيح مسار الأُمّة الإسلامية في هذا الوجود ، وبذلك تتحقّق خيريتها ، إنّها أُمّة تسع الإنسان أينما كان وأنّى كان ، وتشمل برعايتها وأمنها كلّ من يعيش على أرضها .
ثالثاً : البعد الاجتماعي .
وإذا كانت الأُمّة الإسلامية ترتبط فيما بينها بروابط العقيدة والإنسانية فإنّ محصّلة هذين البعدين هي الأُخوّة التي هي أقوى من أُخوّة النسب . ومن هنا كان قول القرآن الكريم : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) ( سورة الحجرات : 10 ) . وعندما أراد النبي (صلى الله عليه وآله) أن يؤسّس قواعد المجتمع الإسلامي في المدينة بعد الهجرة آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار ، فتآلفت قلوبهم بفضل الله ، وقد امتنّ الله على المؤمنين بهذا التآلف ، فقال : ( فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ) ( سورة آل عمران : 103 ) . وهذه الأُخوّة لها حقّها ، فهي تتضمّن بعداً عاطفياً يتمثّل في المشاركة الوجدانية ، فكلّ فرد من أفراد الأُمّة الإسلامية يشعر بآلام وآمال أُمّته ; لأنّه جزء منها يحسّ بإحساسها ويسعد لسعادتها ويتألّم لألمها . ومن هنا كان قول النبي (صلى الله عليه وآله) : « مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى » .
ولكن مجرّد المشاركة الوجدانية ـ وذلك مع أهمّيتها ـ لا تكفي ، ولا بدّ أن يترجم هذا الشعور الداخلي إلى عمل فعّال يكون من شأنه النهوض بالأُمّة وبأفرادها . ومن هنا كان مبدأ التكافل في الإسلام بمثابة ترجمة عملية لذلك الشعور الباطني لدى المسلم . وقد جعل الإسلام هذا المبدأ عبادة مفروضة يتعبّد بها المسلم ويتقرّب بها إلى ربّه ، وهي فريضة الزكاة .
وقد آن الأوان ليخرج المسلمون من دائرة المشاركة الوجدانية السلبية إلى المشاركة الإيجابية المؤثّرة ، وذلك بوضع الخطط المفصّلة لإقامة بنيان التكافل بين أبناء الأُمّة الإسلامية . وقد آن الأوان للأُمم الإسلامية أن تنصهر في بوتقة الوحدة الحقيقية للأُمّة الإسلامية بتحقيق مبدأ التكافل والخروج من سجن الفرديات المنعزلة والقوميات المنفصلة إلى محيط الجماعة الكبرى التي أرادها الله أن تكون خير أُمّة أُخرجت للناس ، تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، وتؤمن بالله ، وتقيم التعاون فيما بينها على البرّ والتقوى ، لا على الإثم والعدوان.
رابعاً : البعد الجغرافي .
لقد جعل الله للأُمّة الإسلامية من وضعها الجغرافي الذي تتميّز به في هذا العالم وحدة طبيعية جامعة في رقعة مترامية الأطراف في كلّ من قارتي آسيا وأفريقيا ، فضلاً عن أنّها تمتدّ إلى بعض أجزاء من أوروبّا . ومن المعروف أنّ الإسلام قد انتشر في جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا بقوّته الذاتية دون أن يدخل إلى هذه البلاد جيش مسلم لفتحها .
ومن نعم الله على المسلمين أنّ هذه المناطق المترامية الأطراف الملتحمة الأجزاء ـ والتي تشكّل بلاد العالم الإسلامي ـ تشتمل على الكثير من المعادن والكنوز النفطية وغير النفطية التي لو أُحسن استغلالها لجعلت من العالم الإسلامي قوّة يحسب لها ألف حساب .
وفضلاً عن هذه الكنوز في باطن الأرض توجد هناك في العالم الإسلامي مناطق شاسعة يمكن استصلاحها بمجهودات قليلة وزراعتها بشتّى المحاصيل لتكون سلّة غذاء للعالم الإسلامي كلّه . وبذلك يتحقّق للمسلمين الاكتفاء الذاتي في غذائهم ، الأمر الذي يساعدهم على استقلاليتهم في إرادتهم وفي قراراتهم ، فمن المعروف أنّ من لا يملك غذاءه لا يملك قراره .
وهذه الوحدة الجغرافية من شأنها أن تمحو بين أقطار العالم الإسلامي تلك الحواجز الإقليمية المصطنعة في قضايا الاقتصاد والإنتاج .
خامساً : البعد الحضاري .
الإسلام ليس دين طقوس تعبّدية جامدة ، إنّه دين للحياة بكلّ أبعادها . والأُمّة الإسلامية أُمّة أراد الله لها أن تكون صاحبة رسالة دينية وحضارية في هذا العالم ، ومن هنا كان وصفها بأنّها خير أُمّة أُخرجت للناس .
وقد رسم القرآن الكريم للإنسان الإطار العامّ في كلّ أُموره الدينية والدنيوية ، واستخلف الله الإنسان في الأرض ، وكلّفه بعمارتها وصنع الحضارة فيها ، ووعد المؤمنين العاملين بالتمكين لهم في الأرض ، وكتب لهم العزّة والنصر . وتحقيق ذلك كلّه أمر منوط بالإنسان وبتأييد من الله تعالى .
وقد أدرك المسلمون الأوائل ذلك كلّه ، وعملوا على تحقيقه ، وقد تحقّق لهم بالفعل ما أرادوا وما أراده الله منهم . وبذلك أقاموا صرحاً شامخاً لحضارة عريقة كانت من أطول الحضارات عمراً في التاريخ . وقد اشترك علماء الأُمّة الإسلامية من كلّ جنس ولون في إقامة هذا الصرح الحضاري بدافع من الإسلام الذي رفع من شأن العلم والعلماء واعتبر مداد العلماء مساوياً لدماء الشهداء أو أفضل ، وجعل العلماء أخشى الناس لله تعالى .
وسارت جهود علماء المسلمين في مجالات العلوم الدينية والدنيوية جنباً إلى جنب في تكامل رائع ، فقد أدركوا أنّ الحضارة تعني تقدّماً مادّياً وروحياً وأخلاقياً ، وبذلك قدّموا للإنسانية خدمة كبرى في الوقت الذي كان فيه العالم غير الإسلامي لايزال يعيش في جهالة جهلاء . وترك لنا الأسلاف تراثاً ضخماً يعدّ أغنى تراث في العالم يعبّر عن وحدة جهود علماء الأُمّة الإسلامية بصورة رائعة ، ويشترك المسلمون اليوم في كلّ مكان في العالم الإسلامي في الاعتزاز بهذا التراث .
وقد آن الأوان للأُمّة الإسلامية أن تتوحّد جهودها مرّة أُخرى في سبيل النهوض بالأُمّة والارتقاء بها حضارياً بما يؤكّد شخصيتها المتميّزة ويحافظ على ذاتيتها مسترشدة في ذلك بتعاليم الإسلام الشاملة وبالجوانب الإيجابية المشرقة في تراثنا .
فلا يليق بالأُمّة الإسلامية أن تظلّ في عالمنا المعاصر قابعة في مقاعد المتفرّجين الذين لا يشاركون في صنع الحضارة ، ويكتفون بدور المستهلك لما تنتجه الحضارة التي يصنعها غيرنا ، في الوقت الذي لا تعرف البشرية فيه ديناً آخر غير الإسلام يشتمل على كلّ المقوّمات والأُسس التي تحقّق للبشرية أفضل المستويات الحضارية مادّياً وروحياً وأخلاقياً .
والرسالة الدينية الحضارية المنوطة بالأُمّة الإسلامية لا يمكن تأديتها والقيام بحقّها إلاّ إذا توحّدت جهود الأُمّة دينياً وفكرياً وحضارياً . وواجبها يفرض عليها في هذا الصدد أن تقدّم للعالم هذه الرسالة الدينية الحضارية في صورة أُنموذج متحقّق في عالم الواقع ، فليس بالأقوال تؤدّى الرسالات الكبرى ، ولكن بترجمة الأقوال إلى برامج عمل . ومن هنا جاء اللوم والمقت في القرآن الكريم للمؤمنين الذين يقولون ما لا يفعلون : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ )( سورة الصفّ : 2 ـ3 ) .
سادساً : البعد المصيري .
وإذا كانت الأُمّة الإسلامية ترتبط فيما بينها برباط ديني واحد وتجمعها وحدة جغرافية طبيعية ولها رسالة نورانية حضارية في هذا الوجود ، فإنّ ذلك يعني أنّ لها غايات واحدة وأهدافاً مشتركة ، ويعني في النهاية أنّ لها مصيراً واحداً .
ومن أجل حماية هذا المصير الواحد وصوناً للمبادئ السامية والمثل العليا التي تقوم بها ومن أجلها الأُمّة الإسلامية فلا بدّ من إعداد القوّة اللازمة لدرء الأخطار التي تحيط بها ، سواء كانت هذه الأخطار قائمة بالفعل أو محتملة الوقوع ، أي : سواء كانت منظورة أم غير منظورة ، فالقوّة في كلا الحالين ضرورية . وفي هذا الصدد يقول القرآن الكريم : ( وَأَعِدُّوا لَهُم مَا استَطَعْتُم مِن قُوَّة وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ ) ( سورة الأنفال : 60 ) .
والهدف الذي من أجله يدعو القرآن الكريم إلى هذا الاستعداد الحربي بكلّ ما أُوتينا من قوّة لا يرمي إلى التخريب والتدمير أو الاستعباد والاستعمار أو سلب الآخرين أموالهم وأوطانهم وأمنهم ، وإنّما يرمي إلى دفع شرّ الأعداء وردعهم وتخليص المستضعفين من أيدي الظالمين المعتدين ، وإفساح الطريق أمام دعوة الخير الذي يريده الله لعباده . وقيام هذه القوّة يعدّ من أقوى وسائل السلم الذي أمر الله به ، فهي قوّة تحمي السلم والأمان والاستقرار .
ومثل هذه القوّة لا تتأتّى إلاّ بوحدة الأُمّة الإسلامية ، فهذه الوحدة هي السدّ المنيع والحصن الحصين في وجه كلّ الأطماع التي تستهدف إضعاف الأُمّة الإسلامية وإثارة الفتن والخصومات بين أبنائها .
وعلى الأُمّة الإسلامية صاحبة المصير المشترك أن تعيد النظر في قائمة الأولويات للقضايا والهموم التي تحيط بها في عالمنا المعاصر ، فتشغل نفسها لا بالقضايا الهامشية ، بل بالقضايا المصيرية ، وعلى رأسها قضية التخلّف التي تمثّل الهمّ الأكبر للأُمّة الإسلامية اليوم . والتخلّف المعني هنا تخلّف متعدّد الجوانب يشمل المجالات الروحية والمادّية والأخلاقية والعلمية والحضارية بصفة عامّة ، وتلك قضية مصيرية لا يجوز التهاون فيها أو التفريط في معالجتها بما تستحقّه من اهتمام وعناية .
التحديات التي تواجه دعاة الوحدة
أمّا تحدّيات وموانع الوحدة : فهي المشاكل التي تواجه الأُمّة الإسلامية ودعاتها في مسيرتها الوحدوية .
والتي منها :
أوّلاً : النعرة الطائفية .
ينبغي أن يُميّز بين الانتماء المذهبي والنعرة الطائفية ، فالانتماء المذهبي تعبير مشروع عن ارتباط المسلم بمذهب فقهي معيّن يعتقد هو ببراءة ذمّته حين يعمل بموجبه ، فيما تكون النعرة الطائفية حالة من العصبية تنطلق من تعصّب مقيت يولّد كراهية لأبناء الطوائف الأُخرى ، وفي الوقت الذدي يعزّز الانتماء المذهبي روح الأُخوّة الإسلامية بين كافّة أبناء المذاهب الإسلامية تكون النعرة الطائفية على عكس ذلك ; إذ تطرح نمطية الاحتراب وثقافة التشاتم بين أبناء الأُمّة الإسلامية ، حتّى أنّها قد تصل ـ أي : النعرة الطائفية ـ إلى أسوأ مدياتها في استباحة دماء المسلمين من أبناء الطوائف الأُخرى ! وقد تفرز هذه رموزاً طائفية وخطاباً طائفياً وفقهاً طائفياً يعطي للنعرة الطائفية مبرّراً شرعياً ويعبّئ أبناء الطائفة بالاتّجاه المضاد .
ثانياً : التسييس الطائفي .
المقصود به النظرة إلى الأفكار والمفاهيم إلى كلّ مذهب من المذاهب من منظور سياسي وليس من منظور معرفي محدّد . وتسييس الحالة الطائفية يحول دون التعرّف الإيجابي بين أبناء المذاهب ، وهو ما لا ينسجم مع المفاهيم القرآنية التي أرادت لكلّ المختلفين من أبناء الشعوب والقبائل التعارف فيما بينهم ، ومن موقع التعارف يجري بينهم الحوار والتعامل .
ثالثاً : العقدة الماضوية .
إنّ قراءة التاريخ قراءة متأنّية تعبر بجيلنا الحاضر إلى الأجيال الماضية لاستلهام التجارب والاستفادة من العبر أمر مطلوب إلى حدّ كبير ، غير أنّ تحويل التاريخ إلى عقدة ماضوية تؤثّر على الحاضر تأثيراً سليباً يجعله حاجزاً يحول دون التعامل بين أبناء الأُمّة الإسلامية فهو أمر مختلف . من هنا كان علينا أن نقرأ التاريخ قراءة مستقبلية ، بمعنى : أنّنا نستفيد من نجاحاتنا في التاريخ ونجاحات الآخرين ؛ لدفع عجلة التعاون في مجال الوحدة نحو الأمام ، كما أنّنا نستفيد من أخطائنا التاريخية ، لتلافي تكرارها وعدم تحوّلها إلى عقبات في الطريق.
رابعاً : الانكفاء الذاتي .
ما تتميّز به بعض الفرق الإسلامية في التاريخ من انكفاء ذاتي أضفى عليها نمطية باطنية في الأداء ، وجعلها تعيش حصاراً داخلياً ربّما يولّد في لا شعورها وشعورها كراهية عارمة تجاه الآخرين . كما أنّها أصبحت ـ والحالة هذه ـ تعاني من عقدة الاضطهاد بسبب عزلتها عنهم . والانكفاء الذاتي هذا تتسبّب فيه عدّة عوامل ، منها ما ينطلق من الظرف الاجتماعي الضاغط على مجموعة ما أو طائفة معيّنة ، ومنها ما ينطلق من ذات المجموعة أو أبناء الطائفة ، ومن أجل التخلّص من هذه الظاهرة السلبية لا بدّ أن تتوفّر أجواء الصحّة الاجتماعية الكافية التي تحترم كلّ معتقدات ومتبنّيات أبناء الطوائف الأُخرى ، كما لا بدّ لذات الطائفة أن تتمتّع بالثقة الكافية والتخلّص من الشعور بعقدة الاضطهاد وتطوير خطابها للتعامل مع الوسط الاجتماعي الذي تتحرّك فيه .
خامساً : عقدة الإقصاء والتسيّد الطائفي .
حاول بعض السلاطين أن يقصي أبناء المذاهب الأُخرى ممّن لا ينتمون إلى مذهبه ، وقد أدّت هذه النعرة إلى وقوع ضحايا كثيرة ، وألحقت الظلم بأبناء المذاهب الأُخرى . إنّ مثل هذه السياسات والممارسات وإن حقّقت نتائج شخصية لواضيعها ، ولكنّها لا شكّ مضرّة في مصلحة الأُمّة ، وإنّها لا محالة زائلة في حسابات الأُمّة وعلى مدى عمرها الذي يتجاوز عمر واضعيها .
سادساً : وجود المذاهب الكلامية والفقهية .
إنّ المسلمين ينقسمون في المذاهب الكلامية إلى طوائف ، كالأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والشيعة . والشيعة تنقسم بدورها إلى زيدية وإسماعيلية واثني عشرية ، فكيف يمكن توحيد الكلمة مع سيادة هذه المناهج الكلامية عليهم ؟ !
والحقّ أنّ هذه المذاهب تتراءى في بادئ النظر سدّاً منيعاً بوجه الوحدة ، ولكن بالنظر إلى أواصر الوحدة تبدو وكأنّها موانع ضعيفة لا تصدّ المسلمين عن التمسّك بأهداب الوحدة على كافّة الأصعدة .
أمّا المناهج الكلامية فجوهر الاختلاف فيها يرجع إلى مسائل كلامية لا عقائدية ، مثلاً : أنّ الأشاعرة والمعتزلة يختلفون في المسائل التالية : هل صفاته تعالى عين ذاته أو زائدة عليها؟ هل القرآن الكريم قديم أو حادث؟ هل أفعال العباد مخلوقة لله أو للعباد؟ هل يمكن رؤية الله في الآخرة أو هي ممتنعة ؟ إلى غير ذلك من أمثال هذه المسائل ، ومع تثمين جهود الطائفتين فالاختلاف فيها اختلاف في مسائل عقلية لا يناط بها الإسلام ولا الكفر ، فالمطلوب من المسلم اعتقاده بكونه سبحانه عالماً وقادراً ، وأمّا كيفية العلم والقدرة بالزيادة أو العينية فليس من صميم الإسلام ، فلكلّ مجتهد دليله ومذهبه ، كذلك القرآن هو معجزة النبي (صلّى الله عليه وآله) وكتابه سبحانه ، فليس الحدوث والقدم من صميم العقيدة ، وقس على ذلك ما تلوناه عليك من المسائل .
وأمّا المناهج الفقهية فالمشهور هي المذاهب الأربعة مضافاً إلى الزيدية والجعفرية ، فهذه المذاهب الستّة مذاهب فقهية ، والاختلاف يرجع إلى الاختلاف في فهم الآية والرواية ، فلو اختلفوا فإنّما يختلفون في فهم الكتاب والسنّة ، وهذا إنّ دلّ على شيء فإنّما يدلّ على اهتمامهم بهما وإمعانهم في فهمهما ، والاختلاف أمر طبيعي ، خصوصاً بعد مضي أربعة عشر قرناً من عصر الإسلام .
ولكن اختلافهم في المناهج الفقهية لا يمسّ بصميم الفقه الإسلامي ، فهل هناك مَن يرى صلاة الفجر ثلاث ركعات أو يرى صلاة الظهر والعصر غير أربع ركعات ؟ ! وليس الاختلاف وليد اليوم ، بل بدأ الاختلاف بعد رحيل رسول الله (صلّى الله عليه وآله)في أبسط المسائل الفقهية ، كعدد التكبيرات على الميّت ، إلى أعمقها ، فالاختلاف الموروث إنّما هو اختلاف في فهم النصوص لا في رفض النصوص وردّها .
ولا شكّ أنّ الشيعة ترى جواز الجمع بين الصلاتين مع القول بأنّ التفريق هو الأفضل ، والسنّة تخصّ جواز الجمع بالسفر ومواقف خاصّة ، ولكلّ دليله ، وقس على ذلك سائر الاختلافات الفقهية ، حتّى الاختلاف في متعة النكاح ، فذهب جمهور السنّة إلى النسخ والشيعة إلى بقاء الجواز ، فالاختلاف فيها كالاختلاف في سائر المسائل الناشئة من الاختلاف في النسخ وعدمه.
سابعاً : وجود الاختلافات القومية .
يتشكّل المسلمون من قوميات متعدّدة من عرب وعجم وترك وبربر إلى غير ذلك من الشعوب والقبائل ، ولكن هذا الاختلاف اختلاف تكويني لا يصلح لأن يكون مانعاً عن وحدة الكلمة ، وقد عالج سبحانه هذا النوع من الاخلاف قائلاً : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ )( سورة الحجرات : 13 ) .
فالاختلاف في اللون واللسان والدم والوطن وإن كانت عوامل توحّد طائفة كبيرة ، لكنّها عوامل عرضية لا تمتّ إلى جوهر الإنسان بصلة ، وأمّا الإيمان بالأُصول الثلاثة فهو عامل باطني ذاتي أقوى من جميع العناصر المتقدّمة .
فالمسلم الشرقي إذا تعارف مع المسلم الغربي مع ما بينهما من الهوّة السحيقة يتآخيان ; لما بينهما من وحدة المبدأ والمعاد والقيادة والهدف ; وأمّا الأُخوان من أُمّ وأب واحد إذا كان أحدهما إلهياً والآخر مادّياً فإنّهما يتناكران .
ثامناً : الجهل بمعتقدات الطوائف .
الحقيقة أنّ جهل كلّ طائفة بمعتقدات الطائفة الأُخرى يعدّ من أهمّ الموانع التي تشكّل حاجزاً منيعاً عن الوحدة ، وهذا ليس بالأمر المستسهل ، وإليك هذا المثال : إنّ الشيعة اقتداءً بالنبي وأئمّة أهل البيت لا يسجدون في الصلاة إلّا على الأرض أو ما ينبت منها ، بشرط أن لا يكون مأكولاً ولا ملبوساً ، فبما أنّ السجود على الأرض في المنازل وحتّى المساجد المفروشة غير ميسّرة ، لذا يتّخذون أقراصاً من التربة يسجدون عليها ، فعند ذلك نرى أنّ بعض إخواننا من السنّة يرمون الشيعة بالسجود للحجر والتراب كسجود عبّاد الوثن له ! مع أنّهم لا يفرّقون بين المسجود عليه والمسجود له ، فالتراب هو المسجود عليه ، وأمّا السجود له فهو الله سبحانه .
وعلى ذلك فلو وقف فقهاء المذاهب على ما لدى الطوائف الأُخرى من الفقه والأُصول والاستدلال والاجتهاد لما عاب أحدهم الآخر ، وإنّما الخلاف في كيفية الاستدلال وحقيقة البرهان لا في الأخذ بالبرهان .
تاسعاً : الجهل بمصطلحات الطرف الآخر .
إنّ لكلّ طائفة مصطلحات خاصّة في العقيدة والشريعة ، يجب أن تؤخذ مفاهيمها من كتب تلك الطائفة ، وليس من الصحيح تفسيره اعتباطاً . ومثال ذلك اصطلاح التقية ، فالتقية من المفاهيم الإسلامية ، وهي سلاح الضعيف أمام القوي ، فإذا خاف المسلم على ماله وعرضه ودمه من أيّ إنسان سواء أكان كافراً أو مسلماً وأراد شخص قوي سلب حرّياته ، فلا محيص له إلّا كتمان عقيدته ، وقد أمر به سبحانه وقال : ( إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ )( سورة النحل : 106 ) ، وقد نزلت في حقّ عمّار بن ياسر ، حيث أظهر الكفر وأخفى الإيمان ، وجاء إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) باكياً ، فقال (صلّى الله عليه وآله) : « لا شيء عليك » ، فنزلت الآية ، ولكن اصطلاح التقية يفسّر عند بعض المخالفين بالنفاق ، مع أنّ بين التقية والنفاق بوناً شاسعاً ، فالتقية إظهار الكفر وإبطان الإيمان ، والنفاق على العكس ، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر .
المصدر
للاستزادة راجع كتابنا « المعجم الوسيط فيما يخص الوحدة والتقريب » ج1 : ص19 ، 63 ـ 64 ، 76 ـ 79 ، 83 ـ 84 ، 112 ـ 116 ، 154 ـ 155 ، 172 ـ 174 ، 279 ـ 281 ، 284 ـ 290 ، 304 ـ 307 ، 332 ـ 333 ، 405 ـ 410 ، 438 ـ 441 . وكذا ج2 : ص10 ـ 11 ، 36 ـ 37 ، 39 ، 177 ـ 178 ، 180 ـ 182 ، 191 ـ 194 ، 198 ـ 203 ، 229 ـ 240 ، 290 ـ 299 ، 396 ـ 398 ، 409 ـ 415 ، وغيرها من الصفحات .
وأيضاً كتابنا الآخر موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح ج1 ،ص37-74 .
1.المعجم الوسيط فيما يخص الوحدة والتقريب.
تأليف : محمّد جاسم الساعدي\ نشر : المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية- طهران\ الطبعة الاولى-2010 م.
2.موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح.
تأليف : محمّد جاسم الساعدي\ نشر : المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية- طهران\ الطبعة الأولى-2010 م.